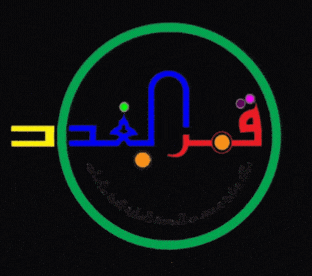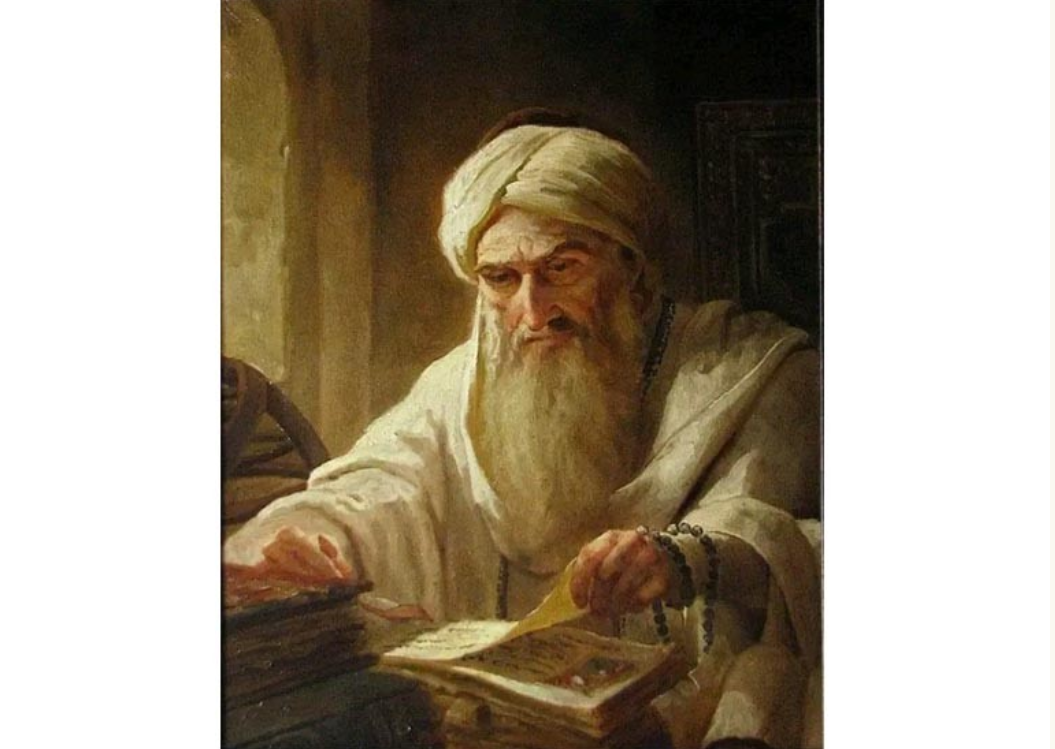صلاح نيازي
كان كتاب محمود عباس العقاد: “آبن الرومي حياته من شعره” نهجاً جديداً في الدراسات الأدبية، في حينه. هكذا رحنا نتفيّأ أخبار آبن الرومي، ونستظهر مطوّلاته، حتى من دون تمحيص.
فتح العقاد الأعين، وقتئذ، على ما للألوان، من تأثير في رونق الصورة الشعرية، وكثافتها.
نبغ آبن الرومي في قصيدتين نبوغاً لا يجاريه بهما أحد، وهما رثاؤه لآبنه محمد وقصيدة أخرى في المغنية وحيد. لكنّ همّ هذه المقالة منصبّ هنا على المرثية في الوقت الحاضر.
ما الذي جعل هذه المرثية أفجع مرثية في الشعر قاطبة. المعروف أن ابن الرومي يقرب في بعض تأليفه من السرد وتنثير الشعر، ويسرف في التصريع، والجناس. قد تكون هذه عيوباً، إلا أنها في مرثية محمد سبباً لعظمة القصيدة. كيف؟
في الظاهر إن القصيدة ترتكز على أربع شخصيات، هم: الطفل الميت، وأخواه الطفلان الآخران والأب، وهو الوحيد الذي يسرد أحداث المأساة. ما من أمّ لتزيد في طبقة النواح.
آبن الرومي وحيد يراقب الموت مرحلة مرحلة، فما حاجته إلى طبقة صوتية عالية.
القصيدة تدور في بقعة صغيرة هي المنزل. بكلمات أخرى إنها مرثية منزلية. وحتى حين يموت محمد فإن آبن الرومي يتحدث بصيغة الحاضر وكأن الطفل ما يزال حيّاً.
الموت لم يفتر، فالمأساة إذن قائمة. هذه إحدى التقنيات التي تفرّد بها آبن الرومي.
التقنية الأخرى انحدرت إلى الشاعر من طبيعة اللغة العربية، فمطلع القصيدة مثلاً:
«بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أودى نظيركما عندي”
لا يمكن أن يترجم إلى اللغة الإنكليزية ويظل يحتفظ بنكهته، ذلك أنّ اللغة الإنكليزية تخلو من صيغة المثنّى. من النافلة أن المثنى كما في “بكاؤكما” له مكانة خاصة في اللغة العربية، فحينما يقول امرؤ القيس مثلاً: «قفا نبكِ» فلا يعني إلا واحداً، وكذلك في سورة الرحمن: “فبأي آلاء ربكما تكذبان». أما الهمزة في “بكاؤكما” فلها موسيقيّاً مفعول الغصة. ذلك أن صوت الهمزة يخرج من قعر البلعوم. جاء في الآية الكريمة: «وإذا الموؤدة سئلتْ بأي ذنب قُتِلَتْ”. تكررت الهمزة أربع مرات من أصل ست كلمات. إلى ذلك فالبيت يحتوي على إحدى عشرة لفظة، منها ست كلمات تحتوي على ألف ممدودة. الألف الممدودة موسيقياً هنا تقوم مقام طبقة صوتية عالية. ينطبق الأمر على البيت الثاني والثالث.
ربما كان آبن الرومي أول شاعر عربي يصف الموت عياناّ، كحدث متدرج وبحالته هذه يزيد من تقطيع النياط. يقول الشاعر:
«ألحّ عليه النزف حتى أحاله
إلى صفرة الجاديّ من حمرة الورد
…فيا لك من نفس تساقط أنفساّ
ويذوي كما يذوي القضيب من الرند”
في الفعل “ألحّ” استمرار وتكرار لعملية النزف. الأب يراقب ولا حيلة بيده لإنقاذه من معاناته. الأمرّ أن هذا استغرق وقتاً طويلاً بدليل تحوّل الطفل من لون إلى لون، من حمرة الورد إلى صفرة الجاديّ (الزعفران).
في البيت الثاني يواصل ابن الرومي الصورة النباتية لاسيّما في الفعل تساقط، والفعل يذوي. كررّ الشاعر يذوي مرتين ليؤكد على شدّة التشابه بين ذواء الابن و ذواء الغصن المقطوع. وبما يشبه الاختلاط العقلي راح الشاعر يسأل عن ابنه حتى وهو في القبر، كيف حاله بعدي؟ ثمّ راح يخاطبه:
«اريحانة العينين والأنف والحشا
ألا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي”
كيف لا؟ إلا أن ابن الرومي استحال إلى مخلوق لا يريد أن يصدق بديهيات الموت. لا عجب أنْ راح الشاعر في الشطر الأوّل بتضخيم المصاب بتعدد الحواس والجوارح، وبهذه التقنية نقل مسرح الحدث من الخارج إلى داخل النفس، وبذا زاد من حدّة الآلام، وهذا بحدّ ذاته شيء طارئ على الشعرالعربي. يبدو أن الشاعر وصل في هذا الحدّ من القصيدة، إلى الآستسلام للأمر الواقع، وما وقع قد وقع. يقول الشاعر:
«سأسقيك ماء العين ما أسعدت به
وإن كانت السقيا من العين لا تجدي”
الشطر الأوّل يتماشى مع الصور النباتية، بينما الشطر الثاني صدى لمطلع القصيدة: «بكاؤكما يشفي وإنْ كان لا يجدي». اللاجدوى في هذه القصيدة هي الثيمة الأساسية من البداية إلى النهاية، وهي على أشُدّها وضوحاً حين يقول:
«أقرة عيني لو فدى الحيّ ميتاً فديتك بالحوباء أوّل ما أفدي»
ينتقل الشاعر بقصيدته في المقاطع الأخيرة انتقالة حاسمة ، فالماضي الذي تصوّره داخل الزمن الحاضر، إنما الآن راح ينفصل ويبتعد، ومعه زاد من وحشة الشاعر. لا ريب إنّ أخطر وحشة في هذه القصيدة هي حينما كانت الذكريات تبتعد حتى لتكاد تصبح في خبر كان:
«كني ما استمتعت منك بنظرةٍ ولا قبلة أحلى مذاقاً من الشهد كأني ما استمتعت منك بضمةٍ ولا شمّةٍ في ملعب لك أو مهدِ»
يجمع الشاعر في هذه الأبيات، أربع حواسّ مرة واحدة: البصر والسمع واللمس والشمّ. الشمّ على وجه الخصوص لم تمرّ بي بهذه الصورة الشعرية من قبل، وهي حين تشترك مع القبلة تكونان أعمق شوق وشغف عميقين. كل هذا امّحى الآن، فراح ينادي:
«محمّد ما شيء تُوهّم سلوةً
لقلبي إلا زاد قلبي من الوجدِ”
لماذا لم يظهر آسم محمد قبل الآن؟
صيغة محمد منادى لغة، ولكنّ في توقيتها لا سيّما ونفسية المتكلّم منهارة، يكون فيها معنى استغاثة بصورة ما، ما دام المتحدث في “وحشة الفرد”. لم يجد مّنْ يواسيه فراح يستحضر ابنه، عسى ينجده. يبدو أن دموع الشاعر لم تعدْ تكفي فختم القصيدة:
«عليك سلام الله منّي تحية
ومن كلّ غيث صادق البرق والرعد».
لا يفوتنا أن نذكر أنّ من أهم تقنيات آبن الرومي هي في كيفية إدامة الحزن وتأبيده:
«أرى أخويك الباقيين فإنما
يكونان للأحزان أورى من الزند
إذا لعبا في ملعب لك لذّعا
فؤادي بمثل النار من غير ما قصد”
كذا وجد الشاعر في ابنيه الباقيين لا سلوة وعزاء، بل «حزازة (وجع في القلب) يهيجانها دوني وأشقى بها وحدي”.
يبدو أن الخنساء في رثائها لشقيقها صخر ابتكرت طريقة فريدة في إطالة حزنها وذلك بوصله بظاهرتين طبيعيتين تتكرران كل يوم.
تقول الشاعرة:
«يذكرني طلوع الشمس صخراً
وأذكره بكل غروب شمسِ”
أي في ذهابه للصيد صباحاً وعودته مساء.
بالمثل ابتكر السياب طريقة جديدة، في هذا الباب لم تمرّ ببال شاعر من قبل، في قصيدته: “الأمّ والطفلة الضائعة» التي كتبها بالبصرة سنة 1961 وهي من السنين العجاف بالعراق.
راحت الأم حتى في الزحام تصغّر ملامح الناس، لترى شبهاً لها كعيني ابنتها وجبينها وفمها، وحين ترى ملامح ابنتها موزعة في وجوه عدّة.، تنفث آهة:
«فآهِ لو أراك وأنت ملتمّهْ”.
كانت النية معقودة على مقارنة مراثي الأطفال العربية وعددها قليل، بمراثي الأطفال الإنكليزية وعددها قليل أيضاً ولكن خشية الخروج عن وتيرة المقالة، استقرّ الرأي على قصيدة بين جونسون في رثاء ابنه وكان عمره سبع سنوات. تعتبر هذه القصيدة أهم مرثية في الشعر لإنكليزي.
كتبها عام 1603 ونشرها عام 1616. أما جونسون فكان أهم كاتب مسرحي بعد شيكسبير.
تتكوّن القصيدة من أحد عشر شطراً فقط، دلالة على صغر الآبن المتوفّى، ولحرص المؤلف على الإيجاز الخالي من أية ميوعة ما من عيون تبكي ولا دموع ولا جوارح ، وإنما مجرد قضاء قدر، وما الموقف منه، وما مبرراته. بكلمات أخرى ما من عاطفة كانت ما كانت.
لا عجب أن كُتبتْ عشرات المقالات النقدية الرصينة والشروح عن هذه القصيدة الصغيرة.
مطلع القصيدة كالتالي:
«وداعاً يا عضيدي (يدي اليمنى) وبهجتي»
ثم يتبسط الأب بعد ذلك فينسب إلى نفسه مسؤولية ما حدث من مصاب، فقد كانت له توقعات كبيرة، وأحلام وطموحات، بآبنه. على هذا المنوال فهم الأب مسألة الموت.
أكثر من ذلك تصوّر الأب، أنّ ولده كان قد أُعطي له كديْنٍ، وها قد حان تسديده.
هكذا فهم الأب القدر، وتقبله. ويقول: «أننا يجب ألاّ نخاف من الموت، يجب أن نحسد هؤلاء الذين ماتوا لأنهم تخلصوا من مآسي الحياة”، نقول في الدارجة العراقية: (مات وخلّصْ).
يشير تنسون في نهاية القصيدة إلى أنّ ابنه قطعة شعريةpiece من فنّه»، ثمّ يقسم أنه لن يحبّ أيّ شيء آخر بالعمق الذي أحب به ولده لأن حبّه ذهب هباء.