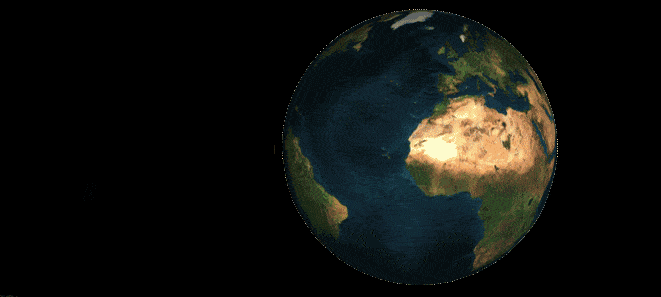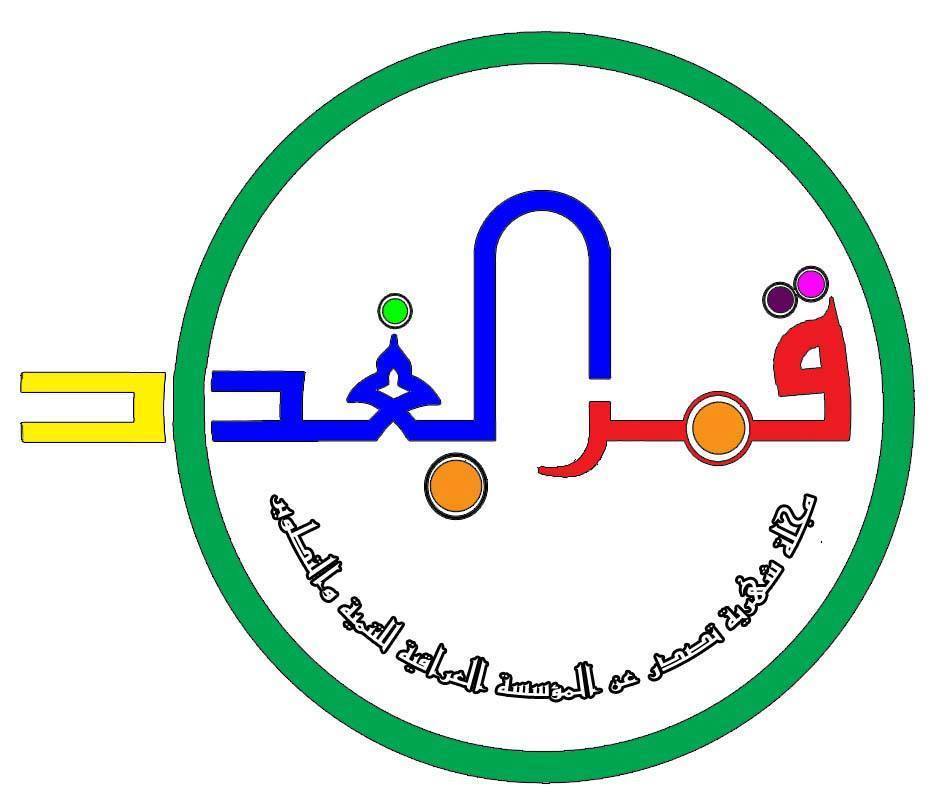مازلت أذكر عبارة مدرس اللغة الإنجليزية البريطاني الجنسية، الذي وجه إلينا سؤالا عن أخطر شيء في الكون، فتعددت إجابات الطلاب بين تعداد الحيوانات المفترسة أو الحشرات السامة أو الزواحف الخطيرة من وجهة نظر بعض من ذكر تلك الكائنات. وبعد أن استعرضنا ثقافتنا في سرد مصادر الخطورة والتقزز أو الخوف من بعض تلك الكائنات، تأوه مستر جون من ضيق أفقنا، ونفى أن تكون تلك الأسباب التي ذكرناها تخولنا وصف أي منها بالأشد خطورة. وقال في عبارة حازمة: «أخطر شيء في هذا الكون هو الإنسان. هل رأيتم أو سمعتم عن أي كائن يقوم بقتل متعمد لأبناء جنسه غير البشر؟ يمكن أن تقوم بعض تلك الكائنات التي ذكرتموها بإيذاء أنواع أخرى غير جنسها، لكنها لا تصل إلى فتك أفراد البشر بعضهم ببعض. هل تسمعون عما يفعله بعض اللبنانيين بالفئات الأخرى المختلفة عنهم في العرق أو الدين أو المذهب؟» وكانت الحرب الأهلية مشتعلة آنذاك في لبنان.
وأحببت أن أضيف أيضا إلى فكرة هذا البريطاني، أن الإنسان ليس أكثر الكائنات خطورة فحسب، بل هو أشدها تعقيدا من ناحية طريقة تفكيره الفردية الموغلة في الأنانية، وفي محاولاته استغفال الآخرين كلما وجد إلى ذلك سبيلا. هل هي تربية ثقافية، أو تراكمات تاريخية تتوارثها الأجيال، إلى الدرجة التي تتحول فيها إلى صفات جينية أصيلة لدى بعض المجتمعات؟ عندما أتذكر الاعتداد لدى كل جماعة ببعض الموروثات، التي تكون لدى جماعات أخرى من المثالب المعتبرة في ثقافتهم، أقول إن هذه الفروق في موازين الأخلاق، واعتبار القيم الإنسانية، تجعل كل فئة تشترك في منظومة الأخلاق والقيم هي فصيلة بشرية مختلفة تقريبا. فما يعد كرما لدى قوم، يراه آخرون سفها وسذاجة، وما يراه بعضهم شجاعة، يراه غيرهم تهورا وقلة عقل، وكذلك الأمر في شؤون الإرهاب والأمور الأسرية والصداقة والوفاء والصدق والأمانة. وفي استعراضي لتلك التباينات، أحسست أن المجموعات البشرية تسير في خطوط متوازية، وربما لا يجمعها إلا بعض الملتقيات الدينية، أو التبادلات الثقافية نتيجة الجوار الجغرافي، أو التمازج نتيجة استعمار، أو حاجات تبادل اقتصادية.
وحتى المرجعيات العالمية في الثقافات القديمة نجدها متباينة بين الكتل البشرية المتصارعة، أو غير المتمازجة في أحد الأسباب المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال إذا ذكر المرء فولتير في سياق ثقافي غربي، فإن الشخص العادي ذا الثقافة المتوسطة يذهب ذهنه إلى مراجعات لمسلمات الكنيسة والفكر القمعي القديم، لكن ثقافات أخرى مثل الثقافة العربية لا تستنتج من ذلك أي خلاصة ذات بال في هذا الشأن. والقضية معكوسة لو كان الأمر متعلقا بذكر الجاحظ في مرجعية عربية، فإن ما يخطر على البال هو السخرية الموجهة لصناعة رأي عام لدى العامة، وهو أمر لا يستنبطه إلا القليل من المتخصصين في الثقافة العربية لدى الأمم الأخرى. وهنا تظهر إلى السطح أهمية أن تُدرس أوضاع الإنسان العقلية الجمعية، ليخلص المرء إلى ما يجمع تلك الفصائل البشرية المختلفة من سمات مهيمنة في إطار صنع قوالب الأخلاق، وتوزيع القيم إلى سلبية وإيجابية، خيرة وشريرة، هادفة إلى التطور ورفعة الإنسان أو هادمة لما حققه في تاريخه من بناء حضاري وتقدم ورقي، وحتى يتحقق ذلك نكون قد خطونا الخطوة الأولى نحو الوئام.