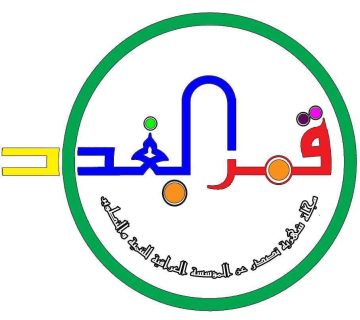إياد أبو شقرا
صحافي وباحث لبناني، تلقى تعليمه العالي في الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان)، وجامعة لندن (بريطانيا). عمل مع «الشرق الأوسط» منذ أواخر عقد السبعينات وحتى اليوم، وتدرج في عدد من المواقع والمسؤوليات؛ بينها كبير المحررين، ومدير التحرير، ورئيس وحدة الأبحاث، وسكرتير هيئة التحرير.
لعلَّ مَن هم أدرى مني بالحسابات الخاصة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأيضاً بالتيارات الصاعدة داخل الحزب الجمهوري، يستطيعون الجزم بما إذا كنا أمام مفترق «آيديولوجي» جمهوري… أم لا.
كثيرون مثلي ممّن لا يدّعون معرفة وثيقة بدواخل الحزب فوجئوا باختيار ترمب السيناتور جي دي (جيمس ديفيد) فانس، عضو مجلس الشيوخ الشاب عن ولاية أوهايو، «رفيق درب» في معركة انتخابات الرئاسة المرتقبة بمطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فنحن «معشر» مراقبي الخارج اكتشفنا طوال الشهور، بل السنوات الماضية كم نجح ترمب في إحكام قبضته على حزب عريق عُرف تقليدياً بكثرة «الرؤوس» فيه.
اكتشفنا ورأينا كم ألغى من قيادات… وهمّش قيادات أخرى.
كم فرض من مواقف وسياسات على «مؤسسة حزبية» كان يُحسب لها ألف حساب حتى الماضي القريب، مستقوياً بقاعدة مأخوذة بشعاراته المبسّطة المباشرة… إلى درجة ما عادت معها مستعدة لممارسة اللعبة بالشروط والضوابط المألوفة.
لقد أعاد دونالد ترمب، المتحكّم بصورة مطلقة في جمهوره، بناء حزب «على مزاجه»…
وفي المقابل، استساغ الحزب أن يسلم قياده إلى «ساحر» ويمنحه تفويضاً مطلقاً… تماماً كما شاهدنا وسمعنا بالأمس في نهاية المؤتمر الوطني للجمهوريين في مدينة ميلووكي. وهنا، لعل النموذجين الأقرب تاريخياً إلى «الحالة الترمبية»، سواءً من حيث شدة يمينيتها أو لجهة تحديها ضوابط اللعبة حزبياً ووطنياً، هما نموذج سيناتور أريزونا السابق باري غولدووتر ونموذج رونالد ريغان.
ولكن إذا كان النموذج الأول قد أسفر عن هزيمة كارثية للجمهوريين أمام الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون عام 1964، فإن النموذج الثاني حقق عام 1980 نجاحاً تاريخياً ترك بصماته لعقود ليس فقط على الحزب الجمهوري، بل وعلى معسكر اليمين في عموم العالم الغربي… وزكّى هذا النجاح بإنهائه «الحرب الباردة» عبر دفعه الاتحاد السوفياتي إلى الانهيار.
تأثير تشدّد غولدووتر، الذي أخاف في حينه مئات الملايين من إمكانية استخدامه «الزر النووي» إبان حرب فيتنام، لم يتكرّر مع ريغان الذي رفع رجاله شعار «أفضل أن تكون ميتاً من أن تكون أحمر (أي مستسلماً للشيوعية)». لا، بل كانت رسالة «صقور» الحقبة الريغانية، كالجنرال ألكسندر هيغ والوزير كاسبار واينبرغر، واضحة جداً عن إمكانية خوض حرب نووية «محدودة»، وأن يكون «المسرح النووي» في أوروبا خاصة، مضبوطاً وقابلاً للتحكم.
وحقاً، جرّ «صقور» الريغانية موسكو إلى مشروع «حرب نجوم» مُكلف لا طاقة اقتصادية للروس على مجابهته. وهكذا بدأ مسلسل «الاستسلامات» السوفياتية التي أقدم عليها ميخائيل غورباتشوف المنتشي بالشهادات الغربية له بـ«الحكمة» و«الرؤيوية». وفي الحصيلة النهائية، انهار الاتحاد السوفياتي وأعيد توحيد جزأي ألمانيا… وبينما انتهى «حلف وارسو»، كبُر وتوسع «حلف شمال الأطلسي» ليشمل أوكرانيا!
ركائز داخلية أميركية ثلاث كانت وراء نجاح النموذج الريغاني، سواءً على مستوى الحزب الجمهوري أو الولايات المتحدة كلها:
الركيزة الأولى تحرير قوى السوق وتقزيم دور الدولة في الاقتصاد، وهو ما كان يدعوه ريغان وفريقه الاقتصادي «الحكومة الصغيرة»، وعُرفت بالتالي بـ«الريغانوميكس» (الاقتصاد الريغاني).
والركيزة الثانية هي القبضة العسكرية الجبارة في السياسة الخارجية التي أكدت وتؤكد مكانة الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة في العالم.
وأخيراً، الركيزة الثالثة هي الالتزام الفكري والاجتماعي بـ«المسيحية المحافظة» (الإيفانجيلية) عقيدةً ضامنةً وحاميةً لأحادية قيادة أميركا العالمية، وهنا برز النفوذ غير المسبوق سياسياً لقساوسة و«مبشّرين» على شاكلة بيلي غراهام وجيري فولويل وآخرين.
بالأمس، مع نهاية مؤتمر ميلووكي، عدّ مراقبون اختيار جي دي فانس (39 سنة) لمنصب نائب الرئيس بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحزب الجمهوري. ومع أنه قد يكون من المبكر الجزم بما سيستطيع فانس فعله عندما يتولى قيادة دفة الحكم – إذا تولاها – فمما لا شك فيه أن ثمة تياراً موجوداً ومتحركاً داخل الحزب حجبته «الظاهرة الترمبية» عن الأنظار. وهذا التيار، إذا كان لنا رصد «فلسفته» عبر ما نشر وبُث من تصريحات للسيناتور فانس قبل ترشيحه في ميلووكي، ولو بكثير من التحفظ، يؤشر إلى ابتعاد بعض الجمهوريين عن «الركائز الثلاث» للنموذج الريغاني.
إذ لا يبدو أن التلازم الكامل بين التدخل العسكري والسياسي الخارجي، والالتزام المطلق باقتصاد السوق، ومحورية «الإيفانجيلية» بشقيها الديني والأخلاقي ستظل من «مُسلّمات» ما سيتركه ترمب لفانس عندما يحين موعد «تبديل الحرس»… كما يقال.
موضوع دعم أوكرانيا – مثلاً – لا يعني كثيراً للتيار الذي يعبّر عنه السيناتور فانس، لا لجهة ضمان أمن أوروبا عبر «حلف أطلسي» قوي واسع، ولا لجهة إبقاء طموح فلاديمير بوتين مقيداً ومحاصراً. ولا سيما، أن موسكو ما عادت مصدر الخطر الأكبر على المصالح الأميركية، كما حرص ترمب على تذكيرنا…
أيضاً، اقتصاد السوق وفق معايير «الريغانوميكس» و«مدرسة شيكاغو» النقدية الفريدمانية، لا يناسب ولايات محافظة قومياً ودينياً واجتماعياً، وفقيرة اقتصادياً تعتمد على موارد اقتصادية متقادمة مثل مناجم الفحم والصناعات التقليدية في «حزام الصدأ»، وبناءً عليه، تحتاج إلى «تدخّل الدولة» في وجه العمالة الأجنبية الرخيصة والتكنولوجيا المتقدمة الزاحفة من شرق آسيا.
وأخيراً، مع التسليم بعمق الإيمان المسيحي على امتداد طيف اليمين الأميركي، وبالأخص، عند الريفيين الجمهوريين في «حزام الإنجيل» وأمثاله، فإن الوجه «الثيولوجي» للهوية اليمينية يتخلّف الآن بفارق واضح عن الوجه «القومي» («إعادة أميركا إلى العظمة من جديد»)، بل أحياناً عن الوجه العنصري الصريح… ضد بعض الأقليات وقطاعات كبيرة من المهاجرين.
نعم قد يكون الوقت لا يزال مبكراً لاستخلاص عناوين حاسمة للمرحلة الجمهورية المقبلة، لكنها مثيرة للاهتمام بكل تأكيد.