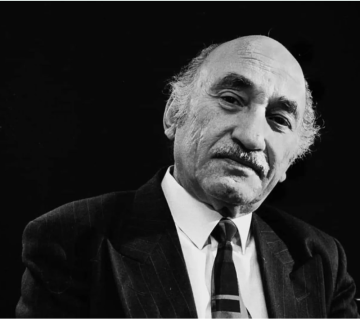الأرملة الشابة نوال تواجه الذكورية الشرعية ببعض التشويق ولا تنتصر

نوال الأرملة الأردنية التي ستحرم من بيتها لأنها لم تنجب ذكراً (ملف الفيلم)
“إن شاء الله ولد” للمخرج أمجد الرشيد، وهو أول فيلم أردني يُعرض في مهرجان “كان” السينمائي (16 – 27 مايو/ أيار)، عمل في منتهى الضرورة، ينكأ الجراح وينبش الأوجاع ولا يساوم في نقله الواقع الأردني، هذا الواقع الذي ينسحب أيضاً على العديد من المجتمعات العربية. المخرج الشاب الذي يقدم باكورته الروائية الطويلة داخل قسم “أسبوع النقّاد”، يقتحم وكر دبابير، ومن المرجح جداً أن يستفز أصحاب الحساسيات الدينية والمحافظين، ويغضب دعاة عدم نشر الغسيل الوسخ على حبال البلد، الذي ينتفض في كل مرة يدور فيها النقاش حول العادات والتقاليد التي تحاول المنظومة الدينية والسياسية والاقتصادية صونها حفاظاً على مكتسباتها. نوال بلا حجاب بعيداً عن الاعين المت

نوال وابنتها بلا حجاب في البيت (ملف الفيلم)
الحكاية غايةٌ في البساطة: يموت زوج نوال (منى حوا) فجأةً، بلا مقدمات. يضع رأسه على الوسادة ليلاً ولا يستيقظ في صباح اليوم التالي. مسألة الموت المفاجئ التي تزعزع الاستقرار الهش للعائلة المؤلفة من أب وأم وابنتهما الصغيرة، ليست شيئاً يتأخر عنده الرشيد، وسرعان ما ندرك أن ليس هذا ما يشغله. فالموت هنا بداية للأحداث لا نهايتها، بل نقطة انطلاق للعديد من الشؤون الأسرية والمعضلات الأخلاقية والسلوكيات الاجتماعية. هذا كله يخرج نوال من الظل إلى الضوء، لتصبح بطلة الفيلم، ماسكةً بمصيرها حتى الختام. من هذه اللحظة المأسوية تتفرع كافة المشاكل. يمضي الرجل، لكنه يترك خلفه زوجة مفجوعة وابنة لا تعي ما هو الموت. أما الأقارب والجيران والزملاء فلا يعرفون معنى الفردية في مجتمع يدين ويصدر الأحكام غيابياً.
ما يحدث بعد الموت “هو” الفيلم. فبسبب قوانين الأحوال الشخصية البالية في الأردن، تجد نوال نفسها تحت رحمة شقيق زوجها رفقي (هيثم العمري) الذي يتبين سريعاً بأنه يطمع بممتلكات المرحوم. فهو وريثها الشرعي لكون شقيقه لم يرزق بإبن. لن يتسنى لنوال ان تحزن على مَن عاشت معه لسنوات، بل تجد نفسها محوطة بناس يقتحمون خصوصيتها. ثمة انتفاء كلي للحيز الخاص. يطالب رفقي بحصته من الإرث علماً أن ما يملكه الراحل ليس سوى منزل متواضع بات يشكّل الملاذ الآمن الوحيد لنوال وابنتها. بيد أن القوانين تدعمه وتقف في صفه كرجل، فينصب نفسه وصياً على المسكينة التي يتخلى عنها الجميع في مجتمع يعتبر المرأة إنسانة غير كاملة.

الأرملة تكافح لكي تحافظ على منزلها العائلي (ملف الفيلم)
لا يخلو الفيلم من تشويق، مذكّراً بأسلوب السينما الإيرانية (لا سيما أصغر فرهادي) الذي ينطلق من موقف عادي ليحوك حوله ملابسات تفضي إلى إدانة جماعية من دون تسمية الأشياء بأسمائها بالضرورة. وهناك دائماً بطل أو ضحية. وهذا هو الخط الدرامي الذي يمشي عليه الرشيد المتأثر بالسينما الإيرانية، عن وعي أو من دونه. منذ لحظة التأسيس للصراع وعرض الحلول المحتملة والعقبات، يغدو الفيلم “ثريللر” يضع بطلته في سباق مع الزمن. تحاول نوال إنقاذ نفسها ولكن ليس نفسها فقط. قضيتها قضية كل النساء اللواتي يعانين مثل ما تعانيه.
يستند الفيلم إلى فكرة لمّاحة لصناعة تشويق. فكرة، على بساطتها، موفقة وقادرة على انتزاع الفيلم من العادية. فنوال تعتقد انها حامل. بيد انها غير متأكدة من حملها. تجري تحليلاً فيتبين انها غير حامل، ولكن قد يكون باكراً ليظهر الحمل. يسأل القارئ هنا: لماذا الحمل على هذا القدر من الأهمية وما الذي سيغير في الصراع على الارث؟ بل هو الذي سيغير كل شيء! ففي حال حملت بذكر، يصبح المولود الوريث الشرعي، ولا يعود للشقيق حق المطالبة بإرث شقيقه المتوفى. باختصار: تُحل المشكلة وتعود نوال لتنعم ببعض الطمأنينة بعد عبورها النفق المظلم. فهي، كامرأة، في حاجة إلى ذكر لينقذها ويوفّر لها سقفاً تعيش تحته.

نحو المجهول في مجتمع ذكوري لا يحمي المرأة (ملف الفيلم)
يحفل الفيلم بالرموز الدينية والنفاق الديني المنتشر داخل المجتمع. حجاب نوال استعارة لركاكة هذه الرموز. حيناً يغطّي شعرها وحيناً يكشفه. تنزعه وترتديه مرات لا تحصى، إلى أن يصبح بلا معنى من فرط التكرار. يتحول الحجاب مرة بعد مرة إلى مجرد أداة سلطة ووصاية لا أكثر. والتركيز في هذه النقطة مهم، ولا أعتقد أنها مجرد صدفة. هناك تفاصيل أخرى كثيرة تكشف احتكام الناس إلى الدين، رغم أن ما يفعلونه أبعد ما يُمكن عن تعاليمه. هم يدركون ذلك ولكن لا بأس. بعض هذه الاشارات والتلميحات تأتي فجّة ومباشرة أحياناً، ولكن نفهم حماسة مخرج يأتي من بلد حيث ثمة صعوبة في مناقشة المشكلات الدينية. تجد نوال نفسها محاصرة بالدين والتدين والمتدينين، بيد أن لا أحد يساعدها، لا بل هي تتعلم كيف تساعد نفسها.
الفيلم واضح في خطابه واستنتاجاته على نحو لا يترك أي مجال للالتباس. هناك مجتمع ذكوري يستمد شرعيته من الدين والأعراف الاجتماعية وعلى هذا أن ينتهي. لا يقوم الفيلم بانتفاضة بل يطالب بحد أدنى من الحقوق. هذا الخطاب في محله، تبقى الكيفية التي يمرر فيها الفيلم أفكاره، وهنا يسقط في فخ المباشرة الفجّة، خصوصاً في مشهد ركيك مضر لكل الفيلم. السينما ليست منبراً لتوجيه رسائل مباشرة. الشرط الأساسي للتعاطف مع المتضررين من منظومة اجتماعية هو أن نصدّق ما نراه، وأن نستنتجه بأنفسنا لا أن يُقال لنا. ولكن، للأسف، هناك حكاية ثانوية متداخلة مع الخط الدرامي الرئيسي، محورها عائلة ثرية تعمل نوال لديها، وهذه الحكاية تزعزع الفيلم رغم أهميتها للربط بين مصائر النساء، ثريات كن أو فقيرات، قويات أو ضعيفات، متمردات أو مستسلمات. هذا الفصل المتعلق بالعائلة الثرية يحمل عيوباً وكان من الممكن إعادة النظر فيه، بل وحذف بعض ممّا يعطي الاحساس بالافتعال والخفّة.
كلمة أخيرة عن الرجل، هذا الذي هو مصدر “كل الشرور” في الفيلم. هناك رجل واحد يوفّره المخرج ويخصص له مكانة خاصة ويعطيه شهادة براءة إذا صح التعبير. بيد أن طيبته لن تسعفه، فهو سيعامَل مثله مثل غيره. هذا جانب مثير في الفيلم، ويحمل في داخله بعض الإدانة للمرأة أيضاً انطلاقاً من سؤال: هل الرقة والاهتمام هما الطريق إلى قلب المرأة الشرقية التي اعتادت الخشونة والرجولة في المفهوم الشرقي؟