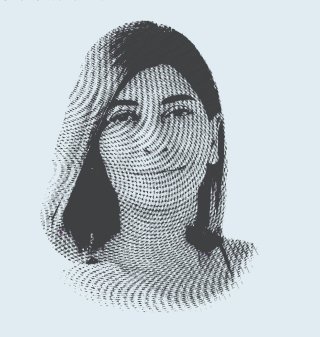عاش العالم خلال السنة الفائتة، أكبر موجة انتخابات عرفتها البشرية على الإطلاق، في الوقت الذي تراجعت فيه الديمقراطية بوتيرة خطيرة وغير مسبوقة. ذهب إلى صناديق الاقتراع مواطنو أكثر من ستين دولة – بينها الهند وباكستان وروسيا وأميركا وبريطانيا – هؤلاء يشكلون نصف سكان العالم. بالنتيجة رأينا في الحكم من جديد، دونالد ترمب وناريندرا مودي وفلاديمير بوتين. الانعكاسات لم تكن قليلة، لكنها لم تقرّب أحداً من الحرية المنشودة.
لم نقرأ دراسة واحدة تشير إلى أن الديمقراطية تتقدم، بل إن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن الانتكاسات لم تعد حكراً على دول متخلفة أو استبدادية، بل وصلت إلى عمق الغرب وبات الأوروبيون يتحدثون عن تراجع الحريات في أميركا، فيما أميركا تتهم أوروبا بتخلفها عن الركب.
الكلام هو عن انحراف، باتجاه أنظمة لها واجهات ديمقراطية ومضمون استبدادي. وهذا قد يسمى «ديمقراطية غير ليبرالية» من باب اللطف أو «استبداد ناعم» وربما «استبداد انتخابي».
التراجع حالة تراكمية متواصلة منذ مطلع القرن. دراسات عدة أجريت في السنتين الأخيرتين، تبين أن 8 في المائة فقط من سكان العالم، يمكن عدّهم يعيشون في ديمقراطيات حقيقية. طال التراجع دولاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا وتتوج إسرائيل على رأس اللائحة، رغم أنها لا تزال تباهي بديمقراطيتها.
جاء في تقرير «فريدوم هوس» أن التراجع متواصل منذ 18 عاماً، في الهند «أكبر ديمقراطية في العالم» قمع للأقليات وتضييق على حرية التعبير، فيكتور أوربان في المجر، عاشق الحواجز والجدران، بات يوصف بـ«أخطر رجل في أوروبا»، وفي ميانمار حيث كان يظن أن فرجاً قد حلّ، فإذا بانقلاب ينهي الأمل. النقاط المضيئة قليلة، وفي بلدان لا تملك قلب الموازين مثل النرويج ونيوزيلندا.
ثلثا البشرية يعيشون فعلياً تحت حكم أنظمة استبدادية. و42 دولة شهدت تدهوراً ملحوظاً. وأكثر من عشر دول كانت تعد ديمقراطيات ليبرالية، فقدت مكانتها خلال عام واحد فقط. وتضيف دراسة «أنماط الديمقراطية» أن 60 دولة تستخدم التضليل الإلكتروني والذكاء الاصطناعي لقمع النشطاء، وهو رقم يبدو متواضعاً لو قورن بالواقع.
غالبية المستطلعين يشتكون من أن النخب السياسية لا تهتم برأي المواطن. وما يخشى منه هو عودة إلى ديكتاتوريات صريحة، بوجهها العبوس، أو استبدادية «مودرن» بلباس عصري، لا تشهر مخالبها وإنما كاميراتها، وخوارزمياتها، ومنصاتها، وقراصنتها، تضعها كلها في خدمة ما بات يسمى «أنظمة سياسية هجينة» ويقصد بها أنها تعتمد على الانتخابات لإيصال أشخاص محددين إلى السلطة، يحكمون بقوة النفوذ ورأس المال.
وكما هناك «هاتف ذكي» و«غسالة ذكية» و«سيارة ذكية»، يوجد كذلك «استبداد ذكي» ينمو أمام أعيننا بحلة برّاقة وأدوات لمّاعة. هذا لم يعد حكراً على دول توجه إليها أصابع الاتهام مثل الصين وسنغافورة وروسيا، بل يتمدد كالوباء النشط.
تهادن الدراسات حين تقول إن ثلثي دول العالم تضع قيوداً على وسائل الإعلام، فيما الشعوب تشعر بالريبة، من كل مصادر الأخبار، تقليدية كما وسائل التواصل، وهذا يساهم في وضع الناس في مناطق يخيم عليها الشك وعدم الثقة.
في سبعينات القرن الماضي، بدت الديمقراطية وكأنها سيل جارف، أو نعمة لا بد منها، وصارعت شعوب كثيرة، من أجل الفوز بها. مع سقوط جدار برلين، قال لنا فرنسيس فوكوياما إنها «نهاية التاريخ» وإن الديمقراطية هي قدرنا، وأقصى ما ستبلغه البشرية من رقي. بعد أقل من عقد ونصف رأينا الحركات الشعبوية تغزو أميركا وأوروبا وتقلب الطاولة، وهي تحدثنا عن إيجابيات التقوقع والانعزال. خرجت بريطانيا بعدها من الاتحاد الأوروبي، ودعا دونالد ترمب في رئاسته الأولى، إلى حمائية أميركية كسبيل وحيد لاستعادة المجد الضائع، ورأينا مثيلاً له في المجر وبولندا.
حلّ الوباء ليلهب جذوة كانت خافتة، فازدادت الرقابة، وقيدت الحريات، وفرضت قوانين مكبلة، بحجة الحفاظ على صحة الإنسان، وبدأت حرب التتبع، بعد بصمات الأصابع، بصمة العين والوجه، وربما رفة الجفن.
لا براءة للتكنولوجيا من القمع الذي يتصاعد، فهي واحدة من الأدوات المحببة للأنظمة الحديثة التي تتهافت للحصول عليها، ومراقبة الشعوب، باسم حفظ الأمن وضبط المخالفات. كان هذا عيباً تعيّر به الصين، فصار أسلوب حكم، لا يملك الضحايا حق الاحتجاج عليه.
نحن في زمن «اقتراع أكثر وحرية أقل». معادلة غير مفهومة، لكنها واحدة من سمات العصر، التي ستتفاقم إن لم تحارب بكل وسيلة.
قدّمت إذاعة «فرنسا الثقافية» سلسلة حلقات متسلسلة تحت عنوان «إنهاء الديمقراطية»، تحدثت فيها عن خيبة الباحثين عن الحرية بعد انتهاء الحرب الباردة، وكيف أن السكاكين والخناجر تطعن في الديمقراطية من كل صوب. فهي تحارب في صناديق الاقتراع، ومن خلال فصلها عن العلمانية، وعبر أضاليل وسائل التواصل، وبقوة الرأسمالية، وفتنة الانتماءات والهوية، وأخيراً وليس آخراً جاء الوسط الأوروبي المتطرف، ليرميها بالضربة القاضية.
ولكن ماذا لو ماتت الديمقراطية فعلاً، أي بؤس ينتظرنا؟