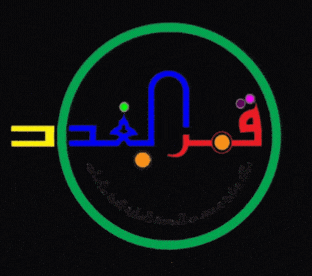يقود هذا التناقض المؤسسي إلى أحد الأعراض الرئيسية للأزمة الوجودية وهو “العجز الديموقراطي”. ففي نظر الشعوب في العديد من أجزاء الاتحاد، فإن العديد من القرارات التي تؤثر على مصالحهم تتخذ في بروكسيل البعيدة، ولكنهم أنفسهم لا يملكون قدراً كبيراً من السيطرة أو النفوذ على هذه القرارات.
أحمد نظيف
المصدر: “النهار”
أعاد دونالد ترامب – بسياسته التجارية الحمائية، وسياسته الدفاعية الانسحابية – وضع الأزمة الوجودية للاتحاد الأوروبي في قلب النقاش الأوروبي. تبالغ بعض التعليقات السياسية في تقديم ترامب وشرور الشعوبية كعاملٍ أساسي لهذه الأزمة. ولكن ذلك لا يمكن أن يحجب حقيقة الجذور الثقافية والطبقية للأخطار التي تهدد وجود الوحدة الأوروبية.
يواجه التكامل الأوروبي مشكلة أساسية وهي عجزه عن بناء مجتمع “أوروبي”. إن الازدواجية بين المكون الاتحادي والمكون الوطني، أصبحت مع الوقت مرضاً عضالاً. في الوقت الذي يتحول فيه الاتحاد إلى كيان سياسي ذي نفوذ كبير متمتعاً بحدود داخلية مفتوحة، وعملة مشتركة، وسياسات دفاعية موحدة ومنسقة، وشؤون خارجية، ومالية، وسياسات هجرة، فضلاً عن مؤسسات مثل البرلمان، والمفوضية الأوروبية، ومحكمة العدل، والبنك المركزي، وتؤثر قوانينه بشكل مباشر على كل مواطن داخل أراضيه، وبالتالي لم يعد منظمة دولية مثل الأمم المتحدة، أو رابطة دول جنوب شرق آسيا، أو صندوق النقد الدولي، لا تزال الدول الأعضاء فيه مستقلة نسبياً. فلديها مؤسساتها الوطنية الكاملة، كما أن شعوبها تقرر وتؤثر على انتخاب الزعماء المحليين وصوغ القوانين بطريقتها الخاصة. وتشكل هذه الازدواجية المؤسسية، حالة تناقض، بين الوحدة السياسية والتعدد المجتمعي، ومن هذا المنظور فإن الاتحاد الأوروبي لم يفلت تماماً من حالة الطبيعة – بالمعنى الدي طرحه هوبز- أو يمكننا أن نقول إنه معرّض لخطر الوقوع في حالة الطبيعة في أيّ وقت.
ويقود هذا التناقض المؤسسي إلى أحد الأعراض الرئيسية للأزمة الوجودية وهو “العجز الديموقراطي”. ففي نظر الشعوب في العديد من أجزاء الاتحاد، فإنّ العديد من القرارات التي تؤثّر على مصالحهم تتّخذ في بروكسيل البعيدة، ولكنّهم أنفسهم لا يملكون قدراً كبيراً من السيطرة أو النفوذ على هذه القرارات. وربما لا يعرفون حتى مَن يتّخذ القرارات. وهذا يجعل من السهل على الناس أن ينظروا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل باعتبارها مؤسسات “غير ديموقراطية” أو حتى “أجنبية”، ويشككون في شرعيتها بشكل أساسي.
واللافت أن مصطلح “العجز الديموقراطي” ظهر للمرة الأولى في سياق نقد ذاتي مبكر، في نص البيان الانتخابي الذي أصدره المؤتمر الفيدرالي الأوروبي للشباب عام 1977، والذي اتهم الجماعة الأوروبية آنذاك بالانفصال عن شعوب أوروبا، وبخاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف محرومة. وفي وقت لاحق، استخدم النائب البريطاني ديفيد ماكون المصطلح لانتقاد البرلمان الأوروبي لعدم انتخابه بشكل مباشر من قبل الشعب، وبالتالي فهو غير ديموقراطي بما فيه الكفاية، وقد استفادت الأحزاب اليمينية المتطرفة بشكل واسعٍ من هذا العجز، وقدمت نفسها بديلاً للأوليغارشية المركزية في بروكسيل.
تحتل مسألة بناء المجتمع السياسي مركزاً أساسياً في الفلسفة السياسية. فالمجتمعات السياسية الحديثة القائمة على الدولة القومية تفترض عادة وجود “شعب” واحد – حتى وإن كان متنوعاً عرقياً أو دينياً – يشكل الأساس لشرعية الأمة. ولكن ما يوجد حالياً في أوروبا لا يزال شعباً “تعددياً” وليس “شعباً واحداً”. فمنذ شرع الأوروبيون في بناء اللبنات الأولى للوحدة في أعقاب الحرب العالمية، اتفقوا على شكل كونفيدرالي، جعل من الصعب بناء مجتمع سياسي موحد، وحافظ على حدود سميكة تغذت طويلاً من الفوارق اللغوية والثقافية بين المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن عجز المؤسسات الأوروبية عن تطوير الوضع الكونفيدرالي إلى حالة فيدرالية، وحدها ستكون قادرة على بناء مجتمع أوروبي، لاسيما أن بناء الهوية الأوروبية لن يكون من فراغ، وليس مصطنعاً تماماً كما حدث في الولايات المتحدة، بل يتغذى على تصورات فلسفية وسياسية كانت دائماً ترى في القارة مكوناً واحداً. فقد توقع كانط مثل هذا الاتحاد. كما شكل مبدأ “الوحدة الأوروبية” أداةً للغزو الإمبراطوري، مع نابليون وهتلر لتوحيد أوروبا، فضلاً عن فكرة المصير المشترك، التي استمدت قوتها من الذاكرة الشخصية للأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية وأهوالها.