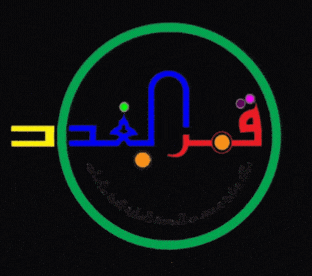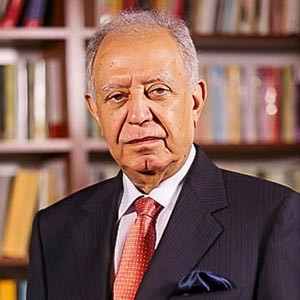فخري كريم
كتب إليَّ عددٌ من القراء ملاحظات ودية حول افتتاحية الاحتفاء بالعدد 6001 من المدى. كانت الملاحظات تدور حول استخدام مصطلحات نخبوية قد تستعصي على بعض القراء. وقد وجدت في ذلك النقد ما يستحق الإصغاء، فالفكرة لا تنقص بالتبسيط، بل تمنح حياةً أخرى حين تصاغ بلغةٍ قريبةٍ من الناس. غير أن المقالة، من حيث التشخيص والرؤية، كانت — في رأيي — التعبير الأدق عن هوية المدى، عن رسالتها الأولى، عن الجوهر الذي تأسست عليه منذ صدور العدد الأول، المؤسسة والمجلة والنهج الفكرية ودار المدى وكتاب مجاني مع جريدة وأسابيع المدى الثقافية ثم توجت بالمدى الجريدة اليومية وجميع الاصدارات والفعاليات التي نُظمت باسمها منذ التأسيس الاول في بيروت ودمشق وقبرص بل منذ ما قبلها بسنواتٍ طويلة حين كان الوعي نفسه في طور التكوين السياسي والفكري.
تلك المرحلة الأولى — كما في كل بداياتٍ كبرى — كانت أقرب إلى البراءة منها إلى اليقين، إلى الانتماء الأول قبل أن يتحول إلى إيمانٍ عميق.
ولم أستخدم مصطلحات “الإغريق القدماء” في توصيفها، لأنها كانت زمن التطلعات البريئة لا زمن الرموز الثقيلة.
أما اليوم، وقد صارت المحرمات هي السلطة، وصار الاقتراب من الحقيقة يهدد بالاغتيال، فقد باتت الحاجة إلى الرمز ضرورةً وجودية. فكل ما يمكن قوله عن حالتنا المزرية قيل وكتب مرارًا: عن شعبٍ مضام، وسيادةٍ منتهكة، وثرواتٍ منهوبة، ومستقبلٍ معلقٍ بقدرٍ مخاتل.
لكن الحقيقة اليوم لا تخفى لأنها غامضة، بل لأنها واضحة إلى حد الفضيحة.
حكام الصدفة هؤلاء تحصنوا بيقين البقاء، لا بإيمان المخلص المنتظر.
سويتهم الأخلاقية بلغت من الانحدار ما يجعل السفاهة مذهبًا، والفساد عقيدةً، والسلطة قدرًا مقدسًا.
إنهم الضالون الذين لم تعد الكلمات تكفي لتوصيفهم، ولا النعوت تفيهم حقهم من الخزي.
من هنا جاء لجوئي إلى لغة الإغريق، لا ترفًا لغويًا بل سلاحًا دلاليًا.
فما عجزت عنه صفحات الشرح تكفيه أربع كلمات، تكشف بنية الحكم، وتختزل طبيعة الخديعة التي نعيشها باسم الديمقراطية.
أولها: كليبتوقراطية — حكم اللصوص، حيث الدولة غنيمة، والمناصب أسلاب.
وثانيها: ثيوقراطية — حكم الملالي ورجال الدين، حيث يستبدل العقل بالفتوى، والوطن بالمذهب.
وثالثها: زبائنية — نظام المحسوبية والقرابة والولاء الأعمى، حيث الكفاءة جريمة، والنزاهة ضعف.
ورابعها: كليانية — الشمولية المقنعة التي تبتلع الفرد باسم الجماعة، والضمير باسم الطائفة، والحرية باسم الله.
لكن ما أغرى المقالة باعتماد لغة الإغريق أيضًا، هو أن المسرحيات الإغريقية القديمة كانت منذ بداياتها مرآةً للسياسة والضمير.
في أوديب الملك، كانت السلطة عمياء تبحث عن قاتلٍ يسكنها.
في أنتيغون، كان القانون يواجه الرحمة، والإنسان يقف عاريًا أمام جبروت الدولة.
وفي الفرس لإسخيلوس، كان الملوك يبكون على حماقتهم بعد فوات الأوان.
ذلك المسرح الذي أسس لوعيٍ جمعي يرى المأساة طريقًا إلى الحكمة، هو ما نحتاج إليه اليوم؛ أن نحيل واقعنا السياسي إلى تراجيديا يتعلم فيها الطغاة درسهم الأخير، لا على يد التاريخ فقط، بل على يد الوعي.
إن استخدام تلك المصطلحات الأربعة ليس زينة فكرية، بل إعادة تذكيرٍ بأن العالم، منذ إسخيلوس وسوفوكليس، لم يتغير كثيرًا: تتبدل الأسماء، لكن الجشع واحد، والعمى واحد، والمأساة ذاتها.
تلك الكلمات تختصر كتبًا كاملة، وتصف نظامًا في جملةٍ واحدة، وتعيد المعنى إلى السياسة بعدما ضاع في ضجيج الشعارات.
ولعل أجمل ما فيها أنها متاحة لأبسط قارئ، لا تحتاج إلا إلى لمسة من فضولٍ على محرك البحث لتفك أسرارها.
لكنها، رغم بساطتها، تحمل من الدقة ما يجعلها مرآة تامة لواقعٍ متداعٍ، ولطبقةٍ حاكمةٍ آمنت بأن لا حساب، وأن لا نهاية.
غير أن المسرح — كما علمنا الإغريق — لا يغلق ستارته إلا بعد الاعتراف.