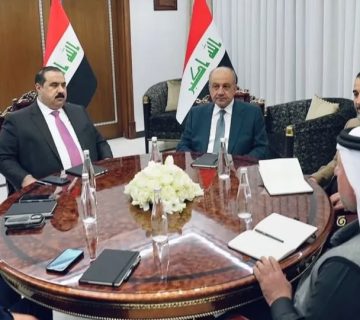يهدد الوضع المتأجج في الشرق الأوسط بالانفجار مرةً أخرى. لنتأمل ما حدث في الأسابيع الأخيرة: تبادل مباشر لإطلاق النار في سوريا بين إسرائيل وإيران، وانسحاب الرئيس الأمريكي من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، أي الاتفاق النووي مع إيران، وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، والمظاهرات التي تقودها «حماس» في غزة والتي سعت إلى خرق الحدود الإسرائيلية لكن دون جدوى، مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين.
ومن غير المحتمل أن تكون أي من هذه التطورات محدودة الوقت أو النطاق. لذا تتطلب على الأقل سياسةً أمريكيةً واضحة.
إن ما قدمه الرئيس ترامب حتى الآن هو خطب بليغة أكثر من كونها عملية. ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان [تعيين] وزير خارجية ومستشار للأمن القومي جديدين سيغيّر ذلك. ولكن ما لم تبدأ واشنطن بمحاولة بنّاءة وسريعة لصياغة الأحداث بدلاً من الرد عليها، فسيتفاقم الوضع في الشرق الأوسط لا محالة – ومن المحتمل أن يجرّ معه الولايات المتحدة في ظل ظروف أسوأ.
لكن قبل أن نغوص في المعضلة الراهنة، لنرجع خطوةً إلى الوراء ونقيّم النهج الأمريكي في المنطقة في السنوات الأخيرة. فلأسباب مفهومة، ركّزت إدارتا أوباما وترامب بشكل كبير على الإطاحة بتنظيم «الدولة الإسلامية». وكانت تلك المعركة ضروريةً وأتت بثمارها، لا سيّما خلال العام الماضي. ولكن بينما كان انتباه واشنطن ينصبّ على تنظيم «الدولة الإسلامية»، عملت إيران على توسيع نطاق انتشارها. وأصبح الآن المرشد الأعلى علي خامنئي يشير إلى سوريا ولبنان على أنهما جزء من الدفاع الأمامي لإيران. فالجمهورية الإسلامية لا ترسّخ نفسها في سوريا فحسب، بل تبني جسراً برياً يربطها بالبحر المتوسط ويمرّ عبر العراق وسوريا ولبنان. كما تستخدم إيران المليشيات الشيعية الوكيلة من أماكن بعيدة مثل أفغانستان وباكستان في سوريا.
وبالطبع، يبقى «حزب الله» وكيلها المفضل، مع عناصر يبلغ عددها ٧ آلاف مقاتل في سوريا، إلى جانب الدور الذي يؤديه الحزب في اليمن والعراق من تدريبات وتجميع للأسلحة ودعم عسكري. كما يعمل «حزب الله» عن كثب مع «فيلق القدس» – الذراع التنفيذي لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني – في جميع هذه المناطق. وقد تفاوت الدعم الإيراني المادي لـ«حزب الله» – فعندما كانت إيران ترزح تحت وطأة عقوبات شديدة من الأمم المتحدة، انخفض الدعم إلى ٢٠٠ مليون دولار في السنة تقريباً. أمّا بعد توقيع «خطة العمل الشاملة المشتركة» فقد عاد ليرتفع إلى حوالى ٨٠٠ مليون دولار.
ويحبّ ترامب إلقاء اللوم على الاتفاق الذي توصل إليه أوباما مع إيران معتبراً إياه السبب وراء كل هذا التدخل الإيراني، لكن هذا التفسير شديد البساطة. فالحقيقة هي أن إيران أصبحت أكثر عدوانيةً في عهد ترامب، بينما لم تفعل إدارته شيئاً لوقف ذلك. وقد ساعد الرئيس الأمريكي في الواقع، بتنازله عن أجزاء كبيرة من سوريا إلى روسيا، على جبهة واحدة على الأقل، في تشجيع الملالي في طهران.
وأصبح تفضيل إيران العمل من خلال وكلائها وتهديد الآخرين بشكل غير مباشر هو النمط السائد. لكن في شباط/فبراير من هذا العام، تصرّف «فيلق القدس» على غير عادته، حيث أطلق طائرةً مسلّحة بدون طيار من سوريا إلى المجال الجوي الإسرائيلي. وبإرساله طائرته الخاصة بدون طيار، اختار «فيلق القدس» أن يتحدى الإسرائيليين بشكل مباشر.
وبعد أن أدركت إسرائيل أنه يجري تجاوز الحدود المرسومة، أطلقت النار على الطائرة بدون طيار ودمّرت عربات القيادة والتحكم الإيرانية التي أطلقت الطائرة ووجهتها من “قاعدة التياس” (T-4) الجوية العسكرية في وسط سوريا. وعند خسارة إحدى طائراتها المقاتلة من طراز “أف – ١٦” فوق المجال الجوي الإسرائيلي جراء وابل من صواريخ أرض-جو، قامت إسرائيل بعد ذلك بتدمير قرابة نصف الدفاعات الجوية السورية دون أن تفقد أي طائرة أخرى. وكان الإسرائيليون يحاولون التلميح إلى الإيرانيين والروس أيضاً – بأنهم لن يتسامحوا مع إيران التي تهددهم بصورة مباشرة بدرجة أكبر.
إلا أنّ هذا كان مجرد تمهيد للتبادل العسكري الأخير. ففي ٩ نيسان/أبريل، قامت إسرائيل مرةً أخرى بضرب عدد من الأهداف الإيرانية، ليس فقط لملاحقة قدرة إيران على إطلاق طائرات بدون طيار، بل صواريخ أيضاً. وعادة لا تعترف إسرائيل بهذه الضربات أبداً، إذ تدرك أنه إذا ما أُشيد بها علناً، فمن شأن ذلك أن يضع الإيرانيين في موقف يضطرهم إلى الرد وإلا فسيخسروا ماء الوجه. لكن روسيا “كشفت” الإسرائيليين – وكان هذا مهماً لأنه ما لا يقل عن سبعة من ضباط «فيلق القدس» كانوا قد قُتلوا في الضربة الإسرائيلية. وعلماً منهم أن إيران قد تضطر إلى الرد، اختار الروس أن يفضحوا الاسرائيليين على أي حال – مما يشير دون أي شك إلى أنهم لم يكونوا راضين من عدم تحذيرهم مسبقاً عندما كان الروس موجودون في القاعدة نفسها. ولم يكن مفاجئاً أن يؤدي هذا الكشف إلى دفع إيران إلى الإعلان بأنها ستقوم بردّ انتقامي.
وقد جاء ذلك الرد بعد يوم واحد من انسحاب الرئيس ترامب من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ولم يكن ذلك التوقيت مجرد صدفة. فقد امتنعت إيران [قبل ذلك] عن القيام بأي خطوة، إذ لم ترغب أن تستخدم إدارة ترامب [ما كانت ستقوم به] كسبب للانسحاب من “الاتفاق النووي”. ولكن بعد تحريرها من هذا الهاجس، أطلقت صواريخها على إسرائيل. وقد اعترضت “القبة الحديدية” الإسرائيلية أربعة صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، بينما سقطت الصواريخ المتبقية في سوريا. ولإثبات أن الإيرانيين سيدفعون ثمناً باهظاً، ضرب الإسرائيليون عدة قواعد إيرانية وشيعية في جميع أنحاء سوريا ودمّروا، على حد تعبير وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الكثير من البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا.
أما في الوقت الحالي، فمن الواضح أنه ليست هناك نية لدى الإيرانيين بمواصلة التصعيد مع إسرائيل. فطبيعة الرد الانتقامي الإيراني، أي إطلاق النار على المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان فقط وليس على الأهداف المدنية في البلاد، هو خير دليل على ذلك. فالإيرانيون منشغلون جداً في تعزيز مكانتهم في سوريا لدرجة أنهم لا يريدون ضرب إسرائيل في الوقت الراهن. إلّا أنّ هذه الصورة لا ينبغي أن تضلّل أحد، فإسرائيل وإيران على مسار تصادمي. فقد عقدت إيران العزم على ترسيخ نفسها في سوريا، في حين لا تقل إسرائيل إصراراً على ضمان عدم قدرة إيران على تأسيس وجود لها في سوريا على غرار ما فعلته في لبنان، حيث يمتلك «حزب الله» اليوم أكثر من ١٢٠ ألف صاروخ. ولا بد من تداعي الوضع [العسكري]. وفي هذه المرحلة، يبدو أنها مسألة وقت فقط قبل اندلاع مثل هذه الحرب.
وللأسف، من السهل تصوّر بداية هذه الحرب، ولكن ليس نهايتها. أقول ذلك لأن إيران تعتقد أن بإمكانها أن تهدد إسرائيل من سوريا ولبنان والوقوف في مأمن من الصراع. غير أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتنظيم حرب ينهال عليها ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ صاروخ في اليوم، بينما تبقى إيران بمنأى عن ذلك كلياً. وفي مثل هذه الظروف، ستضرب إسرائيل إيران بطريقة مصمّمة بحيث تلحق بها أضراراً كبيرة، أي ربما تضرب المنشآت النفطية الإيرانية. عندئذٍ، قد يختار الإيرانيون الرد على السعودية أو أي مكان آخر في الخليج. وبدلاً من انتظار تحقُقْ مثل هذا السيناريو، ينبغي على واشنطن العمل على إيقافه.
لكن الولايات المتحدة لا تزال تتّخذ موقف المتفرج في الوقت الحاضر. أجل، لقد قدّمتْ عرضاً كبيراً بنقل سفارتها إلى القدس، إلّا أنّها تترك الأمر للإسرائيليين لصد الإيرانيين في سوريا. لقد تركتْ واشنطن إسرائيل في وضع يتطلب منها استخدام القوة بدلاً من الحوار للتأثير على الإيرانيين والروس.
وليس من قبيل المصادفة أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن بزيارة فلاديمير بوتين ثماني مرات خلال العامين الماضيين. أجل، لقد هدفت هذه الزيارات إلى تفادي الصراع مع القوات الروسية، ولكن أيضاً إلى محاولة إقناع بوتين باحتواء الإيرانيين في سوريا. وقد نجح نتنياهو إلى حد كبير في المسألة الأولى. ولكنه لم يفلح في الثانية. فقد منحت روسيا للإسرائيليين والإيرانيين حرية التصرف الكاملة – وهي حقيقة تجعل التصادم الذي يلوح في الأفق أكثر احتمالاً.
وتقليدياً، كانت الولايات المتحدة ستعمل على إقناع الروس بأن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح باندلاع مثل هذا الصراع، مؤكدةً أنه إذا لم يتخذ الروس أي إجراء، فستقوم هي بذلك – وليس من خلال دعم إسرائيل فحسب، بل عن طريق الإشارة بوضوح إلى أنها ستقوم باستخدام قوتها الجوية لوقف توسع الإيرانيين ووكلائهم بدرجة أكبر في سوريا. وآخر شيء يريده بوتين هو أن تظهر القدرة الأمريكية كقوة محرّكة للأحداث في المنطقة. فهذا هو دوره، ويبدو أنه ينجح فيه.
لكنّ الرئيس ترامب لا يبدو منزعجاً من هذا الاحتمال. فهو يشبه الرئيس أوباما إلى حد كبير، حيث لا يريد أن يتدخل كثيراً في الصراع السوري؛ وفي رسالة تم نشرها على نطاق واسع، ذهب إلى الحد الذي دعا فيه السعودية والإمارات إلى توفير الأموال وإرسال القوات إلى ميدان المعارك لمنع إيران من ملء الفراغ بعد أن تلحق الولايات المتحدة الهزيمة بتنظيم «الدولة الإسلامية». إنها رغبة مفهومة، لكن لا السعوديين ولا الإماراتيين سيؤدون هذا الدور ويُعرّضون أنفسهم [إلى الكثير من المخاطر] إذا ما انسحبت الولايات المتحدة – وقد أوضح ترامب أن هذا هو ما يعتزم القيام به.
ويبدو أن الوقوف على الجانب هي السياسة الرئيسية التي تتبعها الولايات المتحدة حالياً في الشرق الأوسط. فقد اتخذت خطوةً طال انتظارها ونقلت سفارتها إلى القدس، ولكن واشنطن لا تمهّد الطريق مسبقاً مع شركائها العرب المفترضين من خلال معرفة ما يمكن أن تقوله لكي تفسح لهم المجال لدعم خطواتها – أو على الأقل لعدم معارضتها. وكما أخبرني أحد المحللين العرب مؤخراً: “لو قال الرئيس [الأمريكي] على الأقل إنه يعترف أن لدى الفلسطينيين مطالب في القدس الشرقية لا بد من التفاوض بشأنها، وأنه لهذا السبب لم يعترف بحدود السيادة الإسرائيلية، لكان قد منحنا شيئاً نشير إليه”. بمعنى آخر، أن ذلك كان سيسهَّل على العرب لعب دور ما عندما تعرض الإدارة الأمريكية خطتها للسلام – تلك الخطة التي يستلزم أن تكون الآن أكثر تحديداً حول القدس فيما يتعلق بصلتها بالفلسطينيين مما كان عليه الحال سابقاً. أما بالنسبة لتوقيت تلك الخطة، فسيتعيّن تغيير الظروف الراهنة قبل أن تتمكن الإدارة الأمريكية من عرضها. ويعني ذلك، من بين أمور أخرى، العمل لمنع حدوث انفجار في غزة.
وتعمل «حماس» بدرجة لا يستهان بها على صرف الانتباه بعيداً عن حكمها الفاشل في غزة والضغط على رئيس “السلطة الفلسطينية” محمود عباس. وقد توقف عباس عن سداد [ثمن] الكهرباء الذي تمد به إسرائيل قطاع غزة، وقلّص مرتبات العاملين السابقين في “السلطة الفلسطينية” في القطاع، كما هدّد بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية. بيد، تكمن المشكلة في أن الفلسطينيين في غزة هم الذين “يدفعون” ثمن [هذه التطورات] – فتوفير الكهرباء هو لأربع ساعات يومياً فقط، و [أزمة المياه تزداد سوءاً بحيث أن] ٩٦٪ منها غير صالحة للشرب، كما أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي معطّلة، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الفلسطينيين دون سن الثلاثين لتصل إلى ٦٠٪. ومع ظروف سيئة للغاية كهذه، ليس لدى فلسطينيي قطاع غزة ما يخسرونه.
لنكون منصفين مع إدارة ترامب، فقد قامت بالفعل بتنظيم مؤتمر للمانحين من أجل غزة، إلّا أنّه لم يتحقق شئ منه. لذلك، فقد حان الوقت للعمل مع الأوروبيين والعرب لإصدار بيان يُعلن فيه عن وجود استعداد فوري لتنفيذ المشاريع الجاهزة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء، إذا كان هناك هدوء في غزة. ونظراً إلى الجو السائد في القطاع، يدرك قادة «حماس» أنهم لا يستطيعون منع خطوات دولية جديرة بالثقة لمعالجة الظروف الاقتصادية الرهيبة في غزة بصورة فورية.
وقد يفضّل الرئيس ترامب إبعاد الولايات المتحدة عن نزاعات الشرق الأوسط، إلّا أن هذه الصراعات تعود لتطارد واشنطن. كما أنّ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لن يردع جهود إيران التوسعية في المنطقة. بل على العكس من ذلك، فعاجلاً أو آجلاً، سيؤدي هذا التوسع إلى اندلاع حرب أوسع نطاقاً. لذا فإن الخيار الذي تواجهه واشنطن هو الانخراط حالياً أو في وقت لاحق.