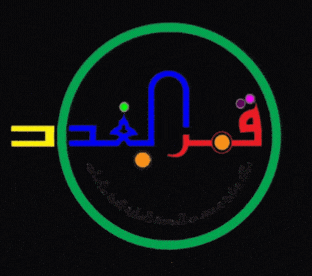ترجم روايتين للمجري «كراسناهوركاي» قبل حصوله على نوبل
برغم أنه خريج جامعة دمشق، تخصص الهندسية الميكانيكية، فإن المترجم السوري الحارث النبهان صنع اسمه، وحقق شغفه من خلال عشرات المؤلفات التي نقلها إلى العربية بأسلوب مشوق وعناوين لافتة. يقيم حالياً ببلغاريا، وتتركز أعماله حول روايات مهمة لأدباء غير متداولين بقوة على الساحة العربية مثل النرويجي كارل أوفه كناوسغارد صاحب سداسية «كفاحي» والآيرلندي ديفيد بارك مؤلف «ارتحال في أرض غريبة».
تردد اسم النبهان مؤخراً، حين اكتشف الجميع أنه مترجم الروايتين الوحيدتين المتاحتين بالعربية لأحدث الأدباء الحائزين على جائزة «نوبل»، لازلو كراسناهوركاي، وهما «كآبة المقاومة» و«تانغو الخراب». هنا… حوار معه حول الترجمة والمشكلات التي تصادفه في الكثير من النصوص.
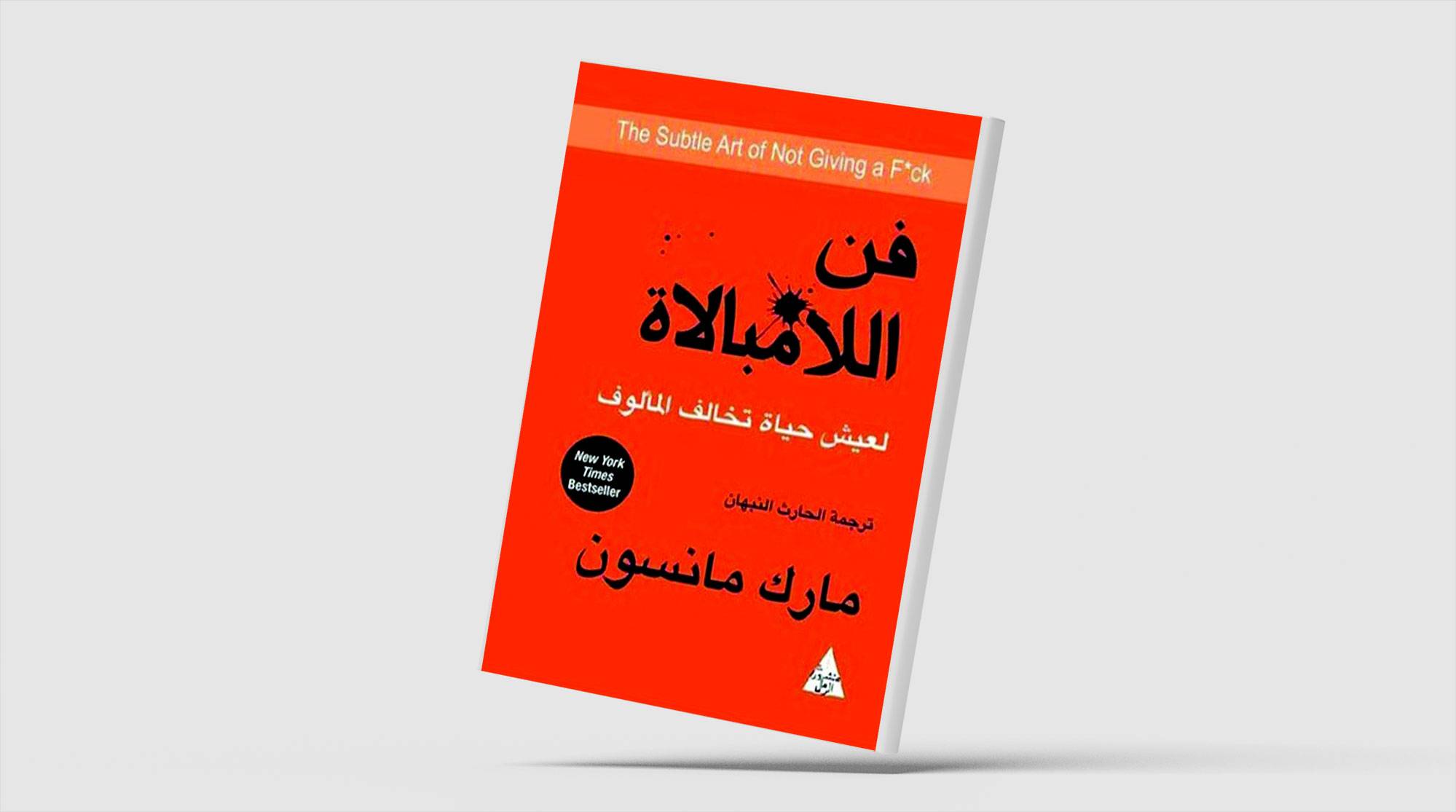
كيف كان شعورك حين وجدت أن الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي فاز بـ«نوبل» بعد مرور سنوات طويلة على ترجمتك لروايتيه الوحيدتين المتاحتين بالعربية: «كآبة المقاومة» و«تانغو الخراب»؟
– بالتأكيد، سرّني هذا الفوز كثيراً لأن كراسناهوركاي متميز فعلاً؛ من حيث أسلوبه المسهب المتلاحق، وجمله الطويلة وأجوائه الفلسفية التي تضفي على الشخصيات والأشياء والطبيعة والعلاقات بين الناس مسحة ثقيلة من الكآبة والإحساس باللاجدوى، فضلاً عن براعته في استدراج القارئ إلى هذا الجو حتى يحس بالعالم يضيق من حوله.
> ألم تتخوف من أن الكاتب غير معروف وقتها؟
– الحقيقة أنني لم أكن متشجعاً في البداية ليس لأن الكاتب غير معروف عندنا فحسب، بل أيضاً لأن الترجمة كانت عملاً مرهقاً بالفعل. كانت البداية مع «تانغو الخراب»، الذي هو نص أبطأ إيقاعاً و«أثقل على النفس» من العمل الثاني «كآبة المقاومة»، لكني لم ألبث أن تلمست تفوق هذا الكاتب وتميزه فمضيت في المشروع بقدر أكبر من الثقة.
> ألم يساورك القلق من أن الروايتين تغرقان في أجواء كابوسية وتنضحان بالتشاؤم والرؤى السوداوية، وهو ما قد يبدو محبطاً للقارئ العربي؟
– صحيح أن الروايتين ناضحتان بالسوداوية والتشاؤم، وصحيح أن فيهما ما يقارب الكوابيس، لكن هذا لا يعني أنهما غير مناسبتين أو أنهما محبطتان للقارئ سواء أكان عربياً أم غير عربي، وإلا ماذا عن كافكا وأعماله كلها؟ كل ما في الأمر أن هذا النوع من الكتابات ليس محبذاً للجميع، ولا يقدر كل قارئ على مواكبته. هذا أمر طبيعي.
> ما الذي شدَّك إلى العالم الأدبي لهذا الكاتب غير المعروف عربياً؟
– يثير حماستي أن أترجم لمؤلفين لا يزالون غير معروفين للقارئ العربي، فهذا يشبه استطلاع أرض مجهولة وفيه نوع مغرٍ من «الريادة»، ومن الإبحار في مياه لا تزال بكراً. وقد كان من بين الكُتاب الذين «استطلعتهم» قامات عظيمة جداً أذكر منهم النرويجي كارل أوفه كناوسغارد صاحب سداسية «كفاحي»، التي يضاهي النقاد بينها وبين «البحث عن الزمن المفقود» للفرنسي مارسيل بروست. لم أترجم من «كفاحي» إلا أربعة أجزاء صدرت عن دار التنوير، ولا يزال الجزءان الخامس والسادس في انتظار ناشرٍ يتصدى لهما.
هناك أيضا الآيرلندي ديفيد بارك صاحب الرواية الهائلة، وإن تكن صغيرة الحجم «ارتحال في أرض غريبة» التي صدرت مؤخراً عن دار «سدرة» في دولة الإمارات، وأنا أعتبره كاتباً لا يزال مظلوماً ولم يحظَ بعد بما يستحق من مجد وتكريم، وأتمنى أن تسنح لي فرصة لترجمة أعمال أخرى له.
> كيف تعاملت مع مشكلة أن الجُمل طويلة للغاية لدى لازلو كراسناهوركاي، حتى إن جملة واحدة قد تأخذ صفحة ونصف؟
– كانت هذه مشكلة بالفعل وذلك لسببين اثنين: الأول هو صعوبة الأمر، فكيف لي أن أكتب كلاماً يكون مفهوماً للقارئ من غير أن أستخدم فواصل ونقاطاً وما إلى ذلك من علامات الترقيم؟ وأما السبب الثاني فهو الخشية من جور «المحرر» لدى دار النشر فهو المسؤول عن «مقروئية» الكتاب، التي هي أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى أي ناشر، وذلك خاصة عندما يغامر بأن يقدم إلى القارئ كاتباً لا يزال غير معروف عنده.
والفكرة هنا أنه إن وجد القارئ صعوبة كبيرة في قراءة واحد من كتب كافكا مثلاً فلن يلوم الناشر، ولن يلوم الكاتب ولا المترجم، بل سيلوم نفسه لأن كافكا اسم كبير معروف جداً. لكن عندما يتناول كتاب كراسناهوركاي، ذلك الكاتب الذي كان لا يزال مجهولاً، فسوف تصدمه غرابة أسلوبه، وصعوبة تفكيك جمله بالغة الطول، وسوف يعيد الكتاب إلى مكانه من غير أن يشتريه.
بالتالي كان عليَ أن أبتكر طرقاً أو «حيلاً» من أجل تجزئة الجمل الطويلة جداً مع الإبقاء على نوع من الترابط المحسوس بينها. أعلم أن في هذا قدراً من «خيانة» النص، لكن الترجمة كلها تنطوي دائماً على بعض من هذه الخيانة، وهذه ضريبة لا بد من احتمالها.
> كيف بدأت علاقتك بالترجمة من الأساس؟
– بدأت علاقتي بالترجمة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكني لم أحترفها إلا سنة 2005، ثم اقتصرت على ترجمة الكتب، لا سيما الروايات منذ 2013. وربما تنبغي الإشارة هنا إلى أن دراستي الجامعية بكلية الهندسة لا علاقة لها بالترجمة من قريب أو بعيد. لكني كنت قارئاً نهماً منذ صغري باللغة العربية. وقد شملت اهتماماتي دائرة واسعة من الموضوعات الأدبية، نثراً وشعراً، والعلمية والتاريخية، ومن أعمال كتّاب اللغة العربية العظام، من قدامى ومعاصرين، كالجاحظ وابن المقفع والمعري وعبد الحميد الكاتب وطه حسين، الذي أراه أهم من كتب بالعربية في العصر الحديث، فكراً ولغةً، وعباس محمود العقاد، وعبد الرحمن بدوي، وغيرهم.
كان لهذه القراءات أثر كبير من حيث صوغ ذائقتي اللغوية وتمتعي بقدر لا بأس به من المرونة أو القدرة على «التلوّن» الأسلوبي بما يناسب النص الذي أعمل على ترجمته. فعلى سبيل المثال، كانت لغتي من حيث المفردات ومن حيث الأسلوب في كتاب «السيرة الذاتية لجون ستيوارت مِل» مختلفة جداً عن لغتي في ترجمة أعمال أندريه دو بوتون.
> إلى أي حد أثرت هجرتك إلى الغرب على مشروعك في الترجمة، وهل ساهمت في توسيع أفق الرؤية والاختيار لديك؟
– لا أعلم كيف أجيب عن هذا السؤال، والحقيقة أنني أحار عندما يواجهني سؤال عن «مشروعي» في الترجمة. لا يستطيع المترجم أن يكون صاحب مشروع في الترجمة إلا إذا كان ناشراً أيضاً، أو ثمة «تحالف» بينه وبين ناشر متمكن. لا أهمية أبداً، ولا جدوى، لأن يقرر المترجم اتخاذ «خط» بعينه في عمله لأن المسألة الجوهرية هنا هي أن تصل أعماله إلى القارئ. وهذه مهمة الناشر.
جلّ ما أستطيعه هو أن أقبل عملاً يُعرض عليّ أو أن أرفضه. وقد تسنح لي أحياناً فرصة اقتراح كتاب أو أكثر، لكن قرار تبني مشروع ترجمة أي كتاب يظل مرتبطاً بعوامل كثيرة تتعلق بالسوق لا يستطيع المترجم تقديرها ولا يستطيع أن يكون مسؤولاً عنها. إن توفر لي ناشر يقبل أن أقترح عليه مشروعاً يشتمل على عدد كبير من الكتب تمثل بجملتها «خطّاً» ذا معالم واضحة، ويمتد العمل عليها فترة طويلة، خمس سنوات مثلاً، أو عشر سنين، فيتبنى ذلك المشروع بحيث أكون متفرغاً له وحده فهذه غاية المنى.
لكن في غياب خيارات من هذا النوع يظل عملي جارياً على مبدأ «من كل بستان زهرة»، ويظل جهدي منصباً على محاولة تقديم أفضل الممكن من بين ما هو متاح. وأما عن أثر الهجرة على عملي فلست أظنه كبيراً مع أن اتساع نظرة المرء إلى العالم يظل أمراً لا مراء فيه.
مشكلات الترجمة في العالم العربي هي نفسها مشكلات القراءة والنشر
> على أي أساس تختار أن تترجم كتاباً وتستبعد آخر؟ لا سيما أن ترجماتك لا تقتصر على اللون الأدبي، وإنما تمتد لتشمل الفلسفة والتنمية البشرية وعلم النفس؟
– أفضل دائماً ترجمة الرواية، لا لشيء إلا لأنني أرى نفسي أجيدها أكثر من غيرها. أي أنني أكون «مرتاحاً» أكثر فتكون الرواية نفسها مرتاحة مثلي. صحيح أن التنوع أمر إيجابي محمود، لكنه لا ينم عن توجه مقصود من جانبي، فأنا أختار من بين ما هو معروض عليّ.
> يلاحظ البعض أن الكتب المصنفة ضمن «الأكثر مبيعاً» تثير اهتمامك، هل هذا صحيح وهل تهتم بمؤشرات السوق التجارية؟
– لا تهمني مؤشرات السوق ولا أتابع حجم مبيعات هذا الكتاب أو ذاك، لكن الكتب «الأكثر مبيعاً» تتصدر اهتمامات الناشرين أكثر الأحيان.
> كيف ترى مشكلات الترجمة في العالم العربي من موقعك في بلغاريا؟
– مشكلات الترجمة في العالم العربي هي نفسها مشكلات القراءة والنشر، نحن قوم لا نحب القراءة… هذا هو الأمر، للأسف. في بلغاريا عدد السكان أقل من سبعة ملايين، ومع ذلك يتراوح عدد النسخ المطبوعة من الكتاب المترجم بين ألف وألفي نسخة. أما في العالم العربي، فيكون الكتاب الذي يبيع ألف نسخة خلال 3 سنين «كتاباً ناجحاً» بالنسبة إلى الناشر. المسألة مسألة سوق، أولاً وأخيراً.
> أخيراً، يمازحك البعض بالقول إن نجم كرة القدم العالمية محمد صلاح ساهم في شهرتك حين نشر غلاف كتاب «فن اللامبالاة» عبر حسابه الرسمي… كيف ترى تفاعل المشاهير مع مؤلفاتك ومع الكتب عموماً؟- لا أعلم شيئاً عن تفاعل المشاهير فأنا لا أتابع أخبارهم، وهذا تقصير مني. وأما ظهور كتاب «فن اللامبالاة» في حساب محمد صلاح، فقد كان ذا أثر كبير جداً على مبيعات الكتاب، وفي جعل اسمي معروفاً أكثر بين القراء. كان أثر صورة صلاح حقيقة وليس مزاحاً، شكراً لأسطورة الكرة؛ وليت المشاهير جميعاً «يعطفون» على الثقافة والكتب، ولو قليلاً.