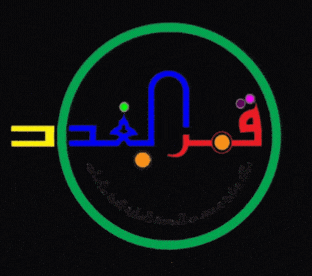شهدت الساحة الدولية والفكريّة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة تحولات جيو-سياسية ومعرفية عميقة، أعادت تشكيل المفاهيم السائدة حول طبيعة العلاقات الدولية. فبعد عقود من الصراع الأيديولوجي الثنائي القطبية، وجد العالم نفسه أمام فراغ استراتيجي سارع المفكرون الغربية لملئه بنظريات تفسيرية جديدة.
في هذا السياق، برزت أطروحة “نهاية التاريخ” لفرانسيس فوكوياما التي بشرت بانتصار الليبرالية الغربية كقدر محتوم للبشرية، تلتها أطروحة “صدام الحضارات” لصامويل هنتنغتون التي رسمت صورة قاتمة لمستقبل تهيمن عليه الصراعات الثقافية والدينية.
في المقابل، لم يقف الفكر الإنساني، والإسلامي على وجه الخصوص، موقف المتفرج أمام هذه التنظيرات التي تؤسس للصراع، بل برزت دعوات مضادة تؤكد على حتمية “الحوار” وضرورة “التعارف” كبديل استراتيجي لإنقاذ البشرية. إن الانتقال من نموذج الصدام إلى نموذج الحوار ليس مجرد ترف فكري، بل هو ضرورة وجودية تمليها التحديات المشتركة التي تواجه سكان الكوكب.
إلا أن هذه الرؤية التبشيرية لصدام الحضارات اصطدمت بواقع عالمي معقد. فالنظام العالمي الجديد لم يحقق الرفاه والعدالة الموعودة، بل كرس الفجوة بين الشمال والجنوب، وأدى إلى تهميش ثقافات وحضارات عريقة.
ارتبطت أطروحات فوكوياما وهنتنغتون بظاهرة العولمة، التي كان يُفترض أن تكون جسراً للتواصل، لكنها تحولت في ظل الهيمنة الغربية إلى أداة للإقصاء. فالعولمة بصيغتها الحالية تسعى لتعميم النموذج الغربي (مركزية الغرب) وتحويل بقية العالم إلى هامش تابع.
يُعد المفكر الفرنسي روجيه غارودي من أبرز المنظرين لحوار الحضارات في الفكر الغربي المعاصر. وفي كتابه “حوار الحضارات”، يطرح غارودي رؤية نقدية للحضارة الغربية، معتبراً أنها ارتكبت جريمة كبرى عندما اختزلت الإنسان في بعده المادي والتقني، وأقصت الأبعاد الروحية.
يقدم الإسلام نموذجاً متجاوزاً لمجرد “الحوار” الدبلوماسي، وهو نموذج “التعارف”. يستند هذا المفهوم إلى الآية المركزية في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾.
وفقاً لهذا المنظور، فإن الاختلاف والتنوع البشري هو إرادة إلهية وسنة كونية لا يمكن إلغاؤها (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة).
هناك تطبيقات تاريخية للنموذج الإسلامي، إذ لم يكن الحوار والتعايش مجرد تنظير في التاريخ الإسلامي، بل كان ممارسة واقعية. ويُشير الباحثون إلى نماذج مبكرة مثل “الهجرة إلى الحبشة” حيث تعايش المسلمون الأوائل مع مجتمع مسيحي تحت حكم النجاشي في إطار من الاحترام المتبادل.
كما تُعد “صحيفة المدينة” (دستور المدينة) أول وثيقة دستورية تؤسس لمجتمع تعددي يعترف بحقوق المكونات المختلفة (اليهود، المسلمين، القبائل) في إطار المواطنة والعيش المشترك. وكذلك استقبال النبي (صلى الله عليه وسلم) لوفد نصارى نجران وسماحه لهم بالصلاة في مسجده، وحواراته معهم، تمثل قمة التسامح والاعتراف بالآخر الديني والحضاري.
تمتلك الثقافة الإسلامية رصيداً قيمياً يمكن أن يساهم به في إنقاذ البشرية، إذ لم يعد الحوار خياراً، بل أصبح ضرورة حتمية تمليها عدة اعتبارات:
- الضرورة الأمنية والوجودية: في ظل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب العابر للحدود. فإن البديل عن الحوار هو الفناء المشترك أو الفوضى الشاملة.
- الضرورة البيئية: أيضاً إذ يواجه الكوكب تحديات مناخية تهدد الوجود البشري.
- الضرورة الاقتصادية: تشابك المصالح الاقتصادية في عالم معولم يجعل من الصراع الصفري كارثة على الجميع، ويحتم البحث عن صيغ للتعاون والتكامل.
لكن لماذا يتعثر الحوار؟ هناك عقبات منهجية ومعرفية تتمثل في هيمنة النظرة الاستعلائية الغربية، وعقبات سياسية ومصلحية، ومحاولة استثمار الدوائر السياسية والعسكرية في الغرب لظاهرة “الإسلاموفوبيا” لتعويض غياب العدو السوفييتي، ومحاولة ربط الإسلام بالتطرف الديني والإرهاب.
لكي ينجح الحوار ويتحول إلى تعارف مثمر، لابد من الندية والتكافؤ، لا حوار بين “سيد” و”مسود”.
يجب أن يقوم الحوار على الاعتراف المتبادل بالكرامة والسيادة. والبحث عن المشترك عبر التركيز على القيم الإنسانية الجامعة (العدل، الحرية، الرحمة، صيانة البيئة) كأرضية صلبة للتعاون.
وأخيراً النقد الذاتي. شجاعة كل طرف في نقد ممارساته وتاريخه، والاعتراف بالأخطاء، مثل الاعتراف بجرائم الاستعمار من جهة الغرب، ونقد الجمود والتطرف من جهة المسلمين، وتحويلها إلى ثقافة شعبية عبر المناهج الدراسية والإعلام والفنون، من خلال تتبع المسار الفكري والسياسي للعلاقة بين الحضارات، إلى أن نظرية “صدام الحضارات” التي صاغها هنتنغتون، ونظرية “نهاية التاريخ” لفوكوياما، لم تكونا مجرد قراءات استشرافية بريئة، بل كانتا تعبيراً أيديولوجياً عن لحظة زهو القوة الغربية ومحاولة لتأبيد هيمنتها من خلال صناعة عدو بديل (الإسلام) أو فرض نموذج أحادي (الليبرالية).
وقد أثبت الواقع الدولي، عبر المآسي والحروب التي شهدها العقدان الماضيان، عقم هذه النظريات وخطورتها على السلم العالمي.
وفي المقابل، يبرز مشروع “حوار الحضارات”، ومفهوم “التعارف” القرآني، كبديل استراتيجي وأخلاقي وحيد لإنقاذ البشرية.
إن الحضارة الإسلامية، بما تمتلكه من رصيد قيمي وتاريخي في استيعاب التنوع والاعتراف بالآخر، مؤهلة للعب دور محوري في هذا الحوار، شريطة أن تستعيد وعيها بذاتها وفاعليتها الحضارية. كما أن الغرب مطالب بمراجعة نزعته المركزية والاستعلائية، والإدراك بأن أمنه ورفاهه مرتبطان بأمن ورفاه الآخرين.
المستقبل لن يُصنع بالأسوار والجدران العازلة، بل بالجسور الممدودة والكلمة السواء، والبحث الدائم عن المشترك الإنساني الذي يحفظ كرامة الإنسان ويصون عمران الأرض.