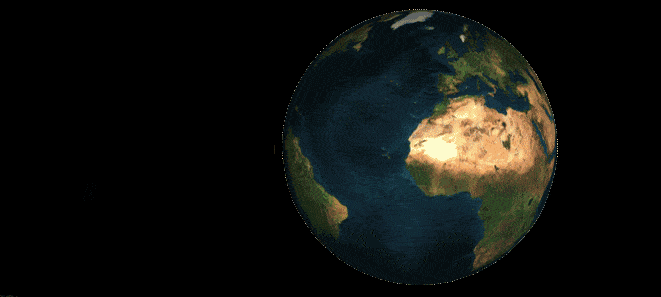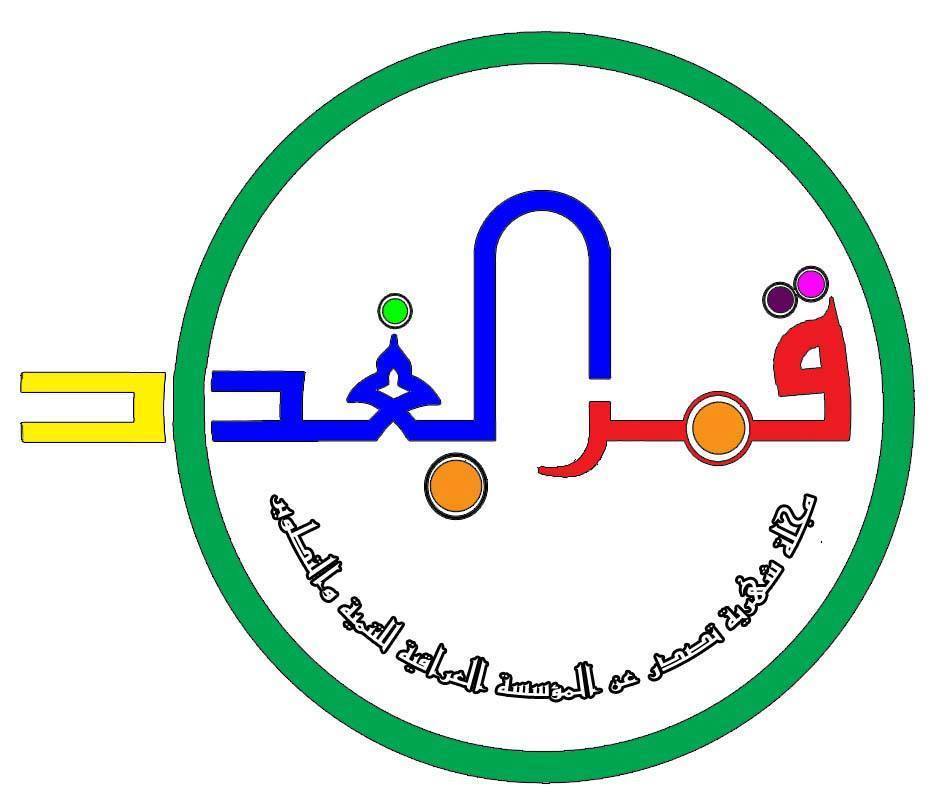د.احمد مصطفى
من الأقوال الشهيرة التي أصبحت شائعة لدى العامة من الناس، وليس فقط المتخصصين والمثقفين، مقولة الاستراتيجي الألماني كارل فون كلاوسفيتس في كتابه عن الحرب “ما الحرب إلا استمرار للسياسة بسبل أخرى”. وفي زمن كلاوسفيتس (نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر) كان ذلك يعني أن الحرب هي من أدوات إنفاذ السياسة مع الدبلوماسية وغيرها. وبتطور الزمن، والعلاقات بين الدول وداخل الدول، تعددت أدوات إنفاذ السياسة من تجارة واقتصاد وعقوبات وغيرها إنما تظل العسكرية والدبلوماسية ركيزتين أساسيتين في إنفاذ السياسات وتحقيق الأهداف.
تذكرت ذلك مع كثرة الكتابات والتحليلات التي تعلق على استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وخصوصا تلك التي تناولت تأثير ذلك على السياسة الخارجية الأميركية وعلاقة الولايات المتحدة مع العالم عموما. وليس التأثير هنا مقصورا على انتشار القوة العسكرية الأميركية في أنحاء العالم ولا الخطط والاستراتيجيات العسكرية الأميركية التي تتجاوز أراضيها لحماية مصالحها حول العالم. صحيح أن أغلب تلك الآراء والتحليلات تناولت تحالفات، جوهرها عسكري، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وغيره، إنما يتخطى دور الرجل الأول المسؤول عن العسكرية الأميركية علاقة أميركا بالعالم عسكريا. ليس فقط على طريقة مقولة كلاوسيفتس السالفة وإنما لأنه كان من بين نفر قليل من المحيطي بالرئيس في النصف الأول من فترة حكمه الأولى ممن يوصفون بأنهم “عقلاء”.
فبعد استقالة، أو إقالة، مدير موظفي البيت الأبيض جون كيلي لم يتبق من هؤلاء في إدارة ترامب سوى الجنرال ماتيس. ويبدو أن ذلك الفريق الصغير من “أبناء المؤسسة” ـ إن جاز التعبير ـ لم يعد قادرا على العمل ضمن فريق الإدارة التنفيذية الذي يتضح أن الرئيس ترامب شكله الآن على طريقته وبما يتفق مع توجهاته. وأصبح مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الشخصية الرئيسية الباقية في الإدارة والتي يمكن أن تشكل ملامح علاقة أميركا بالعالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ولمن لا يعرف جون بولتون عليه العودة إلى تصريحاته ومواقفه “المحافظون الجدد” مطلع القرن الحالي، وحين عينه الرئيس جورج بوش الابن لمدة سنة سفيرا في الأمم المتحدة وترك المنصب لأنه لم يكن مضمونا أن يقر الكونجرس ترشيحه للمنصب. وهو من الشخصيات المعروفة في مراكز البحث اليمينية ومن أنصار التدخل العسكري وتغيير النظام في دول العالم التي لا ترضى عنها واشنطن.
يمكن تفهم قلق البعض من رحيل جيمس ماتيس لأنه مثل “توازنا” إلى حد ما مقابل مجموعة من “منافقي الرئيس” الذين يسمعونه ما يحب ويرضى عنه من آراء. وكان للجنرال المستقيل أسلوبه في ثني الرئيس عن بعض الإجراءات التي اعتبرها كثيرون انفعالية وحتى “كارثية”. ورغم أن القوات الأميركية منخرطة في “حرب” من نوع ما في أفغانستان وسوريا وغيرها، إلا أن دور الجنرال ماتيس في العامين الأخيرين كان يتجاوز أنه مسؤول عن أداة استكمال الدبلوماسية لإنفاذ السياسة. ففي ظل غياب من يمكن أن يناقش الرئيس ترامب أو يحاول أن يقنعه بغير ما يرى أو يغرد بشأنه كان الجنرال ماتيس، ربما بوجود جون كيلي في البيت الأبيض، يفعل ذلك بطريقة غير مباشرة نجحت أحيانا في تفادي تصرفات أميركية تبدو رعناء أو على الأقل تأجيلها. من بين ذلك موقف واشنطن من اتفاقات وتحالفات دولية، ليست فقط عسكرية كالناتو، ولكن حتى تجارية واقتصادية وغيرها. واحتلت منطقة الشرق الأوسط مكانا مهما بين تلك الأمور التي كان للجنرال ماتيس تأثير فيها داخل الإدارة، وربما عكس ما يرى جون بولتون. لكن بولتون تمكن من الاستحواذ على أذن الرئيس بشكل جعل الأخير لا يتكلم حتى مع مدير البيت الأبيض كيلي.
لماتيس رأي مختلف تماما عن الدور الأميركي في كثير من قضايا العالم، من الصين وإيران إلى تركيا وفنزويلا. وكما أوضح بشكل غير مباشر في خطاب استقالته فقد آثر أن يترك منصبه ليتمكن الرئيس من استقدام شخص تتفق آراؤه معه ـ أي شخص يتولى مسؤولية العسكرية المتسقة مع الدبلوماسية التي يقودها الرئيس ووزير خارجيته ويشرف عليها مستشاره للأمن القومي. وتظل مقولة كلاوسفيتس فاعلة، بل إن رحيل جيمس ماتيس ما هو إلا تأكيد لصلاحيتها حتى الآن.
الأهم هو أن الرئيس دونالد ترامب، الذي شهدت إدارته في عاميها الأولين واحدة من أعلى نسب تغيير أعضائها، أمكنه الآن تكوين فريقه الذي يناسبه بما يضمن له الاستمرار في النصف الثاني من رئاسته الأولى والاستعداد للمنافسة على فترة رئاسة ثانية بعد نحو عامين. فبعد رحيل ريكس تيلرسون من الخارجية ورحيل جون كيلي من البيت الأبيض ورحيل جيمس ماتيس من الدفاع أصبحت العسكرية والدبلوماسية بيد ترامب وفريق يتسق مع هواه. وبغض النظر عن رأيك أو موقفك من سياسة ترامب، فطريقته حتى الآن تثبت ما توقعناه في هذه المساحة من قبل من أنه سيتمكن من تكييف الإدارة لتناسبه، وربما يساعده ذلك في الفوز بفترة رئاسة ثانية. فلنستعد إذًا لحكم ترامب لست سنوات أخرى، أو على الأقل عامين.