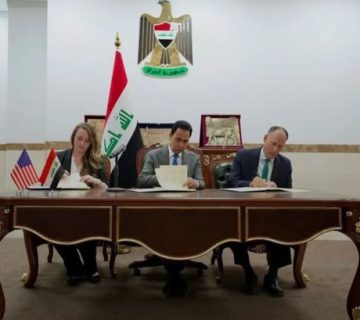خلال 11 شهراً، عملت آية (36 عاماً) من قرية بيت عنان، في مدينة حولون جنوب تل أبيب، وتنقلت بين مصنع للحلويات ومزرعة للعنب ومصنع لتعليب الخضار والفواكه. وقبل شهرين انتقلت إلى رام الله، حيث عثرت على عمل في أحد المراكز التجارية الكبرى.
وتروي آية لـ”النهار العربي” سبب انتقالها من عمل إلى آخر في شكل متكرر، قائلة إن تصريح العمل كان صالحاً فقط للقطاع الزراعي، وقد تسبّب لها ذلك ولغيرها من العاملات الأخريات بمشاكل مع السلطات الإسرائيلية، فاضطررن إلى ترك مصنع الحلوى والاتجاه للعمل في القطاع الزراعي.
.jpeg)
تتحدر آية من عائلة كبيرة تتكون من 13 أخاً وأختاً، 9 منهم عملوا في إسرائيل. ومع أنها حاصلة على إجازة في الإدارة الطبية، لم تحاول البحث عن عمل في اختصاصها. وعن السبب، تقول إنّها كانت تتقاضى في حولون راتباً شهرياً 3 أضعاف ما تحصل عليه في رام الله، وتضيف أنّ والديها تجاوزا الـ75 عاماً، وهما بحاجة إلى رعاية صحية وأدوية، وكلها مكلفة.
عندما سألتها هل تريدين العودة إلى العمل هناك مرّة اخرى؟ أجابتني: “أنا مضطرة، لكن إذا تمكنت من تأسيس مشروع خاص بي، فلن أكون مجبرة على العودة، وسأركّز طاقتي وجهدي في تطوير عملي والحفاظ عليه… يكفي أنني لن أشعر بالخوف أو بالتمييز بعدها”.
وهل تعرّضت لأي نوع من التحرّش اللفظي أو الجنسي خلال عملها، قالت: “لا، لكن في المنطقة التي كنا نعمل فيها، سمعنا عن حوادث عدة مع فتيات من قِبل ربّ العمل الإسرائيلي وبعض الإداريين”. وختمت أنّ هناك مناطق صناعية لا تريد أن تعمل فيها لمجرد أنّها معروفة بين أوساط العاملات بكثرة حوادث التحرّش اللفظي والجسدي.
مستودع العمال
بعد حرب حزيران (يونيو) 1967، شهد الاقتصاد الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، عملية تغيير بنيوية جعلته تابعاً لإسرائيل. وتحوَّل الاقتصاد من زراعي بالدرجة الأولى، إلى اقتصاد خدماتي يفتقر إلى الوظائف والطاقات الإنتاجية. وازداد تدفق العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، ما أدّى الى دمج سوق العمل الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلية، وحدّد طبيعة التنمية الفلسطينية، وتحوّل إلى مصدر رئيسي للدخل الفردي والمحلي الفلسطيني على حدّ سواء.
ومع توقيع بروتوكول باريس عام 1993، بحجة ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي عبر الاتحاد الجمركي ولمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، تعمقت تبعية الفلسطيني للإسرائيلي، وتحوّلت الضفة والقطاع والقدس إلى “مستودعات” للأيدي العاملة الفلسطينية. ورغم الظروف الصعبة والانتهاكات الصارخة، رضخ الآلاف لهذه الأوضاع المأسوية من أجل “لقمة العيش” وهرباً من البطالة، ليصبح العمال الفلسطينيون في إسرائيل تجسيداً حياً للقول المأثور “كالمستجير من الرمضاء بالنار”.
قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل 160 ألف عامل، لكن منذ اندلاع الحرب، تمّ إغلاق الضفة الغربية مع القليل من الاستثناءات للشركات الأساسية، لينخفض العدد إلى 20 ألف عامل فلسطيني فقط.
ويرجع تفضيل السلطات الإسرائيلية العمال الفلسطينيين على غيرهم من الجنسيات الأخرى من الآسيويين والأفارقة، إلى صرف العامل الفلسطيني أمواله التي يحصل عليها آخر الشهر ضمن الدائرة الاقتصادية المغلقة نفسها، كذلك لاتقان عدد كبير منهم للغة العبرية ما يجعلهم مفضّلين على غيرهم، إضافة إلى أنّ العامل الفلسطيني يعود للنوم في منزله، وهو ما يخفّف من العبء الأمني على إسرائيل.
انتهاكات بلا سقف
تتعرّض الأيدي العاملة الفلسطينية داخل “الخط الأخضر” والمستوطنات والمناطق الصناعية، إلى شتى أنواع القهر والتمييز وانتهاك الحقوق، المنصوص عليها في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ بل وتتعداها إلى ما شرّعته إسرائيل من قوانين واتفاقيات جماعية، وما التزمت به في الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية.
وتتلخّص الانتهاكات في حق الوصول الطبيعي والحر إلى العمل، حيث يمنع 11 معبرًا تشهد أبشع أشكال الأبارتايد وعشرات الحواجز الدائمة والمؤقتة، دون تمتع العامل الفلسطيني بحقه الطبيعي في الوصول الحرّ والسهل إلى عمله، ما يجبره على الخروج إلى عمله قبل ساعات للوصول إليه في الموعد المحدد.
انتهاك آخر يتمثل في الحق في التعامل بكرامة إنسانية على الحواجز والمعابر، حيث يمارس الجيش والشركات الأمنية الاسرائيلية كل أشكال الإذلال وامتهان الكرامة بحق العمال على الحواجز والمعابر، من خلال الطوابير الطويلة والازدحام الشديد قبل المعبر وداخله، وغالباً ما يفتقد الى أدنى الشروط الإنسانية، فلا حمامات ولا أماكن للراحة.
كما يتعرّض العمال الفلسطينيون لاستغلال سماسرة التصاريح والسائقين، ويتكبّدون خسائر كبيرة للوصول إلى أماكن العمل في ظلّ عدم وجود وسائل نقل عامة؛ كما يدفع العامل شهريًا آلاف الشواقل ثمناً لتصريح العمل، إضافة إلى سلسلة طويلة من انتهاكات شروط العمل، ويُضاف إليها ما تتعرّض له العاملات من تحرّش لفظي وجسدي ومحاولات ابتزاز ومساومات على الحقوق.
أزمة مالية واقتصادية
خلال اجتماع للجنة المالية والاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي، قال راؤول سارغو رئيس جمعية المقاولين الإسرائيليين: “هناك صعوبات شديدة يواجهها قطاع المقاولات والبناء، إذ بلغت الإنتاجية 30 بالمئة فقط”. وبحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فإنّ الخسائر الاقتصادية كبيرة جداً نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، وتصل إلى 3 مليارات شيقل (830 مليون دولار) شهرياً، وفقاً لما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب، فقدت إسرائيل قرابة ربع قوتها العاملة لأسباب مرتبطة بتجنيد 360 ألفاً من الاحتياط، وتعليق العمل في بلدات غلاف غزة، وتضرّر الاقتصاد الإسرائيلي، وتوقف نشاط بعض القطاعات وبخاصة السياحة.
ويبلغ إجمالي عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألفاً، وارتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف عامل، كانوا يُدخِلون سيولة تصل إلى 900 مليون شيقل شهريا (243 مليون دولار) إلى السوق الفلسطينية، عبر التوجّه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
ويُعتبر العمل في مجال البناء في الداخل الإسرائيلي من أكثر المجالات استقطاباً، حيث انّ 70% من العاملين داخل “الخط الأخضر” يعملون في مجالات البناء، في حين يعمل 22% منهم في مجالات الزراعة، أما من تبقّى منهم (8%) فيعملون في قطاع الصناعة والخدمات.
وتتجاوز أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل شهرياً 1.5 مليار شيقل (400 مليون دولار)، وتُعدّ من أهم الموارد المالية للاقتصاد، حيث بلغ متوسط الأجر للعامل الفلسطيني في إسرائيل قرابة 300 شيقل (81 دولاراً).
لكن العمال الفلسطينيين لا يحصلون على ضمان اجتماعي أو تعويضات بطالة للعمال من إسرائيل، كما هو الحال بالنسبة لأقرانهم من العمال الإسرائيليين. كذلك، لا يوجد أي نظام ضمان اجتماعي يشملهم من قِبل السلطة الفلسطينية.

تأثير انقطاع الدخل
يعيش بشير (47 عاماً) في بلدة دير عمار قرب رام الله، وهو ربّ لأسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء، اثنان في الجامعة و3 في المدارس.
يعمل حالياً بشير في ورشة للبناء، بعد أربعة أشهر من البطالة. سألته كيف تمكّن من تدبير أموره المالية وسط هذه الظروف؟ أجاب: “زوجتي قامت ببيع بعض حليها الذهبية، لتسديد فواتير شهرية للكهرباء والماء والهاتف والإنترنت، والالتزامات الأخرى من أقساط الجامعات والمدارس. هناك أصدقاء قاموا ببيع بعض أثاثهم المنزلي، وآخرون باعوا أرض أو سيارتهم. الغلاء في كل مكان، ولا دخل مالياً منذ أشهر، ولم يقدّم لنا أحد المعونة أو حتى تسهيلات”.
وأضاف بشير أنّ “70 إلى 80 % من سكان دير عمار هم عمّال في إسرائيل، أغلبهم يعانون من البطالة اليوم. في عائلتي نحن 6 مع أشقائي وأبنائهم نعمل في إسرائيل، ونعاني ظروفاً اقتصادية صعبة، لا سيولة، والديون تراكمت. بات الناس يشترون فقط الأساسيات مثل الحليب والأرز والسكر والطحين، ومن كان يأخذ ربطتي خبز، صار يشتري نصف ربطة. الوضع كارثي”. وختم قائلاً: ” فكّرنا بتأسيس مشروع الآن، ولكننا بحاجة إلى ضمانات وسيولة”.
ولا تقتصر تبعات الحرب على من كانوا يعملون في إسرائيل، بل طاولت الفلسطينيين في كافة المدن والقرى والبلدات بسبب تقليص الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأكثر من 120 ألف فلسطيني، لأنّ إسرائيل تحتجز أكثر من 800 مليون شيقل من أموال مقاصة الضرائب التي تحصّلها على البضائع الفلسطينية.
وبحسب تقديرات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وصلت الخسائر إلى 24 مليون دولار، بسبب تراجع في العمالة في إسرائيل والسياحة الداخلية في الضفة.
وفي قطاع التعليم العالي على سبيل المثال، لن يتمكن أكثر من 17 ألف طالب من التسجيل للفصل الدراسي الثاني من أصل 20 ألفاً في جامعة النجاح الوطنية، وذلك بسبب الأزمة المالية، وربما تكون هذه سابقة لم تشهد الجامعات مثيلاً لها من قبل.
كما انعكست الأزمة على الحركة في الأسواق حيث تقلّصت المبيعات بنسبة 70%، وبات التجار لا يقبلون بتزويد البضائع إلاّ بعد الدفع نقداً، فالسيولة شبه معدومة، والأسواق شبه خالية من المتسوقين، في حين يعوق أكثر من 130 حاجزاً إسرائيلياً في جميع أنحاء الضفة الغربية، حركة التنقل بشكل عام، ونقل الإنتاج الزراعي والعمل في الحقول بشكل خاص.