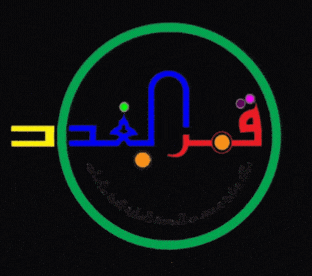يرى علماء الاقتصاد أن العولمة اصطلاح اقتصادي، لأن هدفها الاستراتيجي خلق سوق عالمي تنداح فيه كل الموانع والحواجز، ما يساعد على تحقيق فكرة نهاية التاريخ التي روج لها فوكوياما، الأمريكي الجنسية، الياباني الأصل، كأن العولمة الاقتصادية نذير لخلع العباءة الوطنية وإلباس الجميع زياً موحداً، كما أنها تؤدي إلى محو الجغرافيا وتقليص ظل الدولة، بعبورها للحدود من خلال الشركات متعددة الجنسيات.
ولعل أكثر المستجدات الفكرية التي ترفض ربط العولمة بعجلة الاقتصاد تلك القنبلة التي فجرها أستاذ علم الاقتصاد الاجتماعي آلان كايي، وأستاذ الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، فعندهما أن الإنسان كائن اجتماعي وليس كائناً اقتصادياً بالدرجة الأولى، وأنه من الأفضل من الآن إيجاد بديل للنظام العالمي الجديد، والبحث عن مؤشرات جديدة يقاس بها تقدم الدول وتخلفها، بعيداً عن أطروحات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لأنهما من أسباب إفقار دول العالم الثالث غير النفطية، ومثال على ذلك دول الاتحاد الأوروبي التي تغرق واحدة تلو الأخرى تدريجياً في بحر الديون، وهي لم تستفق بعد من إغماءة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي حسب آخر التقارير المنشورة بحاجة إلى 500 مليار دولار للتخلص من أعباء تلك الديون، وأن البنك الدولي ليس بمقدوره سوى توفير 200 مليار، إذاً إلى أين تقودنا عولمة الاقتصاد؟!.
ويرى كايي في هذا السياق أنه من المناسب والأفضل للدول النامية والناشئة عدم التعاطي مع النموذج الغربي الرأسمالي، الذي لا تزال الدول النامية تستلهم منه تجاربها بتقليد أعمى ظناً من بعض قادتها أنه يوصل إلى طريق الخلاص والرفاهية الاجتماعية، بينما كل الدلائل تؤكد أن هذا النموذج يعيش اليوم المرحلة الأخيرة في حياته، على حد تعبيره، وهو محكوم بالزوال المؤكد، ومن ثم لم يعد بالإمكان الدفاع عنه!
بينما يرى غاري ريتشاردسون، أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا، أن السياسات الأخيرة التي طرحها ترامب تحمل أوجه تشابه واضحة مع تلك التي اتبعتها أمريكا في القرن التاسع عشر، حينما كانت الرسوم الجمركية، وليس ضرائب الدخل، تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة، غير أن الخطر الماثل الآن أمام الاقتصاد العالمي هو أن ترامب يعمل على إعادتنا إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين أشعلت تعريفات «سموت-هولي» سيئة السمعة في الولايات المتحدة سلسلة من ردود الفعل الانتقامية الدولية، التي غالباً ما يوجه إليها اللوم في تعميق أزمة الكساد الكبير.
وقد تكون المخاطر الحالية أشد من نواحٍ عدة، فالتجارة ليست أكثر أهمية فحسب مما كانت عليه في الثلاثينيات، بل إن الاقتصاد العالمي اليوم مبني على سلاسل توريد متشابكة تشهد تدفق البضائع والمكونات عبر حدود متعددة، ويدعم ذلك كله إطار من التعاون الدولي.
وفي معركته ضد العولمة يدفع ترامب باباً كان مفتوحاً جزئياً بالفعل لاشتعال الأوضاع، فقد أدى فقدان الوظائف الصناعية لصالح المكسيك والصين والدول الأقل تطوراً، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية، إلى تقويض ثقة الناس في المنظومة الاقتصادية التقليدية لفترة ما بعد الحرب، وغير صعود الصين الآراء السياسية كذلك، فإذا كانت بكين منافساً جيوسياسياً محتملاً لواشنطن فربما كان منطقياً من الناحية الاستراتيجية أن تسعى الولايات المتحدة لكبح النمو الاقتصادي الصيني المتسارع، وهي سياسة تبناها بحماس الرئيس السابق، جو بايدن، خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض.
وقد جاء ترامب ليمزج هذه المشاعر السلبية تجاه التجارة مع منهجه النفسي الخاص، مع أن عصر العولمة تميز بمفهوم «الكل رابح»، حيث يمكن لكل الأطراف الاستفادة من التسويات، أما ترامب المتأثر بخبرته كمطور عقاري يتنافس على قطع الأراضي، فيؤمن بأن المفاوضات لا يمكن أن تفرز سوى فائز واحد، ويفخر بعدم تراجعه أبداً أو إظهاره لأي علامة ضعف.
وإذا كانت هناك نظرية موحدة وراء التعريفات الجمركية لترامب فيمكن العثور على بعض ملامحها في ورقة بحثية واسعة الانتشار من نوفمبر الماضي لستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب حالياً، فهي توضح كيفية استخدام التعريفات لتعزيز القطاع الصناعي الأمريكي.
وقد طرح ترامب مؤخراً رؤية مغايرة تماماً لتلك الحقبة التاريخية، مقدماً نظرية غير مسبوقة وغير متداولة بين المؤرخين الاقتصاديين، مفادها أن الكساد الكبير ما كان ليحدث أبداً لو أن الولايات المتحدة احتفظت بنظام اقتصادي قائم على التعريفات الجمركية بدلاً من تحولها قبل عقود من ذلك إلى الاعتماد على ضريبة الدخل كمصدر رئيس للإيرادات.
مما لا شك فيه أن تحديات العالم القائم تحتم بروز اقتصاد جديد؛ اقتصاد اجتماعي معرفي يبنى على أنقاض مخلفات العولمة الاقتصادية؛ اقتصاد يتأسس على الاعتراف بخصوصية الآخر، وتبني مفاهيم الشراكة والتعاون وتبادل المنافع بين الشعوب، والإبقاء على ثقافاتها وإرثها الحضاري، بعيداً عن الهيمنة والتبعية والإقصاء؛ ذلك أن مواجهة العالم القائم تتطلب مواجهة تحدياته.