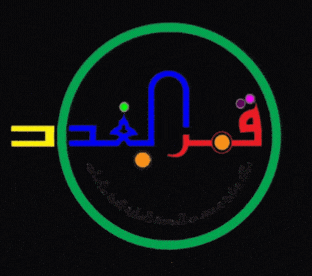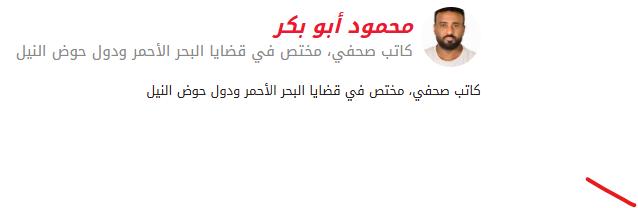التنظيمات الطابع الدولي استغلت حال الفوضى والنزاعات فيما بين الفصائل المحلية المسلحة وقدمت إغراءات ساعدت على التمدد
محمود أبو بكر كاتب صحفي، مختص في قضايا البحر الأحمر ودول حوض النيل
ظلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر جذباً لجماعات الإسلام الحركي المتطرف خلال تسعينيات القرن الماضي (اندبندنت عربية)
ملخص
على رغم الاختلافات النسبية بين واقع دولة وأخرى في منطقة الساحل الأفريقي، فغايات الجماعات الإسلامية المتطرفة تظل واحدة، إذ وجدت أرضية خصبة للبقاء وتدويل الأزمات.
شهدت منطقة الساحل الأفريقي خلال العقدين الماضيين تطورات سياسية وعسكرية لفتت اهتمام الباحثين الدوليين، خصوصاً لجهة تمدد الحركات الإسلامية المتطرفة فيها بصورة غير مسبوقة.
ظلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر جذباً لجماعات الإسلام الحركي المتطرف خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، وانحسار ذلك التمدد كان نتيجة عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، بخاصة أثر الاستراتيجيات المشترك بين دول تلك المناطق، مما دفع قادة الحركات المسلحة العابرة للحدود، للتفكير في مناطق أكثر هشاشة في بنيتها السياسية والأمنية.
إلى جانب انتشار الفقر والحاجة كانت منطقة الساحل الأفريقي الفضاء الأكثر مواءمة لإعادة تموضع الحركات الجهادية، وهو ما اتضح لاحقاً، لا سيما في ظل تضعضع النظم السياسة الحاكمة هناك، بخاصة لجهة انتشار الفساد المالي والإداري، فضلاً عن ارتباط مصالح السلط الحاكمة بالقوى الخارجية، مما أفقدها شرعيتها القانونية والسياسية وجعلها معزولة عن شعوبها، وهو ما ولد تيارات متمردة على النظم الحاكمة تحمل شعارات تتعلق بالمظالم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وشكلت مجموعات مسلحة تستهدف مصالح النظم الحاكمة.
والواقع أن التنظيمات المتطرفة ذات الطابع الدولي استغلت حال الفوضى الناتجة من صراع حركات التمرد ضد الأنظمة الحاكمة من جهة، والنزاعات فيما بين مختلف التنظيمات المحلية المسلحة، وقدمت إغراءات لقادتها، من أجل تقديم الدعم والتدريب ونقل الخبرات القتالية مقابل إيوائها والتحالف معها، وبهذا التغلغل والتوظيف أصبحت الجماعات المتطرفة حاضرة، في ساحات المواجهة فضلاً عن وجودها في قلب المفاوضات الوطنية، لتملي خياراتها كأنها مكون محلي.
ملثمون مدججون بالأسلحة من المنتمين للطوارق في مالي (أ ف ب).jpg
ملثمون مدججون بالأسلحة من المنتمين للطوارق في مالي (أ ف ب)
وعلى رغم الاختلافات النسبية بين واقع دولة وأخرى في منطقة الساحل الأفريقي، فغايات الجماعات الإسلامية المتطرفة تظل واحدة، إذ وجدت أرضية خصبة للبقاء وتدويل الأزمات.
هشاشة الأنظمة
من جهته يرى الباحث المالي علي مامادو أن معظم دول الساحل الأفريقي تشهد ضعفاً في التعليم ونقصاً في الخدمات وندرة في فرص العمل، كما تتسم الأنظمة الحاكمة منذ فجر الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، عجزاً واضحاً في فرض سلطتها خارج العواصم باستثناءات قليلة، إذ ترتكز معظم قدرات السلطة والثروة في العواصم والمدن الرئيسة، في حين ترزح الأقاليم الأخرى تحت خط الفقر والحاجة والعوز، بخاصة في ظل انتشار الفساد المالي والإداري، واعتماد النظم الحاكمة على الطابع الزبائني للحكم، مما ساعد على تفشي جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب السلاح والمخدرات.
اقرأ المزيد
الجماعات المتطرفة تستخدم الغذاء كسلاح ضد المدنيين في الساحل الأفريقي
إيران تفتح نافذة أمنية على الساحل الأفريقي
مغادرة “فاغنر” مالي تثير قلقا على حدود الجزائر الجنوبية
ويوضح ممادو أن هذا الواقع الهش للأنظمة الأفريقية في منطقة الساحل، قد استغل من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة، التي عقدت التحالفات مع الجماعات المحلية، مشيراً إلى أن هذا تحديداً ما جرى شمال مالي، عندما احتدم الصراع بين تنظيم القاعدة وتنظيم “داعش” لاكتساب أكبر قدر من مصادر الدعم، إذ مثل هشاشة النظام عاملاً حاسماً في انتشار الجماعات المتطرفة العابرة للأوطان.
غياب الشرعية السياسية
يضيف مامادو أنه إلى جانب هشاشة النظم السياسية ثمة عامل مهم يتعلق بغياب الشرعية السياسية، ومشروعية النظم الحاكمة التي تعتمد على الولاءات القبلية عوض التمثيل السياسي المتكافئ، فعلى رغم سماح معظم دول الساحل بقيام أحزاب سياسية عدة، فإن وجودها يظل صورياً، قياساً بسيطرة الأحزاب الحاكمة التي تعتمد على مقدرات الدولة، وتمارس السياسة بمنطق التفويض المطلق، إذ تمثل الاستحقاقات الانتخابية مجرد “فعل تحليل” للاستمرار في السلطة إلى الأبد، إذ إن التزوير يعد عاملاً حاسماً في تجديد العهدات الرئاسية والبرلمانية للقوى الموالية للسلطة القائمة، فيما تلعب الأحزاب المعارضة كـ”أرانب” في السباق السياسي، ضمن لعبة متفق عليها بين الطرفين، مما جعل العمل المسلح هو السبيل الوحيد لممارسة المعارضة السياسية.
(أ ف ب).jpg
الأحداث العاصفة في المناطق المتاخمة لدول الساحل أثرت بصورة كبيرة في صياغة تفكير المجتمعات المسلمة المحافظة والمتدينة تقليدياً (أ ف ب)
ويوضح الباحث المالي أن الأنظمة في مالي والنيجر وبوركينافاسو وغيرها ظلت خلال العقود الماضية تراهن على قدرتها في السيطرة على السلطة عبر ثلاث خصائص رئيسة، الأولى تتعلق بتسخير موارد الدولة لمصلحة السلطة الحاكمة، والثانية عبر التزوير الممارس بصورة واسعة في كل استحقاق انتخابي، والثالثة عبر تخوين أي تيار معارض للوضع القائم، مما أدى إلى انحسار الممارسة السياسية السلمية، ودفع بكل معارض إلى الانضمام للجماعات المتمردة (المسلحة)، لأنها الطريقة الوحيدة الممكنة للانتقال إلى نظام بديل.
البيئة التقليدية
في سياق متصل يرى الباحث في شؤون منطقة الساحل الأفريقي محمد إسماعيل أن البيئة التقليدية المتدينة لشعوب هذه المنطقة وغير المؤطرة سياسياً قد تشكل أرضية لتغلغل جماعات الإسلام السياسي المسلح، بخاصة أن النظم التي حكمت هذه الدول منذ الاستقلال لم تعتمد على الدين كعامل رئيس في ممارسة السياسية، إذ إن النظام الوطني الذي حكم بعد الاستقلال، قد ورث البيروقراطية الإدارية والسياسية من النظم الاستعمارية السابقة، وتأثر بها على المستوى النظري والاداري. ويضيف، “كما أبقى على التبعية الاقتصادية والمالية للمستعمر السابق، وأسهم بصورة واضحة في إهدار موارد ومقدرات الدولة لمصلحة الأجنبي، ومن ثم فإن الخروج من تلك الدائرة وفق بعض الأعيان وزعماء القبائل، بخاصة في المناطق الصحراوية النائية بدت تتمثل في العودة للدين، للتخلص من التبعية الأجنبية من جهة وتحكيم الدين من جهة أخرى.
مقاتلون من حركة ماسينا (مواقع التواصل).jpg
مقاتلون من حركة ماسينا (مواقع التواصل)
ويؤكد إسماعيل أن الأحداث العاصفة في المناطق المتاخمة لدول الساحل، سواء في شمال أفريقيا أو تلك البعيدة في الدول الإسلامية، بخاصة في ظل انتشار حركات الإسلام السياسي، أثرت بصورة كبيرة في صياغة تفكير المجتمعات المسلمة المحافظة والمتدينة تقليدياً في دول الساحل الأفريقي، مما خلق بيئة مناسبة لإمكان تموضع حركات الإسلام السياسي في هذه البيئة الصحراوية المحافظة.
سهولة التجنيد
بدوره يرى مامادو أن الجماعات الإسلامية المتطرفة أدركت مبكراً، الثغرات المتعلقة بسهولة عملية تجنيد الشباب الأفريقي العاطل من العمل، بخاصة في المناطق الصحراوية التي تنعدم فيها الخدمات الأساسية، ولذلك عملت في تقديم الإغراءات المادية، إلى جانب عامل آخر ذي أهمية بالغة، يتعلق بالأبعاد القومية والقبلية، إذ إن الولاءات للقيادات القبلية يمثل عاملاً حاسماً في استقطاب وتجنيد أكبر قدر من الشباب، ولعل أبرز مثال على ذلك – كما يقول مامادو – يتمثل في استقطاب جماعة أنصار الدين لعدد من القيادات المحلية النافذة داخلها وفق خطة تهدف إلى توظيف الصراعات المحلية، وتغطية التحالفات الجديدة بمظلتها، مما ضمن لها تجنيد أوسع.
ويضيف، “ثمة مثال آخر يتعلق بتحول الحركة الشعبية لتحرير أزواد” في شمال مالي من حركة قومية علمانية ذات مطالب محلية إلى جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لـ”القاعدة” بقيادة إياد أغ غالي، إذ إن تجنيد الأخير وتأثيره الكبير على مجموعة الأزواد، مكن من تمرير هذا التحول الكبير في مسار نضال هذه المجموعة العرقية في شمال مالي. كما يمكن الإشارة إلى التحول الذي شهدته “جبهة تحرير ماسينا” إلى كتيبة ميدانية تنتمي إلى جماعة “أنصار الإسلام والمسلمين” تحت زعامة أمادو كوفا.
وإذ حاول زعيم الأزواد إياد أغ غالي تسويغ هذا التحول وتسويق نفسه مجاهداً، محتفظاً بالبعد القومي لحركة ماسينا، وعلى رغم اختلاف طريقة القائدين بقيت النتيجة واحدة، وهي تغلغل الحركات المتطرفة في كيانات حركات التمرد القومي، وإعادة تشكيلها وتنظيمها لتستمد طاقتها من الخطاب الديني مثل سائر الحركات الإسلامية المتطرفة.