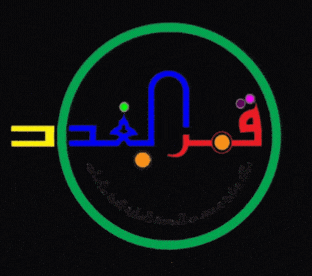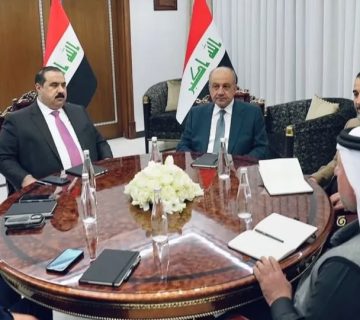في نهاية الأمر ألم يكن محقاً ذلك المؤرخ الذي قال يوماً إن لكل واحد منا فارس طواحينه؟
إبراهيم العريس باحث وكاتب
دون كيشوت وسانشو بانشا في الفن الحديث (موسوعة الفن المعاصر)
ملخص
يعتبر الكاتب الأرجنتيني خوان خوسيه صاير، الذي تعود جذوره إلى سوريا، نفسه “شريكاً” لصاحب “دون كيشوت” في ذلك الميراث معتبراً أنه ميراث كوني كما يجدر بكل أدب كبير أن يكون
إذا كان بديهياً أن من خصائص الأدب الكبير أنه يقرأ في كل مرة ومن قبل كل جيل على ضوء دينامية التاريخ واهتمامات وهموم المجتمع الذي يقرأ فيه، فإن من خصائص الآداب الأكثر استثنائية أن قارئها إنما يقرؤها هو نفسه ويعيد قراءتها في كل مرة وكل حقبة من حياته بصورة جديدة متطورة تتعلق بحياته الخاصة، ومن هنا، بالتأكيد، كان اشتغال الكاتب والمفكر الإيطالي الراحل أومبرتو إيكو، أكثر ما اشتغل على ضوء عمل القارئ نفسه كمكمل للنص الذي يقرؤه إلى درجة أنه عنون واحداً من كتبه الرئيسة “القارئ في الحكاية”. والحقيقة أن المرء يستذكر هذا كله في كل مرة يقع فيها بين يديه واحد من تلك الأعمال الشامخة تذكره بهذا الذي بات ينتمي إلى البديهيات في عالم القراءة. ومن تلك الأعمال الشامخة، وربما في مقدمها، رواية الإسباني ثربانتس “دون كيشوت ديلا مانشا” الرواية المؤسسة للفن الروائي الإنساني بالمعنى الحديث للكلمة، والتي من المؤكد أن الإنسانية جمعاء ستحتفل بعد نحو 20 عاماً من الآن بالذكرى نصف الألفية لولادة مؤلفها (1547 – 1616) الذي زامن شكسبير ويتقاسم معه كثيراً من القيم والمكانة والهم الإنساني، في وقت واحد. ومن المؤكد أن الإطلالة المقبلة على الرواية من خلال ذكرى مولد مؤلفها، لن تقل أهمية عن تلك الإطلالة عليها في عام 2006 في المئوية الرابعة لولادتها، وهي إطلالة أنتجت عشرات الدراسات والتفسيرات الجديدة كما نعرف. وكذلك أعادت إحياء تلك الفكرة التي من المؤكد أنها لن تموت أبداً، فكرة أن لكل واحد منا دون كيشوته الخاص به.
خوان خوسيه صاير الأديب الأرجنتيني السوري الأصل (موسوعة الأدب الإسباني)
ميراث كوني
ويومها كان من بين الذين تحدثوا عن تلك الفكرة، الكاتب الأرجنتيني خوان خوسيه صاير (1937 – 2005)، حتى من دون أن يعلن نفسه كما يفعل كل كاتب باللغة الإسبانية، واحداً من ورثة ثربانتس بفضل اللغة المشتركة بينهما. والحال أن صاير الذي تعود جذوره العائلية إلى العاصمة السورية دمشق التي غادرتها أسرته إلى المهجر الأميركي اللاتيني باكراً في القرن الـ20، لم يسر حقاً على خطى ثربانتس، مستنداً دائماً إلى جذور ثقافته العربية، لكنه اعتبر نفسه “شريكاً” لصاحب “دون كيشوت” في ذلك الميراث معتبراً أنه ميراث كوني كما يجدر بكل أدب كبير أن يكون. ومن هنا، حين سئل صاير في نهايات حياته عن نظرته إلى تلك الرواية الخالدة وقد تحولت مع مرور الزمن، إلى أسطورة، حدد بأن من الضروري “توضيح الفارق بين الأسطورة والنص الروائي في حد ذاته”، وهو نص يشتغل أساساً في رأيه على التناقض بين دون كيشوت وسانشو بانشا “بين مثالية الأول وواقعية الثاني، وهو تناقض ذو محمول كوني يمكننا أن نرصد كيف أنه انتشر في العالم أجمع ليخلق تلك الأسطورية”. أما بالنسبة إلى النص الروائي نفسه فإنه أكثر تعقيداً بكثير بالنظر إلى امتلائه بالتناقضات وضروب الحدس التي لا تحسب لها تلك الأسطورية حساباً. ويقيناً، بالنسبة إلى صاير أن ذلك النص الأدبي قد ألهم بصورة عميقة معظم ضروب السرد، ولكن كذلك عديد من مجالات التأمل حول الأدب وتاريخه. وهذا رغم أن عديداً من سمات ذلك التأمل لم يكن جديداً بالنسبة إلى ذلك الزمن المبكر الذي أضحت فيه الرواية ميداناً للتأمل. ومن ذلك على سبيل المثال ابتكار الكاتب لمبدأ خلق شخصية قرينة للبطل من خلال ثنائي دون كيشوت/ سانشو بانشا. فهو أمر نجده مثلاً في “ساتيريكون”.
ميغويل تثربانتس: إختراع الحداثة الروائية (غيتي)
بين الروايات والملاحم
ويتابع صاير هذا التحليل هنا ليطبقه كذلك على مبدأ القراءة التي تحدث تغييراً في شخصية ما “وهو مبدأ يطالعنا في “الكوميديا الإلهية” لدى دانتي. وكذلك حال الشخصية التي تنوي أن تحكي لنا ما عاشته من مغامرات، وهي شخصية تطالعنا طبعاً في “الأوديسا”، ناهيك بأن أسلوب التهكم على روايات الفروسية وأبطالها كان سائداً في روايات ذلك الزمن”. غير أن هذا كله لا ينفي ضخامة التأثير الذي مارسته رواية “دون كيشوت” على الأدب الغربي بصورة عامة ولا سيما في العصور الحديثة وهو في رأي صاير تأثير مزدوج. فهناك أول الأمر ما يعتبره الكاتب الدمشقي الأرجنتيني المعاصر، “تأثيراً سيئاً يقوم على نظر الكتاب إلى ذهنية كيشوت باعتبارها ذهنية فروسية بالمعنى الحرفي للكلمة، وذلك حين قرأوا الرواية كما فعل هنري فيلدنغ، باعتبارها رواية مغامرات. ولقد كان لافتاً كيف أن الكاتب الإنجليزي الآخر ستيرن وفي زمن يقترب من زمن فيلدنغ، نظر إلى الرواية نظرة مغايرة تماماً حين أخذ بعين الحسبان السمة التهكمية التي تسيطر على نص ثربانتس. والمهم هنا هو أننا نجد في دون كيشوت منطلقاً لكل الأدب الغربي الحديث والمعاصر، ولا سيما بالنسبة إلى الحركة المتقدمة دائماً إلى الأمام في دينامية الرواية، حتى وإن كان حراكها عسيراً. فهنا وعلى العكس من أبطال الملاحم، حيث ينتقلون من مغامرة إلى أخرى ومن غزو إلى ما يليه، نجد كيشوت ينتقل من خيبة إلى أخرى. ما يجعل منه رائداً أساساً في سيرورة تتعلق بالإخفاق المتواصل، وهي السيرورة التي يمكننا أن نرصدها في الأدب الحديث بمجمله. ففي الملحمة ثمة دائماً هدف من الممكن الوصول إليه على رغم ما يعترض ذلك من صعوبات وأخطار، وحتى لئن مات البطل دون الوصول إلى غايته، ثمة دائماً من يكمل مسيرته. أما في “دون كيشوت” فالبطل يعود دائماً خالي الوفاض حتى ولو تمكن من أن يجعل من تلك النهاية مبدأً أخلاقياً وموعظة حسنة”. ويرى صاير أن في مقدوره أن يستنتج من هذا أن ثربانتس قد تفرد في زمنه ومن خلال شخصية بطله الكيشوتي في إدماج رؤية جديدة تضخ الأدب الغربي “حيث للمرة الأولى في تاريخ هذا الأدب، بات ما هو واقعي يعتبر إشكالية من خلال التلقي الذي يمكن للرواية أن تفرضه على قارئها”.
وفي ختام تعليقه يحدد صاير عدداً من الكتاب، الفرنسيين بخاصة، الذين يرى أنهم خلال الأزمنة الأقرب إلينا، يمكن اعتبارهم ورثة لثربانتس في عالمهم الروائي، فيذكر في المقام الأول فلوبير “الذي يمكن القول أن تأثره بالإسباني كان من الوضوح إلى درجة أن روايته “بوفار وبيكوشيه” قد يصح اعتبارها جزءاً ثالثا من رواية “دون كيشوت”… وهذا ما يتيح لصاير أن يقول بعدما يحصر حديثه في هذا السياق بالجوانب الفلسفية والأخلاقية، أي الاجتماعية، بأنه يرى أن الفرنسيين “يبدون لي بصورة إجمالية أقل حساسية من الآخرين بالنسبة إلى مسألة التأثر بـ”دون كيشوت”. ولعل في مقدورنا في هذا السياق هنا أن نتحدث عن كافكا الذي لا شك أننا نجد دون كيشوتا في كل نص من نصوصه، كما الحال لدى الأميركي ويليام فوكنر الذي كان دائماً ما يقول إنه اعتاد أن يقرأ رواية ثربانتس مرة في كل عام… والألماني توماس مان الذي كثيراً ما ذكر أنه كثيراً ما كان يحدث له أن يحلم وهو نائم بلقاء ما مع دون كيشوت، ولكن غالباً تحت ملامح زرادشت كما صورها فريدريك نيتشه في كتابه الشهير، أو حتى بورخيس الذي لم يفته أبداً أن يقول إنه يعتبر شخصية دون كيشوت واحدة من الشخصيات المفضلة بالنسبة إليه…”. وبقي أن نذكر أخيراً هنا أن خوان خوسيه صاير يعتبر في الأدب الأرجنتيني واحداً من كبار المجددين في تياره الواقعي، وذلك منذ عام 1969 حين أصدر روايته الأولى “ندوب” التي سيتبعها خلال ما يقارب نصف قرن سبق رحيله بنصف دزينة من روايات أضحت علامات في الأدب الأرجنتيني، من أشهرها “شجرة الليمون الملكية” و”لا أحد، لا شيء على الإطلاق”، وبخاصة رواية “الفرصة” التي يراها مؤرخو أدب أميركا اللاتينية “غنية بمكوناتها الأدبية ولكن كذلك بعديد من العناصر الأسطورية التي جددت في أدب صاير، ولا سيما من خلال أحداث تدور في مناطق البامبا شديدة الخصوصية في الجغرافيا الأرجنتينية، متناولة صعوبات التعايش بين البشر”.
“دون كيشوت” الرواية التي تعود دائما بتفسير جديد

التعليقات معطلة.