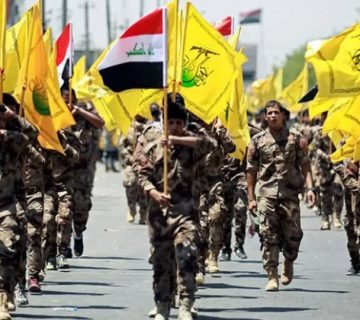حسن إسميك
في معظم الحوارات التي تدور بين الناس في منطقتنا، والتي يكون الهدف منها تحليل واقعنا المنكوب، وأسباب تراجعنا الحضاري، والمشكلات التي تعصف بالعديد من دولنا، لا بدّ أن يخرج شخصٌ ويحاول أن “يُخالف ليُعرف” أو ليظهر وكأنه “يفكر من خارج الصندوق”، فيقول دعكم من السياسة والاقتصاد وغيرها، إنَّ “أزمتنا أزمة أخلاق”. سيصيب هذا الشخص بكلامه، لكنها رمية من غير رامٍ، فأغلب المتحدثين عن أزمة الأخلاق العربية يكتفون بالكلام فقط، ويقولون ما لا يفعلون، وهذا بحد ذاته واحد من أهم مظاهر أزمة الأخلاق في العقل الجمعي العربي، وفي المجتمعات العربية بعامة.
أعلم تماماً أن الكتابة عن الأخلاق أمر شائك وعويص، ويشبه السير في حقل من الألغام، لكن الخوض فيه أمر لا بدَّ منه إذا أردنا لبلادنا أن تستعيد أَلَقَها ومكانتها الحضارية. ومن المهم الإشارة إلى أنني أتحدث هنا عن الأخلاق بمفهومها الواسع، وليس فقط ما يفهمه البعض حين يُقصرون الأخلاق على مجموعة سلوكيات تخص جانباً معيناً في الحياة دون غيره. فالأخلاق كلٌّ متكامل بالنسبة لي، وليست مسألة نسبية يُغني وجود بعضها عن وجود الباقي، من ناحية أنها مجموعة القيم والمعايير التي تحكم سلوك الإنسان وتفاعله مع الآخرين والمجتمع. وهي لا ترتبط بالعقائد الدينية وحدها، وبما تأمر به أو تنهى عنه، بل تتعلق كذلك بسلوك الفرد تجاه نفسه (الصحة، والنظافة، والصدق مع النفس، والطموح..)، وتجاه زملائه في العمل مثلاً (كالأمانة، والمسؤولية، والاحترافية..)، وبطبيعة الحال تجاه الآخرين (كالإحسان، والعدل، والإنصاف، والتعاون، والاحترام المتبادل..)، فالأخلاق هي بشكل أو بآخر ما يميز الإنسان عن المخلوقات الأخرى، ويجعله كائناً اجتماعياً، وكل اختزال لها هو جزء من الأزمة.
تبدأ الأخلاق -بشكل عام وكما هو معروف في منظومتنا الفكرية العربية/الإسلامية- من ضمير صاحٍ وفطرة سليمة، وتتمظهر بكلمة طيبة عدّها النبي محمد عليه السلام “صدقة”، وتنسحب نحو كظم الغيظ والعفو عن الناس وبر الوالدين وصلة الرحم والعطف والرأفة مع القريب والغريب، وفعل الخير والصدق والأمانة والعمل الدؤوب واحترام معتقدات الآخرين وحمايتها والسعي في الحياة الدنيا كأنك تعيش أبداً، ونبذ التواكل وكسب العلم من كل منهل في الأرض. فالأخلاق بالدرجة الأولى تمييز بين الخير والشر، مع الجنوح نحو الخير وإتيانه في كل حين؛ هي الودّ والمحبة والتفّهم وإعطاء كل ذي حق حقه، والعدل مهما كانت الظروف..
نظرة سريعة إلى أحوال العرب ستُظهر بوضوح أن هذه المنظومة شبه مفقودة، تغيب عن تعاملاتنا الفردية والجماعية، ولا تحضر إلا في الخُطب والمواعظ، فأين ذهبت الأخلاق التي تبُقي الأمم وتُعلي شأنها؟ وكيف نطمح كمجتمعات عربية للخلاص من كل ما نقاسيه دون أن ننظر إلى دواخلنا وأفعالنا نظرة موضوعية بعيدة عن الصلف الأحمق وتحميل الآخرين بشكل دائم مسؤولية ما وصلنا إليه؟ كيف ومتى سقطت منظومة قيم كانت تحكم صيرورة المجتمع العربي وحلّت مكانها منظومة أخرى مشوّهة متناقضة صارت تهدد مجتمعاتنا ووجودها؟ هل كان الضياع محتوماً ومُقدراً وليست لنا يدٌ فيه كأفراد، أم أن الفساد الأخلاقي الفردي هو العامل المؤسس لذلك التشوّه الغريب؟
العرب اليوم -في معظمهم كيلا نظلم الجميع- يريدون نتيجةً بلا عمل أو جهد، نجاحاً دون مثابرة، يرغبون بتحقيق “الانتصارات” وهم مرتاحون خلف شاشاتهم، تحولت قيمهم إلى مجموعة من الكلمات الحادة يتراشقونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تطبيق فعلي لها في حياتهم غير الافتراضية، متقاعسون عن كل تضحية يتطلبها تحسين أحوالهم الشخصية أو أحوال بلدانهم، يطمعون بأجور دون أداء عمل حقيقي، وبحلولٍ دون تفكير وتخطيط، كل ذلك يقابله تضخّم في ذواتهم يأتي معظمه من فراغ، فيتصورون بأنهم أفضل الناس، لكن الظروف السيئة تحكمهم بالكامل، دون إدراك أو وعي أو إقرار بالجزء الكبير الذي يتحملونه أنفسهم عن تلك الظروف.
هذا التضخم الفارغ أوصلنا إلى حالة متفاقمة من استجرار “الماضي المجيد” في كل مناسبة، ومحاولة إثبات تفوقنا بالاستناد إلى ما صنعه أجدادنا وما أسهموا به سابقاً في صنع حضارة العالم، وكأن تلك المساهمة أتت دون جهد بذله أصحابها، ودون التزامٍ وعملٍ حثيث ودؤوب، رغم عدم امتلاكهم الأدوات المعرفية التي تتملكها الأجيال اليوم. فباتت معظم الشعوب العربية تتغنى بأخلاق الأجيال السابقة وقيمها دون أن تحاول تمثّلها، بل تكتفي بالبكاء على أطلالها، وترمي في كل مناسبة بمسؤولية ما آلت إليه أحوالها على السياسة والمؤامرات والحكومات المتخاذلة وحدها..
لكن، هل وُجدت يوماً دولة أو نظام حكم قادر على تحقيق التنمية والتطور والرخاء بمعزل عن جهود مواطنيه وعملهم الفردي والجماعي؟ وهل استطاعت أي حكومة أن تغير سياساتها أو تجعلها فاعلة دون دفع مجتمعي حقيقي قوامه المواطن/الإنسان المتعلم والعامل؟
تحت ذريعة الظروف السيئة والفقر والبطالة المنتشرة عربياً، نالت كل أنواع الفساد الأخلاقي “مشروعية” مدعومة بضعف القوانين في معظم البلدان العربية، وانتشار أشكال الفساد الأفقي والعامودي وترسخه حتى صار هو القاعدة، ومن يخرج عنه شاذ. وصارت مصطلحات مثل “حلال عليه” أو صفة مثل “الشطارة” تُمنح لمن يستطيع تحصيل أكبر قدر من المنافع دون بذل جهد، أو من ينجح في غش الآخرين وخداعهم، وتُسقط يومياً قيمة الإنسان الصادق والأمين والمثابر، ما يعني أن مجتمعات كاملة في طريقها إلى السقوط.
أردنا عصرنة الأخلاق فشوهناها!
قد يسأل سائلٌ من أين تأتي أخلاق الناس وطباعها؟
إذا كان الجواب من الدّين، فنحن أبناء هذه المنطقة، نعيش في أرض هي مهد الأديان السماوية الثلاثة؛ كُتُبها وتعاليمها ورُسلها، وهي جميعها تحضّ على الأخلاق الحسنة بدءاً من أبسطها وصولاً إلى أسماها. وإذا كانت الفلسفة مصدراً ثانياً للأخلاق، فليس من الخافي أن هذا المصدر تراجَعَ عربياً أمام سيطرة ثقافة جديدة قوامها مخاطبة الغريزة الفردية، فصارت للأخلاق المعاصِرة مصادرها الجديدة، إذ فقدت المجتمعات مصادرها الأصيلة للأخلاق، وصار مصدرها الأساس: التقليد. نعم، نقلّد ما نراه عبر وسائل الإعلام، بخاصة منصات التواصل الاجتماعي، بكل ما يحتويه من غثّ وسمين، ونطلق عليه زوراً: “مُعاصَرة”، وصرنا نلوم من لا يتّبعها أيضاً!
أما المقصود بالتقليد فأساسه قابلية الأخلاق العالية للعدوى، الأمر الذي أفسحت له وسائل التواصل الحديثة مجالاً واسعاً -كما ذكرت، فالتذمر الدائم واللامبالاة تنتشر بين الشباب العربي بخاصة بفعل التأثر بمواقف الآخرين وانفعالاتهم، وبسرعة أعلى من انتشار السلوكيات الإيجابية التي باتت تصنَّف في خانة “الغباء” أو يُحكم عليها بـ “اللاجدوى”.
وهكذا، تحولت طِباع العرب إلى شكلٍ من اللامبالاة بالحياة، فيأخذون من دينهم فكرة أنهم مسيّرون وليسوا مخيّرين، ويقنعون أنفسهم أن هذا نوع من الارتقاء الروحي، فلا داعي لخدمة عالم فانٍ، وبدل أن يجعل ذلك أخلاقهم أفضل، أحدَثَ مفعولاً عكسياً، إذ إن كل هذا الادّعاء بالانشغال بالحياة الآخرة، أوجد لدى هؤلاء اللامباليين أرضاً خصبة لإنتاج أنواع مختلفة من الكراهية والأذى والعنف بكافة أشكاله اللفظية والمادية، يوجهونه ضدَّ كل من يخالفهم التفكير أو الرأي، وبدلاً من التعقل والتفكّر والنقد البناء، حلّت الانفعالية والتطرف العاطفي في التعامل مع المشكلات والقضايا التي تمسّ حياتهم وتؤثر في مصيرهم.
وكل ذلك ليس إلا انعكاساً لأزمات داخلية وتشوهات نفسية عميقة في وجدان المواطن العربي، مردّها قلة الثقة بالنفس الممتزجة بشعور غير أصيل بالاستحقاق، وهنا يكمن التناقض الذي ينشأ عنه نوع من “الشر الذي يتجذر عندما يبدأ الإنسان بالتفكير في أنه أفضل من غيره” حسب وصف الشاعر الروسي جوزيف برودسكي، فالمواطن العربي مقتنع بأنه أفضل من المواطن الغربي وأكثر أخلاقية، ويعرف في الوقت نفسه أنه ليس كذلك، وأن الغربي يتفوق عليه، ثم يجد نفسه في دوامة السؤال: إذا كنتُ أنا أكثر أخلاقاً (حسب فهمه الخاص) فلماذا حياة الآخر أسهل؟ ولا يجد عزاءً سوى بفكرة الجزاء الأُخروي، ناسياً أن الدين نفسه يشدد على السعي الدنيوي وأهمية الحياة، وأن الله سبحانه يقول في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ففي هذه الآية دليل واضح على أهمية ودور الإنسان في تقرير مصيره.
ورغم أننا ننكر على الغرب مادّيته، ونتّهمه بها، إلا أن أخلاقياتنا -نحن اليوم- باتت تستند إلى المادة كما لم تكن من قبل، إذ إن طغيان المادية في تحديد العلاقات الإنسانية جعل من الإنسان سجين غرائزه باحثاً عن اللذة والمتعة المجانية، فغلبت الانتهازية والمصلحة الذاتية.
مع الأسف، تطغى الانفعالية والعاطفية على الشخصية العربية المعاصرة، إلى جانب موروث لا يستهان به من القبائلية بمعناها السلبي، فالفوضى تحكم حياته وتصرفاته لأنها تحكم تفكيره. وإذا كان “الفجور يأتي من الجهل” كما يرى سقراط، فلا بد أن تأتي الأخلاق من العلم والتنوّر، وسواء اتفقنا على الدين أو الفطرة أو الفلسفة والفكر كمصدر أساس للأخلاق الإنسانية أو لم نتفق، يبقى العمل بمقتضى الأخلاق والقيم معتمداً على نظرتنا الشخصية للإنسان والحياة، على مدى إنسانيتنا بالدرجة الأولى، و”الإنسان السويّ ليس بحاجة إلى التهديد بجهنم كي يكون أخلاقياً ونزيهاً” كما يقول برتراند راسل.
بوصلة اليسار..
تظهر حالة الضياع والفوضى بأوضح صورها في البلدان التي شهدت انتشار الأحزاب اليسارية والأيديولوجيا الاشتراكية التي عززت شعور المظلومية والأحقية غير القائمة على العمل والجهد الفردي، وأوحت لكثيرين بأنهم يستحقون جهد الآخرين، فولّدت لديهم حقداً دفيناً تجاه الثروة وأصحابها، وخلقت في نفوسهم أوهاماً حول استحقاقهم لما لا يستحقونه فعلاً. وقد ترافق كل ذلك بمجموعة من الخيبات والانهزامات على مختلف الصعد، فظهر مزيج من الغضب والتقاعس والانكسار، وتعززت نظرية المؤامرة وتضخمت ووجدت لها مكاناً جديداً في المجتمعات المكلومة.
أذكر مرة أنني قرأت عبارة منقولة عن أحد زعماء الحركات اليسارية العربية يُقرّ فيها بأن “الجماهير كانت مستعدة للحاق بهم كيفما اتجهوا، لكنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يقودونها”. هذه حقيقة تستطيع تفسير الكثير مما وصلت إليه شعوب تلك البلدان، فتلك الحركات والأيديولوجيات التي سيطرت على عقول أجيال كاملة كانت تفتقد المنهج والوسيلة والهدف، وانعكس ذلك على قدرة المجتمعات في صنع حضارتها لأنها فشلت في توليد مجموعة قيم حاضنة ورافعة لتلك الحضارة، بل على العكس، عززت شعور الفرد بأنه ضحية، وتشكلت تبعاً لذلك بُنية ذهنية صبغت المجتمع برمّته وأضاعت بوصلته.
نحن والغرب “اللاأخلاقي”..
منذ عقود ونحن نتّهم الغرب بقلة أخلاقه، مدّعين أننا أصحابها، فما هي الأخلاق التي نتفوق بها فعلاً؟ على أرض الواقع، ليست إلا مجموعة سلوكيات محدودة، ومن جرّب الاختلاط مع الشعوب الغربية يعلم جيداً أن معظم ما نتفاخر به كأخلاقيات نعتقد أنها حصرٌ على مجتمعاتنا، موجودة لدى الشعوب الغربية أيضاً، لكن البروباغندا التي تقودها بعض الجهات ذات المصلحة، هي التي رسّخت تلك الصورة المعاكسة.
والحقيقة أن شعوب الغرب في معظمهم واعون لقيمة العلم والعمل والأمانة وأداء الحقوق واحترام الآخرين ومعتقداتهم، وملتزمون بالقوانين أكثر منا بمراحل. وقد لمس المهاجرون من العرب حقيقة هذا الكلام، ما شكَّل لهم صدمة في بعض الأحيان، إذ وجدوا في بلاد الغرب تحقيقاً لشروط الحياة الإنسانية وتعاملاً مختلفاً عما اعتقدوه، وصاروا هم أنفسهم أكثر جِدّاً والتزاماً واحتراماً للآخر.
أليست هذه الأخلاقيات هي جوهر ديننا وعاداتنا؟ ربما يكون هذا بالذات ما دفع الإمام محمد عبده بعد عودته من زيارة أوروبا عام 1881 م لقول جملته الشهيرة: “رأيتُ في أوروبا إسلاماً بلا مسلمين، وأرى في بلادي مسلمين بلا إسلام”. إن سوء الطباع وتراجع الأخلاقيات مسؤولة بدرجة كبيرة عن تحديد نظرة الغرب إلينا، وهو ما نقدمه حين نهاجر خارج بلداننا، فإذا كنا أصحاب حضارة -كما ندّعي، فلماذا لا نقدّم وجهنا الحضاري للآخرين؟ ونشعر بالشراكة الإنسانية بدل شعورنا الزائف بالتفوق، والذي قادنا إلى واحدة من أخطر مشكلاتنا المعاصرة وهي الحاجة إلى الحضارة الغربية ورفضها في الوقت ذاته؟
علينا أن ندرك أن الغرب لم يتقدم بالتطور التكنولوجي وحده، لكنَّ شعوبه طوّرت قيماً تربوية وثقافية وفكرية بموازاة ذلك حتى استطاعوا البروز والتفوق، والحركة التي تحرروا بها من سلطة الكنيسة ورجال الدين تضمنت تطويراً للقيم الإنسانية في الوقت نفسه، وظل العمل والمعرفة والبناء والتنمية منهجاً يتأصل يوماً بعد يوم، وعلى أي حال، لست بصدد المقارنة بين المجتمعات، إذ إن ظروفها مختلفة بالتأكيد، لكن الوعي بفكرة “أساسية الأخلاق في صنع الحضارة” هي نقطة مفصلية وشديدة الأهمية.
استرداد الأخلاق أم تطويرها؟
بين أزمة الفكر وأزمة الأخلاق صلةٌ وثيقة، فالفكر هو المُنِتج الحضاري لأي مجتمع، ومن البديهي أن تنعكس أزمته أول ما تنعكس على منظومة القيم التي يمتلكها المجتمع، وحين تحدث الأزمة الأخلاقية، فمن شأن ذلك توليد شكل جديد من الفكر يحمل التشوه ذاته ويدعمه، ثم تتكرر العملية دون نهاية لكن مع ابتعاد مطرد عن نقطة البداية؛ نقطة السقوط الأولى للفكر التي أخذت في طريقها الأخلاق والحضارة. لذا، ستصبح العودة أصعب فأصعب، على أنه يمكن للإرادة والقوانين وتفاعلات الزمن والحضارة أن تعيد في لحظة ما وضع ركائز لفكرٍ جديد يؤسس لمنظومة أخلاقية جديدة تناسب العصر وتُبقي على الجانب الإنساني الذي هو أساس كل خُلُق حَسَن.
يبدأ ذلك بالوعي بفكرة الأخلاق الفردية ومسؤولية كلّ منا على حدة عن تشكيل مجتمع أخلاقي. أنا أطالب نفسي بالأخلاق وأعمل بها قبل أن أطلبها من الآخرين، وأتقبل فكرة أن الأنظمة السيئة ليست وحدها مسؤولة عن انهيار أخلاق المجتمع، فالشعب في كل مكان وزمان هو الأداة الأساسية للحركة، والقيم التي يتبناها ويلتزم بها هي ما يحدد مستقبله فعلاً.
الأخلاق كأي منتج فكري إنساني قابلة للتطور والعصرنة، لكن بطريقة صحيحة ليست كما يحدث اليوم، وإعادة التفكير في منظومتنا الأخلاقية العربية الحالية هو ضرورة ملحة، فالأخلاق هي الأساس المتين الذي تقوم عليه الحضارات والدول، وهي بمثابة الروح التي تضفي على الأمة قوتها وشخصيتها، وعندما تفقد الأمة هذه الأخلاق، فسوف تفقد بالضرورة تماسكها وتصبح عرضة للانهيار والسقوط. وقد عبّر أمير الشعراء أحمد شوقي عن هذا ببيت أظنّه من أعمق وأجمل ما نُظم من الشعر عندما قال:
وإنَّما الأممُ الأخلاقُ ما بَقيتْ….. فإنْ هُمُ ذَهَبتْ أخلاقُهُم ذَهَبوا
فهل ذهبت أخلاق العرب.. فذهبوا؟!