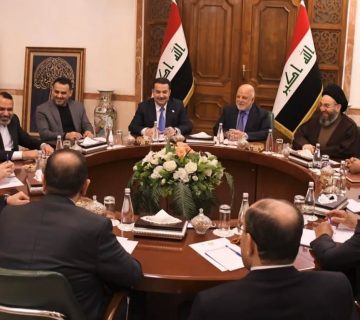*كاتب هذا المقال هو مراسل خاص لمجلة فورين بوليسي في المملكة العربية السعودية
صورة الكعبة المشهورة والمتداولة في جميع أنحاء العالم تتمثل بدوامة الحجاج العامرة، المؤلفة من آلاف الأشخاص المكتسين باللون الأبيض، وهم يدورون ببطء في دوائر حول المكعب الأسود المذهّب، إنه أقدس موقع في الإسلام، الكعبة المشرفة، والمسجد الذي يحيط به، اللذان استقطبا المسلمين وغير المسلمين على حد سواء لأكثر من ألف عام، إنه الرمز الديني الأسمى، الذي يعبّر عن الوحدة الروحية العالمية، والقبلة التي ييمم شطرها جميع المسلم في العالم أثناء صلاتهم.
ولكن الصور قد تكذب؛ فالصلاة في المركز الروحي للإسلام كمسلم شيعي، الطائفة الأقل تعدادًا من طائفتي المسلمين الرئيسيتين، هو كحضور معمداني جنوبي لقداس كاثوليكي، أو بشكل أكثر دقة في هذه الأيام، كحضور بروتستانتي لقداس كاثوليكي في الفاتيكان خلال حملة الإصلاح المضادة.
أديت فريضة العمرة بعد أسبوع واحد فقط من تنفيذ الحكومة السعودية لحكم الإعدام برجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر النمر، الحادثة التي أججت موجة من الاحتجاجات في المجتمعات الشيعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إحراق السفارة السعودية في طهران؛ مما دفع المملكة السعودية لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، في فعل يُعد تتويجًا لسنوات من تدهور العلاقات بين القوة السنية الرائدة في العالم ومنافستها الجيوسياسية الدينية، ذات الأغلبية الشيعية، جمهورية إيران الإسلامية.
كصحفي استحصل على تأشيرة لغاية العمرة إلى المملكة العربية السعودية، كنت أمتلك الكثير من الأسباب للقلق حتى قبل وصولي إلى المملكة؛ فكنت أعرف بأن كتابتي عن تجربتي القادمة في السعودية قد تحول بيني وبين عودتي أو حتى عودة عائلتي من زيارتنا المقدسة، أو قد أتجابه بما هو أسوأ؛ فالمملكة العربية السعودية اعتقلت، حبست، جلدت، وحتى أعدمت، الكتّاب الذين انتقدوا سياساتها أو اتجاهاتها الدينية، وكنت أدرك بأنني وشيعي،ـ أحمل على جواز سفري اسمًا إيرانيًا، قد اخترت ربما أسوأ وقت للذهاب إلى السعودية.
المذهب الرسمي من الدين الإسلامي الذي تعتنقه المملكة العربية السعودية والأسرة السعودية المالكة، التي حكمت المدينتان المقدستان، مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ عام 1925، هو المذهب الأصولي للإسلام السني الذي يُدعى بالمذهب الوهابي، حيث يوجب هذا المذهب الامتثال الشرعي والاجتماعي الصارم بقوانين الشريعة الدينية، ويعتبر بعض الانحرافات في العقيدة أو الممارسة على أنها ردة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في بعض الأحيان، كما أن رجال الدين في المملكة السعودية يعتبرون تبجيل الشيعة لأئمتهم باعتباره شكل من أشكال الشرك، وهي أعظم الكبائر في الدين الإسلامي، ويتم فرض هذه القواعد المعيبة على الأقلية الشيعية في المملكة السعودية، البالغة 15% من مجمل السكان، حيث يُمنع أعضاء هذه الطائفة من تسلم المناصب الحكومية أو العسكرية رفيعة المستوى ضمن المملكة.
يدعي آل سعود بأن قناعاتهم الدينية لم تؤثر على مهامهم في خدمة الحرمين الشريفين، ويمكننا بالتأكيد أن نجزم بأن الصراعات بين السنة والشيعة ليست أمرًا جديدًا وطارئًا ضمن سياسات الشرق الأوسط، ولكن في كل مرة اطردت فيها الانشقاقات الدينية في المنطقة، أو تصاعدت فيها الطموحات الجيوسياسية للدول المنافسة للسعودية لتعكس نفسها بصورة صراع عسكري، شعر المسلمون الشيعة في المملكة السعودية حتمًا بوطأة تلك التوترات على حياتهم، بما فيها ممارستهم المتعلقة بالحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أسفرت هذه التوترات في بعض الأحيان عن طفوق عنف وتمييز ضد الحجاج في مكة؛ ففي عام 1987 وقعت أشهر حادثة أثناء الحج، عندما أدت المواجهة بين الحجاج الشيعة الإيرانيين والشرطة السعودية إلى وقوع أكثر من 400 حالة وفاة، ومنذ ذلك الحين وقعت حوادث أصغر ولكن بصورة متفرقة؛ ففي عام 2009، هاجمت الشرطة الدينية السعودية مجموعة كبيرة من الشيعة في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، التي يرقد فيها أربعة من كبار الأئمة الشيعيين، وفي عام 2013، ادعت مجموعة شيعية قادمة من الولايات المتحدة بأنهم تعرضوا للاعتداء من قِبل مجموعة من المسلمين السنة القادمين من أستراليا أثناء أداء فريضة الحج، وأن السلطات السعودية تجاهلت قضيتهم، وفي أبريل 2015، أدى الاعتداء المزعوم على اثنين من الحجاج الإيرانيين الشباب من قِبل السلطات السعودية في مطار جدة إلى قيام طهران بتعليق رحلاتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية للأشخاص الراغبين بأداء مناسك العمرة.
قبيل رحلتي بأيام معدودة إلى المملكة، انهارت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، علمًا أنه وقبل أشهر، وحتى قبل تنفيذ حكم الإعدام بالنمر، حذرني أحد معارفي الشيعيين، وهو صحافي سابق أدى فريضة الحج قبل عدة سنوات، مرارًا وتكرارًا من وجوب أخذ الحذر، وقبل مغادرتي إلى المملكة العربية السعودية من مسكني في الولايات المتحدة، أوشكت تقريبًا على إلغاء رحلتي تحت إلحاح أصدقائي المقربين، ولكنني أقدمت عليها في النهاية، وفعلًا، سرعان ما أدركت كم كنت مخطئًا في عدم الاكتراث وقبول المشورة التي قدمها لي أصدقائي.
طوال وجودي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لم أتقابل بأي إيراني آخر، وناهيك عن شعوري بالاختلاف عمّن يحيطون بي، أُجبرت على أن أشعر بالانسلاخ خلال رحلتي؛ فمنذ صباح اليوم الأول لي في المدينة المنورة، تنازع داخلي شعور الالتزام الديني مع شعور الوعي الذاتي وذلك أثناء وجودي في المسجد النبوي الشريف لأداء صلاة الصبح، حيث كان من المستحيل بالنسبة لي أن أشارك بالصلاة دون أن أبدو مختلفًا للغاية؛ فالمسلمون السنة يصلون بشكل مختلف عن الشيعة، ومن ذلك قولهم لكلمة “آمين” في أوقات مختلفة عمّا يقوله الشيعة أثناء صلاتهم، كما أن المصلين السنة يلامسون جباههم بالأرض عندما يسجدون للصلاة، بينما لا نضع، نحن الشيعة، جباهنا على الأرض مباشرة، بل فوق قطعة صغيرة مستديرة من الطين معروفة باسم التربة (التربة الحسينية)، وذلك كنوع من التواضع واعترافًا بأننا جئنا من التراب وإليه سنعود، ولكن التفسير الوهابي يعتبر ذلك شكلًا من أشكال عبادة الأوثان؛ لذا تمنع السلطات السعودية استحضار التربة إلى أي من المواقع المقدسة، وفضلًا عما تقدم، يعقد الغالبية العظمى من المصلين السنة أيديهم أمام صدورهم بينما يصلون، بينما يترك المصلون الشيعة أيديهم مرخاة على جانبيهم أثناء الصلاة.
هناك، وفي المسجد النبوي الشريف، ذاك البناء الضخم القادر على استيعاب حوالي نصف مليون مصلٍ، وقفت وحدي ضمن بحر من ترديدات الآمين في مناسبات لم أتوقعها، وبين حشد من الأيادي المعقودة على الصدور، وفكرت في خياراتي، إنه شعور أعرفه جيدًا، شعور مألوف لدى أي مسلم عاش في أوروبا أو في الولايات المتحدة في أعقاب وقوع أي هجوم إرهابي إسلامي؛ فارتفاع درجة كراهية الإسلام بعد هذه الحوادث، يجبرنا على أن نسأل أنفسنا، هل يجب أن أخرج مرتديًا الزي الإسلامي؟ وفي الحفلات، هل يجب أن أتظاهر بشرب المشروبات الكحولية بغية الاندماج بالحشد؟
ولكنني لم أكن أتوقع أن أمارس هذا الحوار الداخلي في مسقط رأس الإسلام، حيث كنت قد قضيت أسابيعًا قبل الرحلة أتساءل حول الشعور الذي سيخالجني عندما سأقف بالقرب من قبر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والصلاة في المسجد الذي أسسه في المدينة التي رحبت به بعد فراره من اضطهاد مكة المكرمة في عام 622 للميلاد، هل سأشعر بقرب جديد إلى الله؟ ولكن الآن، وفي الوقت الذي كنت محاطًا به بآلاف الأيادي المعقودة إلى الصدر، جال في خلدي مئات التقارير التي طغت على وسائل الإعلام مؤخرًا، وطويت يداي على صدري بدلًا من وضعها على جانبي، وحينها، شعرت بالعار، بدلاً من شعوري بالرهبة والخوف.
في اليوم التالي، قررنا أن نبحث عن مكان للعبادة نشعر ضمنه بأننا أكثر قربًا لتقاليدنا، عن أقرب مسجد شيعي يمكن أن نجده في المدينة المنورة، وفي ذاك اليوم، نظرت بقلق إلى سيارة الشرطة التي تتسكع على بعد حوالي 50 ياردة من مدخل مزرعة النخيل، حيث تجمعنا في مجموعتين أمام بوابة المزرعة، مجموعة من الرجال، تواجهها أخرى من النساء المحجبات والمتشحات بالرداء الأسود من الرأس حتى أخمص القدمين، وحينها، تقدم شخص من المجموعة ليقرع الأبواب الخشبية الثقيلة، مطالبًا بالسماح للمجموعة بالدخول.
هذا الموقع ليس مجرد مزرعة نخيل؛ فخلف البوابة الخشبية الشاهقة، ووراء الجدار الإسمنتي الأصم وفدان أشجار النخيل، تكمن قاعة اجتماع الشيعة؛ فالسكان الشيعة الأصليون في المدينة المنورة تربطهم علاقة تاريخية مع زراعة النخيل، وقاعة اجتماع الشيعة، وكما هو الحال مع غيرها من نقاط التجمع الشيعية المماثلة التي يُشاع عن وجودها في المدينة المنورة، لا تعتبر من الناحية الفنية مسجدًا، مما يدل على مستوى الاعتراف الرسمي بالشيعة من الحكومة السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الشيخ الذي يعمل في قاعة الاجتماع كان قد درس سابقًا في قم، المركز الديني الإيراني، حيث سَمِعَ مرافقي بهذا التجمع من خلال أحد معارفه في إيران.
لم يكن من السهل علينا أن نعثر على مزرعة النخيل التي يتوضع داخلها مكان التجمع الشيعي؛ فمن نافذة غرفة الفندق التي استأجرناها، كان يمكننا أن نرى المسجد النبوي، والشارع المزدحم المؤدي إليه، والذي يفيض بالمحلات الصغيرة التي تبيع الملابس الدينية وسجاد الصلاة، وبالباعة المتجولين الذين يبيعون الأوشحة والفواكه، وبالحجاج المكتسين بالبياض والمسرعين جيئة وذهابًا، ومن ذاك المكان كان من السهل علينا أن نستقل سيارة أجرة، بل إننا كنا نأمل في البداية أن نستخدم خدمة أوبر للنقل المتاحة حديثًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ نوفمبر 2015، ولكننا لم نتمكن من تحديد العنوان على تطبيق الخرائط، وخلال بحثنا على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والفارسية لم نستطع الحصول على اسمه الصحيح، حيث كنا نسميه باسم “مسجد القربان”، تيمنًا باسم الحي الذي علمنا أنه يقع ضمنه.
لحسن الحظ، كان الشيخ في فندقنا، وهو مسلم فلبيني يدعى عبد اللطيف، فطنًا وحذقًا للغاية، حيث كان يعرف بيت عبادة شيعي يقع في مزرعة الشيخ عمرو، وعرض علينا أن يدلنا على الاتجاهات، ولكنه حثنا على اصطحاب جوازات سفرنا معنا، تبعًا لاحتمال وجود نقطة تفتيش للشرطة على الطريق، لوقوع بعض “المشاكل” في المنطقة، كما قال.
اصطحبنا عبد اللطيف إلى خارج الفندق ليساعدنا على استقلال سيارة أجرة، ودُهشت عندما لاحظت بأنه لم يعمد إلى إيقاف العديد من سيارات الأجرة الخالية التي مرت أمامنا، وعندما سألته، أجابني: “أنا أبحث عن سائق أجنبي، لأن السعوديين، كما تعلمون …” سكت مُطرقًا، وفي نهاية المطاف، عثر على سيارة أجرة يقودها شخص باكستاني، والذي استطاع معرفة وجهتنا، ووافق على نقلنا إلى هناك بمبلغ 20 ريال، أي ما يعادل 5 دولارات.
تبين لنا بالمحصلة بأن مزرعة الشيخ عمرو قريبة جدًا من مكان الفندق الذي نقطن فيه، حوالي 2 كيلومتر جنوب غرب المسجد النبوي، حيث تقع المزرعة في حي سكني هادئ مليء بالمباني متصدعة الواجهات والمكونة من ثلاثة طوابق بأغلبها؛ ولكوننا وصلنا قبل نحو ساعة من الصلاة، قضينا بعض الوقت للسير حول الجدار المحيط بالمزرعة، حيث مررنا بجانب بضعة أراضٍ فارغة تناثرت ضمنها مواد البناء، وبأماكن تنتشر فيها قطط الشوارع المغبرّة، ومحلات صغيرة لبيع الوجبات الخفيفة، وعندما عدنا إلى المدخل، كان قد تجمع حشد صغير من المصلين، جنبًا إلى جنب مع سيارة شرطة تتسكع في المنطقة بوضوح، وفي تلك اللحظة، وأثناء وقوفي خارج أسوار المزرعة تحت أنظار العين الساهرة للسلطات المحلية، وغير متيقن إن كان سيسمح لنا بالدخول أم لا، بدأت أتساءل إن كانت فكرة القدوم إلى مكان عبادة شيعي في المدينة فكرة سيئة، ولكن أخيرًا، فُتحت الأبواب، وسُمح لنا بالدخول.
على الرغم من عشرات الآلاف من الناس المتزاحمين داخل وحول المباني العامة الكبرى المقدسة، لم أتصادف بأي دورية تفتيش أمني في السعودية، ما عدا تلك التي كانت ضمن المطار، والتي اقتصرت على تمرير الماسح الضوئي أو على البحث بسرعة ضمن الحقائب؛ فالأمن العام بالكاد يبدو وكأنه أولوية قصوى بالنسبة للسلطات السعودية، ولكن أعضاء دار العبادة الصغير، والذي لا يستوعب سوى بضع مئات من المصلين، كانوا مضطرين لرؤية الأمور من منظور مختلف، حيث نظموا فريق تفتيش خاص بهم من المتطوعين، الذين كانوا يفتشون أجسام الواصلين الجدد وهواتفهم الخلوية، للتأكد من أن هذه الأجهزة هي عبارة عن أجهزة اتصال طبيعية، وليست أجهزة أخرى أقل وديّة.
بالنسبة لي، فقد تجاوزت التفتيش الأمني دون أي مشكلة، ولكن المتطوع الأمني لاحظ وجود حقيبة صغيرة، كانت تحتوي على جواز السفر وبعض النقد، التي دسها مرافقي بالسفر تحت قميصه، وطالبه، من خلال الإيماءات، لمعرفة محتويات الحقيبة أثناء ترقبه بحذر وتوجس، وتردد بالسماح له بالدخول حتى رأى جواز السفر الإيراني، وحينها قال بارتياح واضح “ما شاء الله!”، ولوّح لرفيقي للدخول على طول الطريق.
بناء التجمع الشيعي يقع خلف بساتين النخيل الناضجة، وهناك، كانت المطرزات النسيجية التي تمجد الأئمة الـ12 للشيعة تغطي جدران الفناء والبناء في الداخل، حيث شعرت كما لو أنني قد دخلت للتو إلى مسجد إيراني، وبعد أن خلعنا أحذيتنا وانخرطنا في صفوف الصلاة، شعرت بالاسترخاء، وحين قام الأشخاص من حولي بإخراج التربة من جيوبهم ووضعها على السجاد أمامهم، أخذت قرصًا صغيرًا من أحد الرفوف المتوضعة على الجدار، وعلى عكس العديد من النساء السنيات السعوديات اللواتي يرتدين النقاب حتى أثناء الصلاة، كشفت النساء ضمن التجمع قبيل الصلاة عن حجاب وجوههن، تماشيًا مع التقاليد الشيعية، وارتدين الجادور، الرداء الذي تشتهر به النساء الشيعيات، ولكنه ليس حكرًا عليهن.
من خلال هذه التغييرات البسيطة تحولت القاعة التي تغص بالغرباء الذين لا أشاطرهم اللغة، إلى مكان يفيض بالدفء والألفة، وعندما بدأت الصلاة، كنت أعرف متى يجب عليّ أن أقف، متى يجب أن أسجد، وماذا عليّ أن أقول، أرخيت يداي على جانبي دون خوف، ولمست جبهتي كتلة التراب الباردة، وهمست شاكرًا الله.
حاولت أن أحافظ على الدفء الذي شعرت به عندما سافرت إلى مكة المكرمة بعد عدة أيام لأداء شعائر العمرة في المسجد الحرام، ولكن ضمن هذه الطقوس أيضًا يوجد اختلافات شيعية ثابتة ومغايرة للطقوس السنية؛ فعند الطواف حول الكعبة المشرفة، العديد من السنة يرفعون يدهم في كل مرة يمرون فيها بحانب الحجر الأسود ويصيحون “الله أكبر”، ولكن الشيعة لا يفعلون ذلك عادة، حيث يجب علينا أن نُبقي رؤوسنا موجهة إلى الأمام في جميع الأوقات، والامتناع عن تحريكها إلى اليمين أو اليسار أو الخلف؛ لذا، ومع طواف الحجاج حول الكعبة، سيبدو الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقلية الطائفية الشيعية واضحين للعيان تمامًا.
بعد ظهر ذلك اليوم، حدقت في أول بيت لله من موضعي بالطابق الثالث ضمن المنصة الدائرية التي تحيط الكعبة، دققت في كسوة الكعبة من قماش القنب الأسود المطرّز بالذهب، والأبواب المذهبة التي تطل عليها من خلال فتحة في الجانب، وتذكرت ما قرأته حول الهيكل الأصلي للكعبة، الذي لم يتجاوز ارتفاعه طول الرجل العادي، بدون أي سقف يغطيه؛ فالنبي إبراهيم لم يكن يمتلك الذهب ليزين الكعبة، ولم يمتلك أيضًا وشاحًا يستطيع مقاومة جميع الأحوال الجوية لحماية بيت الله من العناصر الطبيعية، لقد كانت الكعبة الأصلية بسيطة، كانت متواضعة، تلك الكعبة التي سبقتنا بوجودها جميعًا، فتأسست قبل وجود السنة، الشيعة، الوهابية، الأحمدية، الإسماعيلية، والعديد من الطوائف الأخرى الأصغر حجمًا التي تفرق بيننا اليوم.
بالمحصلة، وعندما بدأ الإمام بالمنادة للصلاة، أبقيت يداي إلى جانبي.
في رحلة العودة إلى منزلي في الولايات المتحدة، شعرت بالسلام في داخلي، ولكن هذا الشعور لم يأتِ من التنوير الذي شهدته بالسعودية، لأن لحظات الصفاء الروحي التي اختبرتها هناك كانت عابرة، وطغت عليها في معظم الأوقات مشاعر التوجس التي كنت أحملها تجاه من حولي، ومسحة الخوف التي شعرتها داخل نفسي، ولكن ما أعطاني ذاك السلام حقًا هو إداركي بأنني عائد إلى البلاد التي تكرس الحرية الدينية في الدستور، حيث لا يمارس الشيعة والسنة والمسيحيين واليهود والبوذيين عبادتهم بحرية فحسب، بل يمارسونها أيضًا في بعض الأحيان معًا بصدق وصراحة، متعلمين من النهج الإيماني لبعضهم البعض، لقد شعرت بالخجل جرّاء إخفائي لهويتي الشيعية، ولكن هذا العار ليس عاري، إنه عار السلطات السعودية، التي صعّبت على الحجاج المسلمين أن يروا الله من خلال عدم الثقة، العقيدة المتزمتة، ومراكز التسوق منعدمة الروح، التي تزدحم بها الشوارع بالقرب من الكعبة المشرفة.