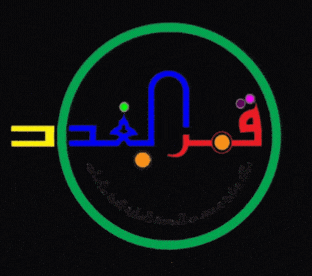الدكتورة جواهر آل سعود تحكي لـ«الشرق الأوسط» عن قيادة مؤسسي البلاد توجهاً للقضاء على النفوذ الأجنبي
حقق الإمام محمد بن سعود بعد رحلة كفاح استمرت أربعين عاماً، وهي مدة حكمه، منجزات لافتة، تمثلت في تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي تعد أول دولة مركزية في الجزيرة العربية، ونشر الأمن وحقق العدل والاستقرار في ربوعها، كما نظم أمور الدولة السياسية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية، وتأمين طرق الحج والتجارة، والتصدي للحملات المعادية للدولة الوليدة، لكنه آثر بشكل مؤقت ألا يستعدي القوى الكبرى لضمان نجاح مشروعه الكبير في بناء دولة مركزية، وحمايتها من القوى الأخرى في المنطقة، والتطلع إلى طرد العثمانيين وولاتهم من المناطق العربية، وبعد وفاته عام 1765، واصل أبناؤه وأحفاده السير في الحفاظ على مكتسبات الدولة، وتوسيع نفوذها، وقطع دابر أعدائها، لتبلغ أقصى مدى لها، وتصل حدودها إلى إمارات ساحل الخليج العربي وعمان شرقاً، وإلى أجزاء من اليمن جنوباً، وأجزاء من العراق وبلاد الشام شمالاً.
ووضع الأئمة السعوديون خططاً، وقادوا توجهاً للقضاء على النفوذ الأجنبي في الأراضي العربية، الذي يهدد وجود دولتهم ومصالحها، إضافة إلى الحضور العروبي عندهم وحرصهم على التخلص من المحتل الأجنبي لأراضٍ عربية. وبرز هذا التوجه السعودي خلال مواجهات مع الفرس والعثمانيين لتحقيق هذه الأهداف.
الباحثة الدكتورة جواهر بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود كشفت في حوار مع «الشرق الأوسط» طبيعة هذا التوجه في الدولة السعودية الأولى، وما صاحبه من أحداث وتطورات للقضاء على الوجود الأجنبي في الأراضي العربية، تحديداً في كل من العراق وسوريا، وجاء الحوار كما يلي:
ما هو موقف الأئمة السعوديين من الوجود العثماني في الولايات العربية؟
في الوقت الذي كانت تنتشر فيه مراكز للحكم العثماني في الولايات العربية، التي تهدف إلى ربط تلك المناطق بالتبعية للدولة العثمانية والقضاء على أي تحرك ينادي باستقلال العرب، كان ظهور نشاط الأئمة السعوديين الذين لعبوا دوراً مهماً في أحداث تلك الحقبة، في محاولة تخليص العرب من الهيمنة العثمانية لتكوين دولة إسلامية عربية حرة.
كان الإمام محمد بن سعود يدرك موازين القوى، لهذا تحاشى استعداء القوى الكبرى في المنطقة مؤقتاً حتى يشتد عود دولته، حرصاً منه على نجاح مشروعه في مرحلته الأولى، التي بعدها سيعمل على الانطلاق لطرد العثمانيين من الأراضي العربية.
لم تكن وفاته عام 1179هـ/ 1765م نهاية لمشروعه التقدمي، فقد كان ابنه الإمام عبد العزيز مدركاً لأهداف والده وسعيه الحثيث، ولهذا كان عازماً على مناطحة القوى الاستعمارية في المنطقة. فبدأ تحركه نحو الحجاز غرباً، والخليج في الشرق، والعراق والشام في الشمال، وجنوباً عمان واليمن في آن واحد. وأكدت الوثائق البريطانية تقدمه عبر الساحل الشرقي للخليج وصولاً إلى إقليم بر فارس البحري، الذي انتزعه إلى غير رجعة من الحكم الفارسي، حتى نجح في تغيير موازين القوى، مما ترتب عليه تواتر التحذيرات من الولايات العربية العثمانية إلى السلطان العثماني، مؤكدةً تنامي نفوذ الإمام السعودي.
مقتل تجار نجديين يثير أزمة سعودية فارسية
ما هي أهم العلامات الفارقة في العلاقات السعودية الفارسية في عهد التأسيس الأول؟
تعددت الحملات العثمانية بأوامر السلطان العثماني بهدف القضاء على النفوذ السعودي، وكان إحداها حملة علي باشا على الدرعية عام 1799، التي انتهت بعقد هدنة مع السعوديين تنص على عدم الاعتداء من قبل الطرفين. إلا أنه في العام التالي، تم قتل ثلاثمائة من التجار النجديين في النجف بطريقة وحشية، فجاءت تلك الحادثة لتشعل فتيل أزمة سعودية فارسية أثارت مخاوف سليمان باشا والي بغداد؛ لإدراكه أن الإمام عبد العزيز لن يفوت مثل هذه الفرصة للقضاء على النفوذ العثماني في العراق. لهذا سارع بتأديب المعتدين في محاولة لإرضاء الإمام السعودي، الذي كان هذا الهجوم سبباً كافياً لعدم التزامه بالهدنة، رغم محاولات والي بغداد للحد من تفاقم الأزمة معه. وذكرت تقارير وزارة الخارجية الفرنسية أن الإمام عبد العزيز أوفد رُسله على عجل إلى سليمان باشا والي بغداد يطالبه بالقصاص من المذنبين، الذي لم يكن لوالي بغداد مقدرة على تنفيذه خشية فتح جبهة جديدة مع الفرس، مما دفع سليمان باشا والي بغداد إلى إرسال مبعوث إلى الإمام السعودي لمفاوضته بقبول الدية. وأشار التقرير الفرنسي إلى رد فعل الإمام السعودي الذي ضحك وقال: «أما كفى والي بغداد أننا تاركوه يحكم بغداد؟ والله عن قريب ترى جميع غربي الفرات لنا وشرقيه له»، مما يؤكد النيات السعودية بطرد العثمانيين من الأراضي العربية. أما الوثائق العثمانية فقد أكدت ربط الإمام السعودي تجديد الهدنة بالحصول على منطقة الشامية الممتدة من مقاطعة عنّة (الأنبار) حتى البصرة، ويعد ذلك أمراً تعجيزياً، مما يوضح أن الدرعية لن تتجاوز هذه الأزمة بالسهولة التي توقعها والي بغداد.
هجمات سعودية للقضاء على النفوذ العثماني
ما هي الإجراءات التي اتخذها الإمام عبد العزيز بن محمد تجاه تلك التطورات؟
جرّد الإمام عبد العزيز قوة تزيد عن عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة ابنه سعود، وفي 20 أبريل (نيسان) 1801 انطلقت سلسلة من الهجمات السعودية المتتالية بهدف تقويض النفوذ العثماني الفارسي في الأراضي العراقية، مما أثار مخاوف السلطان سليم الثالث من فقد ولاية بغداد.
حداد فارسي ولوم عثماني
من خلال قراءتك لتلك الأحداث كيف تصفين رد الفعل الفارسي عليها؟
استشاط الشاه الفارسي غضباً على جرأة السعوديين وتخاذل السلطات العثمانية، وأعلن الحداد لأربعين يوماً بعد أن تجمهر الفرس مطالبين بالانتقام من السعوديين.
تزامن ذلك مع انتشار الشائعات في فارس حول التقدم السعودي، مما دفع شاه فارس لإرسال رسالة أخرى يلوم فيها السلطات العثمانية على تباطؤها في اتخاذ إجراءات فعلية لإيقاف هجمات السعوديين.
إرباك سعودي للباب العالي
ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمانية لاحتواء الأزمة السعودية الفارسية؟
أكدت الوثائق العثمانية أن السلطات العثمانية كانت تبذل قصارى جهدها للحد من نفوذ الإمام عبد العزيز في ولاياتها العربية في العراق والحجاز وبلاد الشام، وتعمل على قدم وساق للحد من تفاقم الأزمة السعودية الفارسية، التي قد تلقي بظلالها على العلاقات الفارسية العثمانية رغم الإجراءات التي اتخذتها لإرضاء الشاه الفارسي، مع إدراكها أنها لن تَسْلَم من مكر ودسائس الفرس التي تستوجب التيقظ والحذر المستمر، مما سبب إرباكاً في الباب العالي. وتواردت الرسائل وعقدت الاجتماعات، وصدرت الأوامر بتحصين الولايات العثمانية خوفاً من التقدم السعودي، الذي قد ينتهي بسقوط العراق بأكمله في أيديهم، بعد أن فتحت تلك الأزمة باب العداء السعودي الفارسي.

في خضم تلك الأحداث، أكدت الوثائق العثمانية إرسال سليمان باشا والي بغداد خطاباً للسلطان العثماني يؤكد استمرار اضطراب الأمن في العراق، وظهور بوادر مخيفة بشأن شاه فارس، مما قد يؤدي إلى اتخاذ تلك الحادثة ذريعةً لنقض العهد المبرم مع الدولة، خاصةً لما عرف عنهم منذ القدم بنقض العهود عند استشعارهم القوة. وقد زاد التحرك الأخير للأمير سعود بن عبد العزيز من تأجج غضب الشاه الفارسي الذي تصرف وكأن القطر العراقي من أملاكه، مما أثار حفيظة السعوديين، الذين يعتبرون أنها أراضٍ عربية، وساهم ذلك في إشعال نار العداء بينهما. ورغم سعي والي العراق الحثيث لإطفاء شرارة هذه الفتنة بكل الطرق، فإنه لم يحقق أي تقدم بهذا الشأن، مؤكداً أنه ليس له قِبَل بمواجهة الشاه الفارسي أو الإمام السعودي، وبدأ بالاستعداد لمواجهتهما كخطر يهدد النفوذ العثماني في العراق.
مخاوف من استيلاء السعوديين على العراق
ما هي السبل التي اتخذها والي بغداد لإدارة الأزمة السعودية الفارسية؟
كان تكليف سليمان باشا والي بغداد لإدارة هذه الأزمة قد جعله في موضع لا يحسد عليه. ومما يبدو أن الشاه الفارسي قد أصر على عدم إقفال ملف تلك القضية أو تركها تمر بسلام، واستمر مبعوثوه بالوفود حتى أبلغ والي بغداد في عام 1802 بأنه ينوي الانتقام من السعوديين الذين لن يتراجعوا عن التقدم نحو أهدافهم، مما دفع سليمان باشا والي بغداد لتقديم اقتراح للسلطات العثمانية، مطالباً بتحرك دبلوماسي عن طريق إرسال مبعوث رسمي إلى الشاه الفارسي ليقطع الطريق على أي تحرك عسكري من قبله. كما نصح بـ«السعي الحثيث للقضاء على الإمام السعودي بعد الجرأة التي اتسم بها نتيجة قوة نفوذه وشهرة صيته، مما يصعب التخلص منه. وشدد على أنه إن لم يتم إيقافه والحد من نشاطه في وقت قريب، فإنه سوف يقوم بالاستيلاء على العراق».
كان وصول تقارير تشير إلى اتساع هيمنة الإمام السعودي وازدياد أتباعه بشكل غير مسبوق، قد أدى إلى تعذر مواجهته. لهذا جنحت السلطات العثمانية إلى استخدام الدبلوماسية عن طريق إرسال خطاب ودي، تنصح فيه الإمام السعودي بعدم إثارة العنصر الفارسي. وتعد هذه المرحلة منعطفاً جذرياً في مسار السياسة الخارجية العثمانية تجاه القوة السعودية التي أصبح وجودها واقعاً سياسياً زاد من إرباك السلطات العثمانية ووضعها أمام مشكلتين رئيسيتين: الأولى التعاطف العثماني مع القضية الفارسية مقابل عدم تحرك السلطات العثمانية، خصوصاً وأن ضغط الرأي العام الفارسي قد أعطى الشاه فرصة لتحرك جاد إزاء النشاط السعودي، مما طرح فكرة أن تجتاز فارس الأراضي العراقية العثمانية لمعاقبة السعوديين. وقد حذر السفير العثماني في فارس حكومته حول هذا الشأن، بعد أن توقع أن الشاه سوف يهاجم السعوديين بعد العودة من خراسان. وقد أكد هذا حشد واستنفار جميع قواته. بالإضافة إلى أنه بعث رسالة تهديد إلى الإمام عبد العزيز بأن «سنابك خيل فرسانه سوف تذرو تراب الدرعية في فصل الشتاء».
أما المشكلة الثانية، فتكمن في معاناة سليمان باشا، والي بغداد، من عدم قدرته على توقع تحركات الإمام عبد العزيز المستقبلية وازدياد نفوذه، الذي كان يرحب بفكرة قضاء الفرس عليه، ولكنه يعارض عبور الفرس من خلال الأراضي العراقية. ورغم ذلك، اجتهد سليمان باشا والي بغداد في إرضاء الشاه الفارسي عن طريق تجريد حملة على الدرعية في عام 1802، غير أنها فشلت كسابقاتها. في تلك الأثناء تلقى سليمان باشا والي بغداد رسالة من الشاه الفارسي مليئة بالتوبيخ، عبر له فيها عن سخطه من فشل الحملة في القضاء على نفوذ الدرعية، وهدده بأنه سيتولى بنفسه إرسال جيش عرمرم لإبادة السعوديين. ورغم محاولة والي بغداد الاعتذار للشاه الفارسي، ووعده بمتابعة النشاط السعودي بحزم، فإن تلك التطمينات لم تلق أي أثر لدى الشاه الفارسي. في وقت كان فيه الإمام عبد العزيز يواظب على مواصلة مخططه الطموح في طرد العثمانيين من الأراضي العربية والقضاء على النفوذ الفارسي في العراق. وقد انعكست تلك الهزيمة على مكانة سليمان باشا، والي بغداد، مما أدى إلى اعتلال صحته ووفاته في 1802.
في هذا الإطار، ذكر القنصل البريطاني في بغداد في تقريره عام 1803 أنه «من غير المتوقع أن يستطيعوا مجابهة القوات السعودية التي يقدر عددها بمائة ألف مقاتل يحملون السيوف، ويرون أن الموت في سبيل قضيتهم هو الشهادة التي يتطلعون لها، لهذا فإن فكرة إخضاعهم أمر مستبعد ولم يشهد التاريخ بإمكانية حدوثه». وقد أيده في الرأي السفير الفرنسي في بغداد في تقريره عام 1804، حين ذكر أنه «في حال استمرار الشاه الفارسي ووالي بغداد بعدم التحرك لعقد الصلح مع السعوديين واتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح طموحهم وجرأتهم، فمن المؤكد أنهم لن يبقوا طويلاً دون جلب المتاعب والخراب للعثمانيين والفرس في مناطق نفوذهم»، وأنه «من الصعب التعامل مع هذه الطائفة التي تزدري الموت بما يكفي للذهاب لمواجهته».
أما علي باشا، والي بغداد الجديد، فقد بعث بتقارير للسلطان سليم الثالث تؤكد أن استمرار امتداد نفوذ الإمام السعودي قد أثار غضب الفرس، وأدى إلى اضطراب مزاجهم. لهذا كان من الضروري تهدئة روعهم قبل اتخاذهم أي إجراء يمس مصالح الدولة العثمانية. ونتيجة لعدم جدوى تلك الإجراءات الدفاعية ضد المد السعودي، نصح علي باشا والي بغداد بأهمية وضرورة معرفة مخططات الإمام السعودي وفتح باب الحوار مع الدرعية. وبعد لقاء المبعوث العثماني بالأمير سعود وسؤاله عن سبب هجومه، رد الأمير «أنهم ضاقوا ذرعاً بتعديات والي بغداد وحملاته التي لا تتوقف ضد الدرعية، وحصار الأحساء، وأخيراً مقتل التجار النجديين»، مؤكداً أن «الاستيلاء على بغداد أمرٌ يسير، ولكن لعدم إيصال الكدر لقلب السلطان، صرفنا النظر عن ذلك، واكتفينا بما قمنا به».
وأردف قائلاً: «لو كان السلطان يعلم أحوال العجم وتصرفهم هذا لاستحسن فعلنا هذا معهم، وإذا خطر على بال السلطان أن العجم من الممكن أن يتعرضوا على الممالك السلطانية، فأنا أتكفل بمساعدة الدولة العلية في دفع ضرر العجم دون طلب مني».
وقد حمل ذلك التصريح شيئاً من التهكم بمدى سهولة الاستيلاء على بغداد، والقوة التي تؤهل الإمام السعودي لمساعدة السلطان العثماني في الدفاع عن أراضيه ضد الفرس. كما كشف عن ازدواجية السياسة السعودية، التي طردت العثمانيين من مكة المكرمة ومستمرة في مهاجمة القوات العثمانية في أرجاء الجزيرة العربية والشام، وتعرض في الوقت نفسه تقديم المساعدة لهم ضد الفرس، مما يوضح موقفها من النفوذ الفارسي في الأراضي العربية.
استمرت الهجمات السعودية على الحدود العراقية مثل البصرة والحلة، التي زادت مخاوف علي باشا والي بغداد بأنه في حال استمرارها، لن تستطيع القوات العثمانية الموجودة في تلك الأماكن الصمود والحفاظ عليها أمام هجمات السعوديين الشرسة، مما قد يزيد من اضطراب الأمن في العراق. وتم إبلاغ السلطات العثمانية بضرورة التحرك السريع لحماية العراق ومناطق النفوذ الفارسي، مما يوضح أن الهجمات السعودية تحولت إلى صراع سعودي فارسي عثماني في الأراضي العراقية.
وقد زاد الأمر تعقيداً ما حمله تقرير علي باشا والي بغداد للسلطان العثماني، الذي أكد أن الإمام السعودي أصبح من القوة والمكانة ما يدفع الشاه الفارسي للتفكير قبل التحرك نحو السعوديين، الذين يمثلون خطراً حقيقياً يهدد جميع الولايات العربية العثمانية وفارس.

وظلت الأزمة السعودية الفارسية لسنوات طويلة مصدر قلق وإرباك للسلطات العثمانية، ولم يتجرأ الشاه الفارسي على تنفيذ تهديداته للسعوديين أو التقدم خطوة واحدة باتجاه الأراضي السعودية، لإدراكه التام أنه في حال دخل في مواجهة مع الإمام السعودي سيعرض أراضيه للخطر، وستنتقل العمليات السعودية إلى عقر داره. مما دفعه إلى تجنب مواجهته في عداء مباشر، ورغم الانتصارات التي حققها السعوديون، لم يتجاهل الإمام سعود أن يدي علي باشا والي بغداد ما زالت ملطخة بدماء والده. لهذا كان أول ما قام به بعد اغتيال والده هو إرسال قوات إلى المناطق القريبة من مدينة النجف في عام 1803، كرسالة لعلي باشا والي بغداد بأن غياب والده عن الساحة السياسية لن يوقف المخطط السعودي الذي يهدف للقضاء على النفوذ الأجنبي في الأراضي العربية. وكشف العرض الذي قدمه الإمام سعود لعلي باشا والي بغداد مرة أخرى ازدواجية السياسة السعودية مع العثمانيين بهدف ضرب النفوذ الفارسي في الأراضي العربية، حين عرض عليه الدخول تحت النفوذ السعودي مقابل تزويده بمائتي ألف مقاتل مجهزين بالعتاد ليكونوا تحت إمرته لحرب الفرس. وظلت الأزمة السعودية الفارسية تتسم بعدم التوافق على مر العصور، وعلامة بارزة في مسار العلاقات السعودية الفارسية.
انطلاق سعودي نحو الشام لطرد المحتل
كيف تصفين انطلاقة النشاط السعودي تجاه بلاد الشام؟
تلقى السلطان العثماني العديد من التحذيرات بشأن النفوذ السعودي، منها ما ذكره سليمان باشا والي بغداد: «أنه مما لا شك فيه أن إهمال أمر الإمام السعودي سيجعل الأمر أكثر تعقيداً وخطراً من سقوط مصر في يد الفرنسيين»، وقد أكد ذلك ما ذكره الصدر الأعظم من أن «طموحه لا يقتصر على حدود الجزيرة العربية بل سيتجاوزها حتى الشام وحلب».
في تلك الأثناء، كانت الشام إحدى هذه الولايات العربية منذ سقوطها على يد السلطان سليم الأول عام 1516، التي عانت كسائر الولايات العربية من فساد الحكم العثماني، زد على ذلك انقسام الجيش في كل ولايات الشام. فحلب كانت تعاني من النزاع بين الإنكشارية والقوات المحلية، وفي دمشق كان النزاع مستمراً بين جنود السلطنة والجند المحلية، وصيدا كانت في صراع مع دروز جبل لبنان. فالدولة العثمانية لم تختلف عن باقي الدول المستعمرة التي تسعى لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية التي تخدم مصالحها، دون الالتفات لما يتعرض له سكان تلك البلاد.
في عام 1794، بدأ الإمام عبد العزيز بن محمد بالتطلع لانطلاق نشاطه العسكري نحو الولايات العثمانية في الشام، لمعرفة رد الفعل العثماني ومدى جاهزية ولاته لمواجهته، خاصة بعد وصول نفوذه إلى حدودها.
وخلال الأربع سنوات التي تلت ذلك التحرك، لم تكشف لنا المصادر التاريخية أي معلومات دقيقة حول النشاط السعودي في الشام حتى عام 1797، عندما أرسل الإمام عبد العزيز قوة نحو بوادي الشام. ويبدو أن هذا التحرك كان له تأثير على بعض القبائل التي كانت تتجول في المنطقة، فأقبلت على الدخول تحت نفوذه. ولم تشر المصادر المعاصرة لتلك الحقبة إلى موقف والي دمشق. وقد زاد الصراع بين الولاة والأهالي من الفوضى التي عجلت بانضمام مزيد من قبائل بادية الشام، التي فضلت الانضواء تحت لواء الإمام السعودي، بعد أن أدركت أن اعتماده على الشريعة الإسلامية هو الخلاص الوحيد لها من فساد حكم الولاة العثمانيين. ويمكن تقدير مدى انتشار النفوذ السعودي من ظهور عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية، يحملون زكاة بوادي أهل الشام، مما يؤكد دخول تلك القبائل تحت النفوذ السعودي.
القبائل الشامية ترفض التمرد على السعوديين
كيف كان رد فعل السلطان العثماني وولاته بالشام في مواجهة المد السعودي؟
بعد فشل ولاة بغداد بتحقيق رغبة السلطان سليم الثالث بالتصدي للمد السعودي، التفت إلى والي الشام علّه يجد فيه بغيته. في وقت كانت فيه الفوضى تعم الشام، مما ترتب عليه تعيين عبد الله العظم للمرة الثانية والياً على الشام عام 1799، الذي بعث بخطابات من السلطان سليم الثالث إلى مشايخ قبيلة عنزة وعربانها القاطنين في الشام وحماة وحمص، ومشايخ قبيلة صخر القاطنة في الزرقاء المؤيدين للسعوديين، يدعوهم فيها للتمرد على الإمام السعودي بعد انضمام أعداد كبيرة منهم لقواته. إلا أن معظم القبائل الشامية التي انضمت له رفضت الانصياع لأوامر السلطان العثماني لحرب السعوديين في الحرمين الشريفين. وقد وجد والي الشام أن استخدام القوة سيعيدها للطاعة، بعد فشل محاولة إغرائها بالمال لتمسكها بولائها للإمام السعودي.
في الوقت الذي كانت فيه الفتن والاضطرابات تعم الشام، كان الإمام عبد العزيز وابنه سعود يواصلان نشاطهما نحو القبائل الشامية. وأفادت التقارير العثمانية بأن الإمام السعودي «يملك أعداداً مهولةً من المقاتلين ومعظم العرب قد اتبعته». مما نتج عنه عقد السلطان اجتماعاً مع أركان الدولة في عام 1803، وتمخضت المباحثات عن أن أحمد جزار باشا من سيتولى ولاية الشام لمواجهة السعوديين وحماية الحرمين الشريفين بعد فشل عبد الله باشا العظم في الحد من النفوذ السعودي.
إلا أن جزار باشا كان يدرك جيداً أنه لا قبل له بذلك، فأخذ يسلك مسلك من سبقه بالمماطلة رغم انتصاراته في مواجهة الفرنسيين في عكا، لتخوفه من مواجهة الإمام السعودي. وجاء موته دافعاً لبدء البحث عن والي جديد قد ينجح في تحقيق حلم السلطان بمواجهة النفوذ السعودي.
اعتقد السلطان العثماني أنه وجد ضالته في صالح بك الذي ولاه حكم الشام، بعد أن عقد عليه الآمال في محاربة الإمام سعود الذي استمرت قوته بالتنامي بشكل غير مسبوق. ولكن الأحداث أثبتت له أن ولاته أكثر جبناً من التحرك نحو السعوديين. لهذا سارع صالح بك بمجرد تعيينه إلى بث الطمأنينة في نفس السلطان سليم الثالث المضطربة بعد ضياع الحرمين الشريفين من أيدي الدولة العثمانية، لعدم اتخاذه أي إجراء حقيقي يرقى لطموح السلطان سليم الثالث، الذي سأم من مراسلاته وتقاريره، وأدرك أن صالح بك لم يكن أفضل حالاً منهم، ولهذا تم عزله فلحق بمن سبقه.
جاء تولي عبد الله باشا العظم ولايته الثالثة والأخيرة على الشام في عام 1805، ولم يفتتح عهده بما هو جديد، بل سارع كأسلافه بإرسال التقارير مؤكداً استعداده لتنفيذ أوامر السلطان سليم الثالث لحرب السعوديين وحماية الحرمين الشريفين. وقد جاء الخطاب الذي أرسله عبد الله باشا العظم ليثلج صدر السلطان بعد إعلان خروجه مع الحجاج الشاميين، فتحرك في 19 يناير (كانون الثاني) 1806، إلا أن عدم مواجهته لجيش الإمام السعودي في المدينة المنورة كان سبباً في إثارة غضب السلطان العثماني منه. وجاءت محاولته الثانية في العام التالي 1807، ولكنها لم تكن أفضل من سابقتها؛ فقد كان انصياعه لأوامر الإمام سعود والعودة أدراجه مخالفاً بذلك أوامر السلطان العثماني، قد أدى إلى عزله وتعيين يوسف كنج، الذي كان يدرك صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه. لهذا سارع بمجرد توليه حكم الشام بكتابة التقارير، في محاولة لكسب ثقة السلطان سليم الثالث وتأكيد ولائه وطاعته للأوامر الصادرة إليه بشأن القضاء على النفوذ السعودي، إلا أن ذلك لم يحد من ازدياده في بلاد الشام حتى أصبح لهم دعاة داخل بعض المدن والقرى الشامية.
جاء أول اتصال رسمي من والي الشام يوسف كنج باشا عام 1807، بالإمام السعودي، رغم الأوامر التي صدرت له من السلطان العثماني بالتحرك لمحاربته، ولكنه لم يجرؤ على معاداته، بل مال إلى مهادنته من خلال الاعتراف الصريح بسيادة الإمام سعود على الحرمين الشريفين. وقد دل على ذلك خطاب التوصية الذي بعث به لطلب الإذن بأداء مناسك الحج لبعض سكان الشام وحمايتهم.
إلا أن تلبية الإمام سعود لطلبه لم تنسه الشام وأهله، ولم تكن عائقاً لإرسال الإمام خطاباً تحذيرياً له من مغبة مقاومته، كما أرسل إلى شيوخ القبائل الشامية التي لم تنضم له بعد يدعوهم إلى الدخول تحت لوائه، عن طريق توزيع المنشورات بين سكان الشام وقبائله، يوضح فيها مشروعه ومعتقده ويدعوهم لمحاربة العثمانيين.
أما يوسف باشا كنج فقد تعامل مع خطاب الإمام سعود بشيء من الحدة، فأرسل محذراً إياه من مغبة الاقتراب من ولايته. فما كان من الإمام سعود إلا أن رد عليه بخطاب شديد اللهجة، يحذر فيه يوسف باشا والدولة العثمانية قائلاً: «من أشد منا قوة»، وأنه في حال عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية وإنصاف المظلومين، فليس لديه إلا السيف. ودعا إخوته من أهل الشام للمحافظة على التمسك بالشريعة الإسلامية، وإعلان الجهاد ضد العثمانيين.
زادت مخاوف السلطات العثمانية بعد الخطاب الذي أرسله يوسف باشا كنج والي الشام إلى السلطان العثماني في يوليو (تموز) 1810، الذي ذكر أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن الإمام السعودي خرج من الدرعية نحو الشام. وزاد الأمر سوءاً تأكيد تلك المعلومات من مصادر مختلفة بأن «الإمام سعود لديه مخططات جادة للقضاء على النفوذ العثماني في الشام ونواحيه، وأنه بصدد دخول الشام»، ومواجهة يوسف كنج غير مكترث بتهديدات والي الشام والدولة العثمانية.
ورغم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته في الشام عن طريق إرسال قوات مجهزة بالعتاد والمدافع إلى قلعة مزيرب وحوران، وتسيير حملات استطلاعية على أطراف ولاية الشام، واتخاذ الإجراءات اللازمة في اللاذقية وطرابلس وحماة وحمص والقدس بتزويدها بأعداد كبيرة من الجنود، ونشر العيون لتقصي تحركات السعوديين، فإن ذلك لم يعرقل التقدم السعودي الذي أعطت السجلات البريطانية تفصيلات أكبر عنه، حيث ذكرت أن الإمام سعود وصل إلى حوران، التي تبعد عن دمشق يومين، بعد أن دخل 35 قرية في غضون ثلاثة أيام دون أن يتحرك يوسف باشا للدفاع عن مناطقه أو حتى إنذار تلك القرى بقرب تقدم القوات السعودية إليها. وقد أكدت السجلات البريطانية أن الإمام سعود كان رحيماً، فحافظ على حياة الفلاحين الشاميين، وكان في قدرته إسقاط دمشق لو أنه أدرك مدى الرعب الذي أثاره تقدمه، لكن مخطط الإمام السعودي كان يقتضي إرهاق القوات العثمانية بالهجمات المفاجئة المتكررة حتى يعلن ولاة دمشق استسلامهم. ولذلك عاد أدراجه، بعد أن فشلت القوات العثمانية التي أعدها كل من يوسف كنج وسليمان باشا والي إيالة صيدا في مجابهة القوات السعودية.
عندها أدرك السلطان محمود الثاني أن يوسف كنج ضيّع الفرصة وترك الشام التي يحكمها مفتوحة أمام السعوديين، ولم يتخذ من الاحتياطات إلا القليل، وأنه ليس الرجل القادر على القضاء على الدرعية، وليس أفضل من ولاة بغداد بعد أن فشل كل منهم في حماية حدود ولايته من التقدم السعودي. ولذا أمر بعزله، وتوجيه إيالة الشام إلى سليمان باشا، وطلب إليه السلطان محمود الثاني الاتصال بمحمد علي باشا والي مصر لتنسيق جهودهما للقضاء على النفوذ السعودي.
أشار تقرير سليمان باشا والي الشام إلى أنه يواجه مشكلة بسبب تبعية القبائل من المدينة المنورة وحتى باب الشام للإمام السعودي، وأن إرجاعهم عن تبعيتهم إلى العهد السابق يقتضي تقريب بعضها بتطيب خاطرها، وتكدير بعضها الآخر، حتى يتم استجلابها جميعاً. ولم يطل الوقت بالسلطان سليم الثالث حتى تكشف له أن خوف ولاته من مواجهة القوة السعودية قد تأصل فيهم وأصبح ديدنهم.
تكتيك سعودي بارع يفتح جهات متعددة
كيف تعاملت الدولة العثمانية بعد إدراكها قوة السعوديين وإصرارهم على القضاء على نفوذها في الشام؟
استمر ولاة الدولة العثمانية في الشام والعراق يتتبعون عن كثب النشاط السعودي بعد أن استشعروا خطره الذي يُمكن أن يصل إلى ولاياتهم، دون عمل أي إجراء حقيقي يرقى لقوة السعوديين أو لطموح السلطان العثماني.
تزامن ذلك مع إدراك السلطات العثمانية أنه لم يعد في مقدور ولاتها في بغداد أو الشام الوقوف في وجه النشاط السعودي، وزاد الأمر سوء انتزاع الحرمين الشريفين منها، عندها أدركت أنها تواجه السعوديين في ثلاث ولايات عربية، مما يعكس التكتيك العسكري للأئمة السعوديين الذي يعتمد على فتح جبهات متعددة في الوقت ذاته.
وفي عام 1811، ورغم الوضع الحرج الذي تمر فيه الدولة السعودية بعد وصول الحملة المصرية وانشغالها بمجابهة طوسون باشا، فإنه بمجرد توقيع الهدنة معه عام 1815، سارع الإمام عبد الله بن سعود بالتحرك من جديد لتخليص الشام استكمالاً لمشروع من سبقه من الأئمة بهدف تخليص الولايات العربية من الاستعمار العثماني، مما يوضح مدى أهمية القطر الشامي للأئمة السعوديين، حيث أكدت الوثائق العثمانية تجول قوات الإمام عبد الله بن سعود في صحراء بغداد، وجمع قرابة أربعين ألف مقاتل، واتجهوا نحو الحدود الشرقية من حماة في الشام بعد أن تجولوا في تلك المناطق ونجحوا في إدخال القبائل تحت سلطة الإمام عبد الله.
وعندما وصلت تلك الأخبار إلى والي الشام سليمان باشا، بادر بإرسال مدير أعماله إبراهيم باشا يقود قوة قوامها اثنا عشر ألف جندي، وعدد من المدافع، وعدد كبير من العتاد الحربي لمهاجمتهم. وبعد وصولهم إلى حماة، كانت القوات السعودية قد نصبت معسكرها على مسافة ثلاث ساعات منها، وحدثت معركة في يوم 21 مايو (أيار) 1815، قاوم فيها المقاتلون السعوديون، وتجولوا بعدها في الصحراء حتى وصلوا حدود حلب في تل السلطان، وأقاموا معسكرهم. وحين بلغت تلك الأخبار السلطان سليم الثالث، أمر والي حلب بمهاجمتهم. ومما لا شك فيه أن الحملة الشرسة التي أعدها محمد علي باشا والي مصر بقيادة ابنه إبراهيم باشا عام 1816 بهدف إسقاط الدرعية، قد أحبطت مخططات السعوديين في تخليص الشام والولايات العربية وطرد العثمانيين، بعد أن أصبح السعوديون خطراً حقيقياً يهدد نفوذهم في المنطقة العربية، بل في آسيا. وقد أكد ذلك ما ذكرته السجلات البريطانية بأنه بعد الإطاحة بآخر أئمة الدولة السعودية الأولى «تم القضاء على سلطة وحكومة هذه الدولة الفريدة من نوعها، التي بعد أن كانت ضعيفة وهزيلة، وصلت في وقت من الأوقات لدرجة من القوة مكنتها من بث أعلى درجات الرعب والذعر في نفوس الباشوات الأتراك في جميع أنحاء آسيا، بل بثت الرعب في نفس السلطان في القسطنطينية».