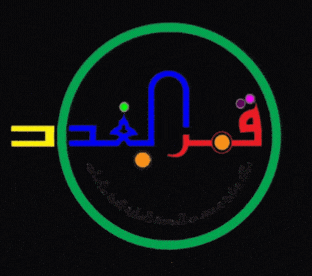في عالمٍ حيث تتقاطع المعلومة مع الشائعة، وتتسابق فيه الأخبار الحقيقية مع الأكاذيب المصنوعة، باتت مسؤولية المتلقي لا تقل أهمية عن مسؤولية من يكتب أو ينشر.
ولعل من أخطر أدوات التضليل التي تسللت إلى وعينا الجمعي هي الأحاديث المفبركة المنسوبة زوراً لشخصيات عامة، سياسيين، مفكرين، علماء، أطباء، أو حتى أنبياء ورسل.
أحاديث تُروَّج بأسلوب درامي، يُطعّم أحياناً ببعض الحقائق ليُكسب الكذب شرعية، وتُقدَّم للناس كحقائق دامغة، بينما هي في حقيقتها لا تعدو كونها نتاج خيال كاتب مغمور أو أجندة خفية.
صناعة الأحاديث والأخبار الملفقة ليست جديدة، لكنها اليوم أكثر خطورة. كانت الأكاذيب في الماضي تنتقل شفهياً، ويكفي أن يشكك فيها واحد من أهل العقل لتسقط.
أما اليوم، فالأكاذيب تنتقل بصور احترافية وصيغ لغوية ساحرة، ومقاطع فيديو مزيفة تُظهر ما لم يحدث، أو تُقطّع ما حدث لتغير معناه.
والأنكى من ذلك أن هذه الأحاديث لا تقتصر على المعلومات السياسية، بل تمتد لتطال الدين والتاريخ والهوية والثقافة، لتصبح أداة غسيل دماغ جماعي، أو تحريضاً طائفياً، أو سلاحاً ناعماً في الحروب النفسية.
تُفبرك هذه الأحاديث لأغراض متعددة، منها التضليل، والتحريض، وكسب التعاطف، وتشويه الخصوم، أو حتى الترويج لفكرة معينة من خلال استغلال رمزية شخصية مشهورة.
فحين يُنسب كلام خطير إلى رئيسٍ دولة عظمى، أو حكيم ديني، أو زعيم روحي، أو عالم، أو طبيب، فإن وقعه يتضاعف، وفرص تصديقه تزداد، فينساق الناس وراءه دون تفكير، ويعاد تدوير الأكذوبة إلى ما لا نهاية.
صحيح أنه ليس كل الناس علماء أو باحثين، لكننا جميعاً قادرون على كشف هذه الأحاديث والأخبار المفبركة، والتحقق منها إذا توفرت لدينا أدوات بسيطة، مثل التحرّي عن مصدر الحديث أو الخبر، وما إذا كان تم نُشرهما في وسيلة إعلامية معروفة وموثوقة، وهل هناك تسجيل صوتي أو فيديو، أم هو مجرد نص عائم مجهول النسب.
كما يمكننا التحقق من الأسلوب، وما إذا كان النصُ يعكس أسلوبَ الشخصية المنسوب لها الحديث، وهل يحتوي على تحليل لا يتطابق مع طريقة كلامها المعروفة.
وعلينا أيضاً المقارنة مع الواقع، وما إذا كان يتوافق مضمون الحديث أو الخبر مع الوقائع الحقيقية، وهل يحتويان على مبالغات واضحة أو معلومات خاطئة تاريخياً، وذلك عن طريق استخدام أدوات التحقق، مثل مواقع كشف الشائعات، ومحركات البحث التي تستطيع كشف الحديث والخبر المفبركين خلال ثوانٍ. وسأضرب على ذلك مثالاً.
في الأيام الأخيرة، تناقلت المنصات نصّاً مطوّلاً يُنسب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلاً عن محطة فضائية عربية شهيرة، نُسجت فيه خيوط المؤامرة بإتقان، وصيغ بأسلوب يجمع بين الفلسفة والتاريخ والتحليل السياسي، حتى ليظن القارئ للوهلة الأولى أن الرجل انقلب فجأة إلى مؤرخ وفيلسوف، يُحدثنا عن الثورة الفرنسية، ونهاية الميثولوجيا، وأفول القيم الدينية، وبداية النظام العالمي الجديد.
وقد تحمس البعض لنشر هذا الحديث وتوزيعه «للفائدة والتبصر» كما جاء في الرسالة المنتشرة.
عندما نخضع هذا الحديث لقواعد التحقق التي ذكرتها نجده غير صحيح، ولم يصدر عن ترامب أو عن أية جهة رسمية بهذا الشكل أو المضمون.
فهو من حيث اللغة والأسلوب لا يتوافق مع لغة وأسلوب ترامب الذي لم يستخدم يوماً هذا النوع من التحليل التاريخي العميق والممنهج.
كما غابت المصادر عن الحديث، واتضح بعد البحث أنه نصٌّ متداولٌ منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم نسبته في كل مرةٍ إلى إحدى الشخصيات، دون مصدرٍ موثوقٍ أو تسجيلٍ أو رابطٍ لجهة إعلامية معتمدة تؤكده.
الخطورة لا تكمن في الكذبة ذاتها، بل في سهولة تصديقها. فحين تغيب أدوات التحقق، وتنتفي ثقافة السؤال، يتحوّل كل ما يُقال إلى يقين، ويصبح المتلقي شريكاً، دون أن يدري، في نشر الزيف وتغذية الوعي المشوّش.
لا أقول هذا دفاعاً عن ترامب أو غيره، ولكن لأننا في زمن لا يكفي أن نكون مستقبِلين للمعلومة، بل يجب أن نكون مُدققين، فالكلمة لم تعد مجرد جملة تُقرأ وتُنسى، بل غدت أداةً لتوجيه العقول وتغيير المسارات.
ولعل أعظم ما يمكن أن نقدمه في هذا الزمن ليس مشاركة الأخبار، بل التأكد من صحتها قبل نشرها، ففي زمن الفوضى، تصبح صناعة التضليل منجماً للفتن.