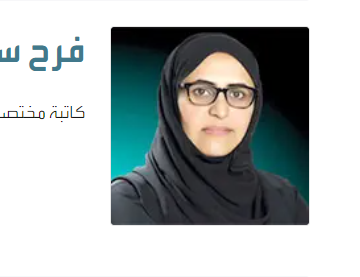حميد الكفائي
لدينا ميل في العالم العربي نحو التشدد في فرض الأمن وتطبيق القوانين، ويصدر قضاتنا أقسى الأحكام بحق المسيئين والمجرمين، وعادة ما تختار الحكومات وزيراً عسكرياً صارماً أو مدنياً متشدداً للداخلية، متوهمة بأن التشدد والصرامة ضروريان لحفظ الأمن وردع المتجاوزين ودفع الناس إلى احترام القانون والنظام. لكن الحقيقة مختلفة تماماً، فالتشدد والتعسف في التعامل مع الناس يدفعانهم إلى القسوة وممارسة العنف والجنوح نحو الجريمة، لذلك من الضروري أن يضطلع خبراء في الثقافة وعلوم النفس والاجتماع والقانون بإدارة الأمن والقضاء، لأن بإمكان هؤلاء الخبراء أن يقدروا تأثيرات الأحكام القضائية وممارسات أفراد الشرطة والأمن على مستقبل المجتمع.
قد يلتزم أكثر الناس بالنظام خشية من القسوة التي تمارسها السلطة معهم، ولكن القسوة، إن أصبحت مألوفة، تتحول إلى ثقافة يورثها الآباء إلى الأبناء ويصعب حينها خلق مجتمع سلمي ملتزم بالقانون ومتصالح مع نفسه. وعندما تسود القسوة في المجتمع فإنها تولد مزيداً من الجرائم والفظائع التي تستدعي مزيداً من القسوة المعاكسة ما يحول المجتمع إلى بيئة قلقة متشنجة يحكمها العنف والتعسف.
في العراق مثلاً، أصبح ارتكاب الجرائم البشعة أمراً عادياً بسبب تعرض المجتمع للقسوة والعنف والإرهاب والخداع لعقود طويلة. والمزعج أن معظم مرتكبي هذه الجرائم شبان بعمر الزهور كان يفترض أن ينشغلوا بالدراسة والرياضة والموسيقى والفنون. ومن المتوقع أن تؤثر أعمال العنف الجارية حالياً في سورية واليمن وليبيا ومصر على ثقافة الأجيال المقبلة، وتجعلها أكثر ميلاً إلى العنف والقسوة والتعسف، إن لم تكن هناك حلول ثقافية واجتماعية ناجعة.
المجتمعات الحديثة تحتاج لأن تكون متسامحة ورحيمة حتى مع المجرمين، ليس من أجلهم ولكن من أجل ترسيخ مبادئ الرحمة والتسامح التي تقلص العنف والجريمة، وتنمّي الضمير عند الإنسان، خصوصاً بين الشباب الذين سيقومون مستقبلاً بإدارة المجتمع. كثيرون ينتقدون الأحكام «المتساهلة» التي يصدرها القضاة في المجتمعات الغربية على المجرمين، إلا أن هذه الأحكام، وإن بدت متساهلة، إلا أنها ترسخ مبادئ التسامح والتعايش وتؤسس لمجتمع رحيم متكافل يقيم وزناً أكبراً لقيم الحرية والسلم وقبول الآخر بدلاً من الاستبداد والثأر والعنف.
عندما تولى حزب العمال بقيادة هارولد ويلسون السلطة في بريطانيا عام 1964 اختار روي جنكِنز، خريج جامعة أكسفورد وأحد دعاة التسامح والمدنية والعالمية، وزيراً للداخلية، وقد أرسى جنكنز عبر عمله في وزارة الداخلية دعائم ما سماه بـ «المجتمع المتحضر» وأوقف العمل بالممارسات والقوانين الصارمة السابقة، بما فيها حكم الإعدام الذي كان نافذاً حينها. وبعد أن أصلح وزارة الداخلية، انتقل جنكِنز إلى وزارة المالية كي يعزز تماسك المجتمع عبر دعم الضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية والنظام الصحي، الذي كان يعتبر الأكفأ والأقل كلفة في العالم، إذ يغطي جميع المواطنين والمقيمين من دون استثناء، بينما يكلف 7 في المئة فقط من نسبة الإنفاق الحكومي، خصوصاً إذا ما قورن بأفضل نظام صحي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها وهو «أوباماكير» الذي يكلف 51 في المئة ولا يشمل كل المواطنين.
لقد أرسى جنكِنز مبادئ التسامح والرحمة في المجتمع البريطاني وألغى العسكرة ومنع الشرطة من حمل السلاح، كي لا يصبح منظر السلاح مألوفاً، وعزز حرية المواطنين بينما تمكن من خفض معدل الجريمة، مع انحسار العنف تدريجياً. انتقل جنكِنز بعد ذلك إلى رئاسة المفوضية الأوروبية وعمل على توحيد أوروبا وعلى الحد من الفوارق والتفاوت الاقتصادي بين دولها المختلفة. لقد تمكن شخص واحد من أن يحقق كل هذه الإنجازات لأنه وُضع في المكان المناسب.
في عالمنا العربي نحتاج أن يشغل وزارات الداخلية أشخاص من مستوى روي جنكِنز، يمتلكون العلم والخبرة الكافيين في سلوك الأفراد والمجتمعات والثقافة والقانون، بالإضافة إلى الرؤية البعيدة الأمد لبناء مجتمعات متسامحة متصالحة متكافلة ومنتجة.
ما زال الاهتمام في مجتمعاتنا يتركز في الغالب على الوعظ والقسوة والثأر وتطبيق مبادئ «السن بالسن والعين بالعين»، أو مبدأ «سبعة بسبعة» الذي أسسته في العراق حنان الفتلاوي من أجل الفوز بأصوات البسطاء في الانتخابات! والأخطر أن هذا التشدد يُمارس فقط مع الناس العاديين، أما المرتبطون بمراكز القوى فهم يفعلون ما يشاؤون من دون وزاع أو رادع.
كثيرا ما يتحدث المسؤولون العراقيون عن محاربة الفساد، لكن معظمهم يمارس الفساد علنا فيعيّن أتباعه وأقاربه في وظائف الدولة ويمنح عقود الإعمار والخدمات لمن يقدم له نسبة محددة من قيمتها. إضافة إلى ذلك فإن المجرمين والفاسدين المرتبطين ببعض المسؤولين لم يحاسبوا، وأكثر ما يحصل لهم أنهم يهربون إلى دول مجاورة وتنتهي القضية. لم نسمع أن حوكم سارقو المصارف أو مهربو العملة أو متعاطو الرشوة، علماً أن بعضهم ارتكب جرائم قتل أيضاً، ولم يحاسب أعضاء عصابات الخطف والابتزاز، علما أن أحداها كانت بقيادة أحد أقارب المسؤولين الكبار، الذي ربما سهَّل هروبهم إلى دولة مجاورة! وقد سرق أخ احد المسؤولين مبلغاً كبيراً من المال العام الذي كان بعهدته وهرب، ولم يحاسبه أحد، بل أعلن أخوه المسؤول بأنه سوف يُشمل بالعفو عن المجرمين! لم يُلاحَق مئاتُ المسؤولين المتهمين بالفساد، بل ألغيت التهم الموجهة إليهم بسهولة في صفقات مشبوهة.
مثل هذا التمييز بين المجرمين يترك آثاراً وخيمة على ثقافة المجتمع ويجعل أفراده يحتقرون القانون والدولة ويطعنونها في الخلف في أول فرصة.
قوانيننا تركز دائماً على الماضي وتنسى المستقبل. نعم يجب إنزال العقوبة المناسبة بالمجرم، ويجب أن يؤخذ الحق من المعتدي ويعاد لأصحابه، ولكن يجب دراسة تأثيرات الأحكام والممارسات السلطوية على مستقبل المجتمع والدولة والاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى. فعندما يحاسب الإنسان العادي وتنزل به أشد العقوبات بينما يفلت المسؤولون الكبار وأتباعهم من العقاب، سوف يشعر المواطنون بالظلم وعندها لن يحترموا القوانين بل سيخالفونها ويستهينون بها. يجب أن يكون المستقبل حاضراً دائماً أثناء تطبيق الأحكام القضائية وأوامر السلطات الحكومية، وهذا لا يمكن أن يحصل من دون وجود خبراء في مراكز القرار الأمني والقضائي، ليس في القانون فحسب، بل في الثقافة وعلوم الاجتماع والنفس والسلوك. عندها فقط سوف نرسي دعائم العدالة والأمن والاستقرار.