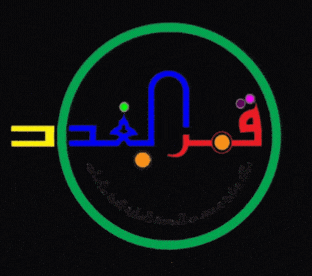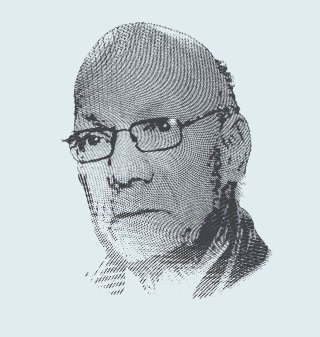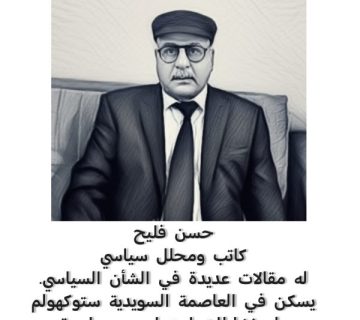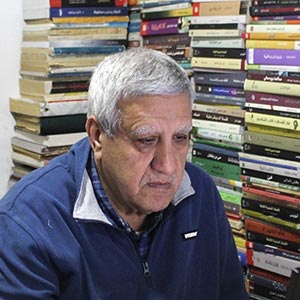الآن، لم يعد الخطأ في اللغة مجرد خطأ مكشوف يعلن عن نفسه، ويستطيع الجمهور القارئ أو المستمع أن يدركه بنفسه لأنه تعلّم اللغة جيداً كما كان يحدث من قبل، وأصبح قادراً على اكتشاف الخطأ الذي لم يعد اكتشافه يحتاج إلى علم واسع؛ لأن لغة العصر التي تعبر عن الواقع وتسعى للوصول إلى أوسع جمهور أكثر مما تسعى لاستعراض القدرة أصبحت متاحة للملايين الذين تحرروا من الأمية بعد أن صار التعليم حقاً للجميع، ولم يعد الفرق بين الكاتب وقرائه فرقاً في معرفة اللغة، وإنما أصبح هذا الفرق فيما يملكه الكاتب من موهبة أو معرفة يستطيع أن يقدمها لقرائه الذين يملكون من ناحيتهم أن يتجاوزوا مستوى الفهم إلى مستوى التذوق والتقييم والحكم على ما وصل إليه الكاتب من نجاح في عمله، سواء كان هذا العمل أدباً أو علماً أو مقالات صحافية.
وأنا هنا أتحدث عن اللغة التي كنا نقرأها قبل خمسين أو ستين عاماً، وعن الذين كانوا يكتبونها، والذين كانوا يقرأونها. وقد انتقلنا في هذه العقود الأخيرة إلى واقع آخر تراجع فيه التعليم ومستوى المعلمين، ومستوى المتعلمين بالضرورة، وهو المستوى الذي نشكو منه الآن ونحتاج إلى النظر فيه ومراجعته، والبحث عن الأسباب التي أدت إليه، وعن الطرق والوسائل التي تمكننا من تجاوزه والعودة بلغتنا الفصحى إلى المستوى الذي بلغناه من قبل، وكنا نأمل أن نتجاوزه إلى مستوى أفضل نزوّد فيه لغتنا بالطاقات ونطعّمها بالأدوات والقدرات التي تمكنها من مغالبة اللهجات العامية التي لم تعد تتسلل إليها سراً كما كان يحدث من قبل، بل صارت تهاجمها في عقر دارها، وتحل محلها حتى في المجالات التي كانت ملكاً خالصاً لها وحدها، أو كان للفصحى فيها النصيب الأوفر كالأدب، والمسرح، وحتى الإعلانات التجارية، على حين كانت العامية مكتفية بمكانها في السينما والزجل، فضلاً عن كونها لغة الحياة اليومية، وهذا امتياز لم تكن الفصحى، حتى في مرحلة ازدهارها، تطمح إليه، لكنها كانت تثق في قدرتها على أن تؤثر في العامية بالقدر الذي تضيق معه المسافة الفاصلة بين لغة الثقافة ولغة الاتصال، معتمدة في هذا على القوى والمؤسسات والأدوات التي أصبحت تملكها في هذا العصر الحديث. المدارس، والجامعات التي انتشرت وأصبح التعليم فيها متاحاً للجميع. وكما انتشرت المدارس والجامعات انتشرت الصحف التي كان يحررها كبار الكتاب والأدباء. ومع الصحف دور النشر والمسارح التي بدأت نشاطها بمسرحيات مترجمة ومؤلفة بالفصحى. كما أُنشئت مجامع اللغة لإحياء الفصحى أو إيقاظها من نومها الطويل، وتصحيح الأخطاء التي نقع فيها، وتعريب ما نحتاج إليه من اللغات الأخرى، فضلاً عن الإذاعات التي أصبحت بها الفصحى حاضرة في حياتنا اليومية، لا بالمذيعين وحدهم، بل أيضاً بالمتحدثين أمثال طه حسين الذي كنا نستمع له في أحاديثه التي كان يؤديها بلغته الرفيعة وصوته الرخيم. وأستطيع أن أشير هنا أيضاً إلى برنامج الشاعر فاروق شوشة «لغتنا الجميلة». وكان فاروق شوشة – رحمه الله – أميناً عاماً لمجمع اللغة العربية في مصر.
***
غير أننا ننظر الآن لهذه اللغة الجميلة فنراها محاصرة بالخطرين: خطر العامية، وخطر اللغات الأجنبية التي تفرض علينا مفرداتها مع الأجهزة والكشوف التقنية التي لا نستطيع إلا أن نتعرف عليها ونسميها بأسمائها.
ونحن نعرف أن هذا الخطر ليس جديداً، وأننا نواجهه منذ خرجنا من عزلتنا وأصبح علينا أن نتعامل مع الغرب مضطرين حيناً ومختارين آخر؛ لأن الغرب لم يكن بالنسبة لنا حضارة متقدمة فحسب، وإنما كان أيضاً كما عرفناه في القرنين الماضيين، وكما لا نزال نعرفه حتى الآن في فلسطين قوى غاشمة وأطماعاً استعمارية كان علينا أن نواجهها، ونعرف عنها ما يجب أن نعرفه لنقاومها ونوقفها عند حد لا تتجاوزه. وفي هذه العلاقة بوجهيها الإيجابي والسلبي تأثرت لغتنا فاغتنت من ناحية بمفردات وأساليب جديدة استطعنا أن نعرّبها، واختنقت من ناحية أخرى بالكثير الذي حط عليها فيما يشبه الغزو، ونحن لا نتحرك، وفينا من يشعر بالزهو وهو يلوي به لسانه. وهكذا لم يعد الخطأ في اللغة مجرد خطأ أو غلطة تقع سهواً، وإنما أصبح الخطأ على ما يبدو لي هو الواقع الذي يفرض نفسه؛ لأن الصواب أصبح مجهولاً، أو لأن الذين يعرفون اللغة يجدون أنفسهم أمام أخطاء تتكرر كل يوم وتشيع فلا يملكون إلا السكوت وعدم المقاومة يأساً من تغيير هذا الواقع، باستثناء بعض الكتب التي صدرت في السنوات الأخيرة تنبه للأخطاء وتصححها، وتسهم في تعريف القارئ بقواعد لغته.
***
والخطأ في اللغة كان وارداً دائماً حتى في عصرها الذهبي الأول، وخاصة على ألسنة المتحدثين والخطباء الذين قد ينفعل الواحد منهم فيسبقه الخطأ إلى لسانه قبل أن ينتبه له أو يتداركه، على عكس الكاتب الذي يفكر قبل أن يكتب، ثم يراجع ما كتبه ليتأكد من سلامته.
لكن هذا الامتياز لا يجد في هذه الأيام ما ينتفع به؛ لأن الانتفاع به يحتاج إلى مناخ يسوده الحرص على اللغة والاستعداد للذود عنها وحراستها مما يمكن أن تتعرض له. وهذا هو المناخ الذي كنا نعرفه إلى أواسط القرن الماضي؛ إذ كان الكتاب يُراجع قبل طبعه، فإذا وجد الناشر فيه أخطاء خصص لها صفحة في الختام يثبت فيها الأخطاء، ويحدد مكانها في الصفحات، ويضع الصواب أمام الخطأ، وبذلك يكسب ثقة القراء فيما يصدره، ويجعل احترام اللغة والغيرة عليها خطة لا يحيد عنها، وعقيدة لدى القارئ تدفعه لتوسيع ثقافته اللغوية والحرص على سلامتها.
ونحن نقرأ الكتب الآن فلا نجد تصحيحاً أو تصويباً، وإنما نجد الخطأ منتشراً، ليس خطأً واحداً أو عشرة أخطاء، بل نراه سائداً، ثم لا يجد من يراجع، أو يصحح، أو يلاحظ، أو يعترض. وهنا أحتاج إلى المثل الذي يضرب لأمر يشتد حتى يزيد على الحد المحتمل فيقال عندئذ «بلغ السيل الزُّبى». والزبى جمع زُبية، وهي الرابية التي لا يبلغها السيل إلا حين يشتد ويعلو فَيصلُ إليها!