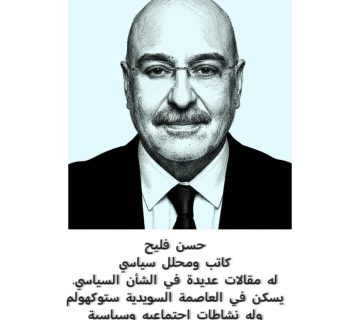أعادت أزمة التحرش، وما صاحبها من تداول للفيديو الذى يعترض فيه المتهم على ملابس الفتاة، فتح نقاش واسع حول ملابس النساء وعلاقتها بالتحرش. للأسف، هذا النقاش كارثى بكل المقاييس. فالتحرش لا يرتبط بلبس المرأة، بل بثقافة أوسع تتيح استباحة جسدها فى المجال العام، وتُحمّلها مسؤولية ما تتعرض له من انتهاك.
فلو كان اللبس هو السبب، لما تكرر التحرش بنساء منتقبات أو محجبات، وهن يشكّلن النسبة الكبرى من النساء فى مصر، ولما وقعت اعتداءات داخل نطاق الأسرة نفسها، داخل فضاءات يُفترض أنها الأكثر أمانًا. فالحقيقة أن ربط التحرش بملابس النساء ليس سوى تبسيط غير مقبول، ينقل النقاش من المذنب إلى الضحية، ويحوّل الجريمة إلى مسألة نسبية بدلًا من كونها انتهاكًا صريحًا يعاقب عليه القانون.
وهذه الثقافة لا تُنتج التحرش فحسب، بل تُسهم فى استمراره. فهى تخلق مناخًا يشعر فيه المتحرش بأن فعله قابل للتبرير، أو على الأقل للتسامح. وفى هذا المناخ، لا ينصبّ النقاش على مساءلة المتحرش أو معاقبته، بل تتحول الأسئلة إلى الضحية: لماذا كانت هناك؟، ولماذا لم تنتبه؟، ولماذا ترتدى هذا اللباس؟، ومع تكرار هذا الخطاب، تتآكل فكرة المساءلة، ويترسخ شعور بأن التحرش فعلٌ بلا عقاب.
من هنا تبرز أهمية تطبيق القانون بوصفه أداة أساسية لتقويض هذه الثقافة، لا كحلّ فورى، بل كمسار تراكمى. فحين يُعاقَب المتحرش عقابًا واضحًا وحاسمًا، تتغير معادلة الفعل نفسه. لا يتوقف الأمر عند ردع الجانى، بل يمتد إلى المحيطين به، ممن يدركون أن التجاوز لم يعد يمرّ بسهولة، وأن المجال العام لم يعد ساحة مفتوحة للاستباحة.
غير أن ثقافة الاستباحة نفسها تضع عراقيل حقيقية أمام المحاسبة. ففى كثير من الحالات يغيب الشهود إذ يفضّل كثيرون الصمت أو الانسحاب، أو حتى إبداء تضامنٍ فعلى مع الجانى. ومع غياب بدائل كافية، مثل كاميرات المراقبة أو آليات توثيق فعالة، تصبح المحاسبة أكثر صعوبة، ويزداد العبء الواقع على الضحية.
ومع ذلك، يظل تطبيق القانون بصرامة شرطًا لا غنى عنه. فحين يعرف المتحرش أن العقاب حتمى؛ ومع مرور الوقت، تبدأ ثقافة الاستباحة نفسها فى التراجع لأنها تفقد أهم ركائزها: الاطمئنان للإفلات من العقاب. لذا فإن تقليص التحرش لن يحدث سوى بمساءلة واضحة للجناة، مساءلة تعيد رسم حدود المقبول فى المجال العام، وتؤسس تدريجيًا لشعور أوسع بالأمان والعدالة لنصف المجتمع.