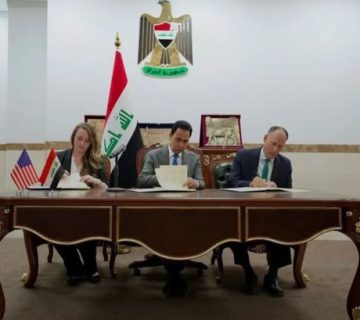المحكمة العليا هل تصبح البطل الحقيقي لحماية الجمهورية خلال انتخابات 2024 الرئاسية على رغم المطالبات بالتحقيق في أخلاقيات أعضائها؟

أعضاء المحكمة العليا الأميركية عام 1884 (الموسوعة البريطانية)
على عتبات عام جديد، 2024، تبدو الولايات المتحدة الأميركية أمام سلسلة من التحديات الجسام، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي تأتي هذه المرة وسط خلافات عميقة، لا سيما حول المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب، وهل يحق له الترشح بالفعل أم لا، عطفاً على خلافات معمقة أخرى، تظهر على السطح يوماً تلو الآخر، خلافات موصولة بأزمات النسيج المجتمعي الأميركي، وفي مقدمها إشكالية العرق والعنصرية، التي تعود لتطل برأسها من نافذة الأحداث بتكرار مخيف.
في هذا الإطار ينظر كثر إلى المحكمة العليا، بوصفها الحصن الحصين الذي سيلوذ به الجميع، لتقضي بينهم، مما يحفظ للداخل الأميركي هدوءه واستقراره.
والشاهد أنه منذ عام 2000، هناك حضور خاص للمحكمة العليا في مشهد الانتخابات الرئاسية، فقد حسمت الصراع بين بوش الابن وآل غور، كما بدا أنها كانت على مقربة شديدة من أزمات انتخابات 2020، لا سيما بعد أن اتهم ترمب الديمقراطيين بتزويرها.
واليوم هل يعيد الأمس أحداثه؟ تبدو كل الطرق هذه الأيام تقودنا إلى المحكمة العليا، وبخاصة في ظل القرار الأخير للمحكمة العليا في ولايتي كولورادو ومين بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية.

تظاهرة أمام المحكمة العليا الأميركية بخصوص قانون الإجهاض (أ ب)
المحكمة الأميركية العليا… المعنى والمبنى
هي أعلى المحاكم في أميركا، وتخول المادة الثالثة من الدستور للمحكمة “السلطة القضائية في الولايات المتحدة”، وهذه المحكمة عليا في حقيقة الأمر من حيث المكانة، كما هي من حيث الشكل. وتتكون المحكمة من رئيس للقضاة وثمانية من القضاة المعاونين. ويترأس رئيس القضاة الجلسات والمؤتمرات العلنية للمحكمة، إلا أنه أثناء المداولات الفعلية للمحكمة وعملية اتخاذ القرارات، لا يتمتع الرئيس بسلطة أكثر من زملائه. فكل قاضٍ يعطي صوتاً واضحاً. ويكون تأثير رئيس القضاة لحد ما في توظيف قدرته الذاتية على القيادة، فبعض رؤساء القضاة، مثل الراحل “إيرل وران”، استطاعوا قيادة المحكمة في اتجاه جديد. وفي أحيان أخرى يكون أحد القضاة المعاونين هو الأقوى، مثل الراحل “فيلكس فرانكفورتر”.
لا يحدد الدستور الأميركي عدد القضاة الذين ينبغي أن تتشكل منهم المحكمة العليا، لكن الكونغرس لديه سلطة تغيير حجمها. ففي مطلع القرن الـ19، كانت المحكمة تتكون من ستة قضاة، أصبحوا فيما بعد سبعة، ثم حدد الكونغرس عدد القضاة بتسعة عام 1869، وظل تشكيل المحكمة على هذا العدد منذ ذلك الحين، وفي عام 1937، طلب الرئيس فرانكلين روزفلت من الكونغرس، بعد أن أغضبته قرارات عدة اتخذتها المحكمة العليا، تسببت في إلغاء برامج “العقد الجديد”، زيادة عدد القضاة حتى يمكنه إضافة بعض المتعاطفين معه إلى المنصة، وعلى رغم أن الكونغرس أعاق خطة روزفلت “لحشد المحكمة”، فإن المحكمة أذعنت لضغوط روزفلت وبدأت في تبني نظرة أكثر استجابة لمبادراته الخاصة بالسياسات. وقام الرئيس بدوره بالكف عن مجهوداته لزيادة عدد القضاة، وقد عرف استسلام المحكمة لروزفلت بأنه “التحول الذي جاء في وقته لينقذ التسعة” The switch in time that saved nine”.
كيف يتم تعيين قضاة المحكمة؟
يعين الرئيس القضاة الفيدراليين، ويتم بوجه عام اختيارهم من بين الأعضاء البارزين أو الناشطين سياسياً من العاملين في المهن القانونية، وقد سبق أن شغل عديد من القضاة الفيدراليين مناصب القضاة في محاكم الولايات أو المدعين العامين على المستوى المحلي أو مستوى الولاية، وفي عملية ترشيح غير رسمية، يتم رفع اقتراح المرشحين للمناصب الشاغرة في المحكمة العليا الأميركية عموما إلى الرئيس من قبل أحد أعضاء مجلس الشيوخ، المنتمين إلى الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، والذي يمثل الولاية التي يوجد فيها المنصب الشاغر. وكثيراً ما ينظر أعضاء مجلس الشيوخ إلى مثل هذا الترشيح على أنه لمكأفاة الحلفاء والمساهمين المهمين في ولاياتهم، وإذا لم يكن هناك عضو في مجلس الشيوخ عن هذه الولاية من الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، فيمكن أن يتقدم الحاكم أو أعضاء الوفد النيابي للولاية باقتراح الاسم، وبوجه عام، يسعى الرؤساء إلى تعيين القضاة الذين يمتلكون الخبرة القانونية والشخصية الطيبة والذين تماثل وجهات نظرهم الحزبية والأيديولوجية تلك الخاصة بالرئيس.
والثابت تاريخياً أنه أثناء رئاسة رونالد ريغان، وجورج بوش الأب، كان غالبية القضاة الفيدراليين المعينين من الجمهوريين المحافظين. وقد أسس بوش لجنة استشارية لفحص المرشحين القضائيين للتأكد من أن فلسفتهم القانونية والسياسية محافظة بصورة كافية.
أما في عهد بيل كلينتون، فقد كان القضاة الذين قام بتعيينهم على المنصة الفيدرالية، يميلون إلى أن يكونوا من الديمقراطيين الليبراليين، كذلك بذل كلينتون جهداً كبيراً لتعيين النساء والأميركيين ذوي الأصول الأفريقية، في المحاكم الفيدرالية، وقد جاء نصف مرشحيه تقريباً من تلك الجماعات.

الأعضاء الحاليون في المحكمة العليا الأميركية (موقع المحكمة)
ترمب وأزمة كلورادو… دور المحكمة
في قرار غير مسبوق، قضت المحكمة العليا في ولاية كلورادو الأميركية (وبعدها ولاية مين)، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في العام المقبل، أما السبب فهو دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
قالت المحكمة في حكمها إنها خلصت إلى أن ترمب “ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس”، بموجب المادة الثالثة من التعديل الـ14 لدستور الولايات المتحدة.
ويبقى تنفيذ قرار المحكمة، الذي انتقدته حملة ترمب ووصفته بغير الديمقراطي، معلقاً حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.
وعلى رغم أن الحكم الجديد يسري فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية المقرر أن تجري في الخامس من مارس (آذار) المقبل، فإنه من المرجح أن تطاول تأثيراته، وضع ترتيب ترمب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
هل سيكون مصير ترمب معلقاً في أيدي المحكمة الأميركية العليا بهيئتها الحالية؟
في الأسبوع الثاني من ديسمبر (كانون الأول) طالب مدعون عامون من المحكمة الأميركية العليا البت وبسرعة فيما إذا كان ترمب يتمتع بحصانة من المحاكمة بتهمة التواطؤ لقلب نتائج انتخابات الرئاسة 2020.
كتب المدعي العام جاك سميث الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية في شأن ترمب في الطلب المقدم لأرفع محكمة في البلاد أن “هذه القضية تمثل سؤالاً أساسياً في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان كرئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فيدرالية على جرائم ارتكبت أثناء ولايته”.
وطلب سميث من المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين كان ترمب قد عين عدداً منهم بالفعل (6 مقابل 3) اتخاذ قرار سريع ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترمب. غير أن قضاة المحكمة العليا رفضوا تجاوز محكمة الاستئناف من أجل التعجيل بإصدار الحكم النهائي في شأن مطالبة ترمب بالحصانة الجنائية قبل محاكمته المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس المقبل.
قرار الرفض يمثل في واقع الأمر “ضربة كبيرة” لسميث، غير أنه يفتح الباب أمام الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المحكمة العليا في توجيه مسار الانتخابات الرئاسية القادمة… هل سيتكرر سيناريو انتخابات عام 2000؟

مقر المحكمة العليا الأميركية (موقع المحكمة)
من فوز بوش الابن إلى حظوظ ترمب
الذين لديهم حظ من الذاكرة قرابة ربع قرن إلى الوراء يتذكرون جيداً ما جرى في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2000، حين كان المرشح الجمهوري منبت الصلة بعالم السياسة يواجه نظيره الديمقراطي آل غور نائب كلينتون لثماني سنوات، وليس أي نائب، بل رجل له وزنه واعتباره السياسي، لا سيما تبنيه لقضايا البيئة، وغالب الظن لو كان قد بلغ مقام الرئاسة لكانت أمور كثيرة في سيرة ومسيرة واشنطن قد تغيرت عبر العقدين والنصف الأولين من القرن الـ21.
باختصار غير مخل، بدت بضعة أصوات لا تتجاوز 500 في ولاية فلوريدا التي كان يحكمها في ذلك الوقت جيب بوش الأخ الأصغر للمرشح الجمهوري، بدت قادرة على قلب الموازين، على رغم كثر من الأصوات التي تشكك في دقة تصويت هذه الخمسمئة لصالح بوش الابن بالفعل.
ولحسم الأمر جرت إعادة فرز الأصوات في فلوريدا يدوياً بعد موافقة المحكمة العليا بغالبية 5 مقابل 4، على رغم اعتراض كثر على القرار، بسبب الانتماءات الحزبية، لا سيما بعد أن صوت 5 من أعضائها الجمهوريين لصالح وقف إعادة الفرز ومعارضة 4 أعضاء محسوبين على الديمقراطيين.
هنا ترتفع علامة استفهام حول الدور المحوري للمحكمة العليا في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبخاصة في ظل المحاكمات المتعددة التي سيتعرض لها المرشح ترمب، وهل سيرى العالم لحظة فاصلة تقطع فيها بأنه غير مؤهل للرئاسة، أم سنرى حكماً تاريخياً هو الأول في تاريخ البلاد، يقول بأحقيته للبيت الأبيض، حتى وإن صدرت ضده أحكام مختلفة.
الجواب ملتبس لسبب واضح، وهو أنه خلال حكمه الذي دام أربع سنوات، سمى الرئيس السابق، ترمب، ثلاثة قضاة محافظين، مما جعل أعلى محكمة أميركية ذات غالبية يمينية، مع ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين.
هنا يتحدث المتخصص في قوانين الانتخابات في جامعة كاليفورنيا ريتشارد هاسن بالقول عبر مدونته، “إنه خلافاً لما كان عليه الحال في عام 2000، فإن عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة يجعل الوضع أكثر خطورة بكثير”.
تبدو أميركا عن بكرة أبيها في انتظار الجواب الشافي الوافي من عند المحكمة العليا: هل شارك ترمب في تمرد الكونغرس بالفعل في 6 يناير 2021 أم لا، وإذا كان قد شارك بالفعل، فهل الأمر يستدعي أن يستبعد من دائرة الترشح للانتخابات الرئاسية، لا سيما أن المادة الثالثة من الدستور الأميركي لا تتطلب إدانة الشخص بجرائم تتعلق بالمشاركة في تمرد حتى يتم استبعاده من الاقتراع.
وفي كل الأحوال، فإن المحكمة العليا يمكنها أن تتعمق في مسألة مشاركة ترمب من عدمه، أو يمكنها أن تختار الحكم على أسس فنية، مما يترك ترمب خارج مسألة إبداء الرأي.
قرارات للمحكمة العليا تثير الخلافات
ينتظر الأميركيون قرارات المحكمة العليا في شأن ترمب، وقد يكون القرار حجر عثرة جديد في الطريق نحو المستقبل، وضمن أحجار عثرة عدة، تبدو مقلقة للمسارات الآمنة للأميركيين عما قريب.
في مقدم القرارات الخلافية المثيرة للجدل، جاء إلغاؤها لبرنامج الرئيس جو بايدن، الخاص بشطب قروض الطلاب، الذي يستفيد منه الملايين من طالبي العلم الأميركيين، غير القادرين على تمويل مسيرتهم العلمية، وقد اعتبرت المحكمة أن بايدن بهذا القرار قد تجاوز صلاحياته.
يدرك قضاة المحكمة العليا أن هناك نحو 43 مليون أميركي يقعون تحت الأعباء الطائلة لكلف التعليم، ويبلغ إجمالي قروضهم نحو 1.6 تريليون دولار، مما يضطر الملايين إلى دفعها تالياً على مدى عقود، في التزام مالي مهلك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.
وعلى رغم ذلك، فإن المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، صوتت بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، لصالح إلغاء البرنامج.
ومن بين القرارات الأخرى التي سببت شرخاً عميقاً في جدار النسيج المجتمعي الأميركي، ذاك الخاص بالإجهاض، ففي يونيو (حزيران) 2022، ألغت المحكمة حكماً شهيراً يعرف باسم “رو ضد ويد”، يكفل منذ عام 1973، حق النساء في الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
منذ هذا القرار الجديد، صار لكل ولاية الحق في سن القوانين التي تراها مناسبة في شأن الإجهاض، ومن ثم قررت نحو 20 ولاية حظر الإجهاض.
هذا القرار سبب خلافات عميقة بين المحافظين اليمينيين في عموم أميركا، وبين الديمقراطيين، لا سيما التقدميين، أولئك الذين يرون أن قرار المحكمة العليا بمثابة عودة للولاية أو الوصاية الدينية كما كان الحال في القرون الوسطى في أوروبا.
من القضايا الأكثر إثارة التي تعرضت لها المحكمة العليا قضية فصل الدين عن الدولة، لا سيما في ظل دستور يكرس حرية التعبير والإيمان والمعتقد، ومن غير ربط أو شرط بين التقدم للوظائف، أو أداء الخدمات العامة، بالهوية الدينية.
في يونيو من العام نفسه 2022، أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بأن ولاية “مين”، لا يمكنها حرمان المدارس الدينية من الأموال العامة.
واعتبرت القاضية، سونيا سوتومايو، وهي من القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة العليا، أن زملاءها من الغالبية المحافظة تعدوا على أحد المبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة المرتبطة بالفصل بين الكنيسة والدولة.
دفع القرار كبير المستشارين في اتحاد الحريات المدنية للأميركيين في ولاية “مين” زاكاري هايدن للقول إن الحكم “قلب عقدين من الاجتهاد القضائي”.
هل بات الأميركيون يعتقدون أن المحكمة العليا في البلاد أصبحت بالفعل مؤدلجة وموجهة في خط سير واحد؟
تبدو القرارات السابقة وكأنها تؤسس “لقوة طاغية محافظة لا تتزعزع، لديها طموح لتبقى مسيطرة”، والعهدة هنا على صحيفة “نيويورك تايمز”.
هل هذه القرارات تقود المجتمع الأميركي، لا سيما التشريعي منه إلى إعادة النظر في حال ومآل المحكمة العليا دفعة واحدة؟

القاعة الرئيسة للمحكمة العليا الأميركية (موقع المحكمة)
الكونغرس ومساءلة “أخلاقية المحكمة”
في أوائل شهر مايو (أيار) الماضي، بدا وكأن هناك تطوراً غير مسبوق في مسار علاقة الأميركيين بالمحكمة العليا، التي كان يتم النظر إليها على الدوام بوصفها “الملاذ الآمن” الأخير للأميركيين حينما تقع بينهم خلافات.
المحكمة عينها صارت محل خلافات، فقد بينت استطلاعات رأي أن 58 في المئة من الأميركيين باتوا يرون أنها تؤدي وظيفتها بصورة سيئة.
في هذا التوقيت شهدت جلسة استماع للجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون جدلاً كبيراً حول أخلاقيات القضاة، لا سيما بعد أن قبل قاضيان محافظان، أحدهما هو كلارنس توماس هبة من رجل أعمال.
في الوقت عينه رفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، المحافظ أيضاً، الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، مشيراً إلى ما سماه “مخاوف في شأن فصل السلطات وأهمية الحفاظ على استقلال القضاة”.
هل بلغ الفساد المالي الذي يخيم على سماوات السياسيين الأميركيين، طريقه كذلك إلى عالم القضاة المفترض فيهم نزاهة مطلقة؟
المؤكد أن القاضي توماس الذي يعد من القضاة الأكثر محافظة في المحكمة العليا، قد وجد نفسه وسط جدل كبير، وذلك عندما كشف موقع “بروبابليكا” عن أنه قبل هدايا باهظة الثمن من دون الإعلان عنها، بما في ذلك رحلات طيران خاصة، أو رحلات بحرية على متن يخت ضخم من الملياردير الجمهوري هارلن كرو.
توماس في واقع الحال، لم يكن هو القاضي الوحيد الذي ألقى الضوء على سلوكياته، فقد باع زميله المحافظ نيل غورسوش مباشرة بعد التصديق على تعيينه في المحكمة العليا، في عام 2017 عقاراً كبيراً في كولورادو، إلى المدير التنفيذي لشركة المحاماة “غرينبريغ توريغ” التي تترافع بانتظام في قضايا أمام المحكمة العليا، وفقاً لصحيفة “بوليتيكيو”.
اختصم كذلك من رصيد المحكمة في أعين الأميركيين تسريب القرار الخاص في شأن الإجهاض قبل أن يصدر بصورة رسمية، مما جعل مستويات الثقة الشعبية في المحكمة تنخفض بصورة تاريخية، مما يقوض صورتها التي يفترض أن تكون “فريدة” و”مستقلة”، وقد زاد من أبعاد الأزمة تصريح رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دورين في رسالته التي دعا فيها رئيس المحكمة العليا إلى الإدلاء بشهادته. وقال فيها “عمليات الكشف التي طاولت قضاة لا يحترمون المعايير الأخلاقية المتوقعة في ازدياد”.
هنا تطفو على السطح علامة استفهام مثيرة، وربما خطرة في الوقت عينه: هل سينظر الديمقراطيون والمستقلون، وكل من يتخذ موقفاً مضادا من ترمب، بنظرة شك إلى المحكمة وقراراتها المستقبلية، حال اعتبرت أن كل الاتهامات الموجهة إلى ترمب، لا تمثل عائقاً في طريق ترشحه للرئاسة 2024؟ وإذا جرى الأمر على هذا النحو، هل ستتحول المحكمة العليا من ترس وسيف للأميركيين يحتمون به في أوقات الخلاف، إلى نقطة خلاف؟
هل من حاجة إلى إصلاحات للمحكمة؟
يبدو التساؤل الملح الذي يرد على تفكير الأميركيين، نخبة وعواماً، موصولاً بفكرة الإصلاحات الواجب إدخالها على بنيان المحكمة العليا، وبما يلائم تطورات المشهد العالمي عامة، والأميركي بخاصة.
في مقدم المقترحات الخاصة بالمحكمة العليا يأتي الحديث عن زيادة عدد القضاة، لا سيما أن الدستور لا يحدد عدداً بعينه.
في ورقة بحثية قدماها عام 2019 اقترح أستاذا القانون دان إيبس وغانيش سيتارامان زيادة عدد أعضاء المحكمة العليا إلى 15 شخصاً، بحيث تتألف من خمسة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين وخمسة قضاة يختارهم الـ10 الآخرون.
صاحب هذه الفكرة السيناتور بيت بوتجيج الذي حاول الترشح للرئاسة الأميركية في انتخابات 2020، ويشغل الآن منصب وزير الإسكان في إدارة الرئيس جو بايدن.
تدور الفكرة في سياق أن ميزان القوى في المحكمة العليا سيحكمه قضاة معتدلون مقبولون لكلا الحزبين، ولكن هناك عدداً من المخاوف في شأن هذا الاقتراح، منها أنه من المحتمل أن يعلن أنه غير دستوري، إذ يمنح الدستور الرئيس فقط سلطة ترشيح قضاة جدد، وليس لهيئة من 10 قضاة آخرين.
على أن التساؤل الحقيق بالوقوف أمامه: هل الأزمة تتوقف عند حدود عدد القضاة، أم أنها تتشابك مع قضية فصل السلطات في الدستور الأميركي؟ بمعنى أنه هل يمكن للسلطة التشريعية أن تراقب القضائية بصورة مكثفة، أم أن الأخيرة ترفض هذه الرقابة، كما تبين من رفض رئيس المحكمة المشاركة في أعمال جلسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ؟
ثم تبقى هناك مسألة العلاقة بين التوجهات الحزبية والأيديولوجية بين الرئيس الحاكم وبين القضاة المعينين، وهي مسألة تحتاج إلى إعادة قراءة، ذلك أن كل رئيس يميل عادة إلى اختيار قضاة يتفقون وتوجهاته السياسية، مما يخلق نوعاً من أنواع التمايز أو المحاصصة.
هل من خلاصة؟ مؤكد أن أحوال المحكمة العليا تشبه كثيراً من أوضاع أميركا في نهج إعادة ترتيب أولوياتها عما قريب.