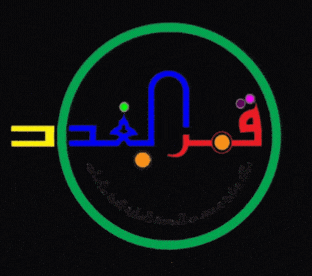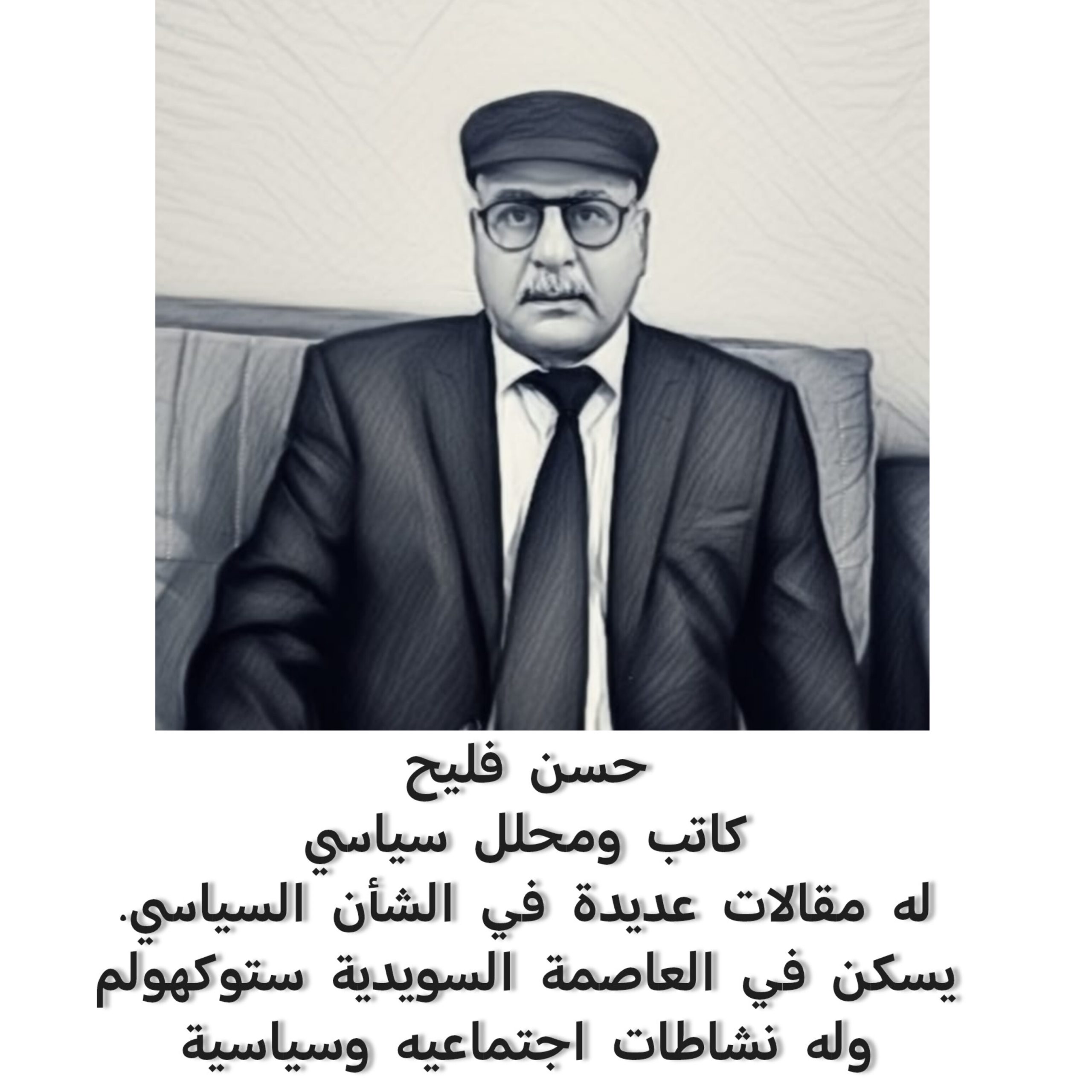في الذاكرة الجمعية العربية، تمثل نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967 محطتين مفصليتين في مسار الصراع العربي–الإسرائيلي، ومعهما تكرّس شعور الهزيمة كعنصر دائم في الوعي السياسي العربي. ومع ذلك، فإن الحدث الذي أعاد صياغة خريطة المنطقة وأحدث انقلابًا استراتيجيًا في موازين القوى، لم يكن في فلسطين أو على حدودها، بل في بغداد، يوم 9 نيسان 2003، حين سقطت عاصمة الرشيد تحت الاحتلال الأميركي، وانفتح الباب على مصراعيه أمام تمدد النفوذ الإيراني داخل قلب العالم العربي.
من هزيمة الجيوش إلى تفكيك الدول: الفرق الجوهري بين 1948 و2003
نكبة 1948 كانت ضياعًا للأرض بفعل فشل سياسي وعسكري، لكنها لم تُغيّر البنية العميقة للمجتمعات العربية، ولم تُنتج انقسامًا داخليًا. العدو كان واضحًا، والمشروع الصهيوني محدد المعالم، ومع ذلك بقيت المجتمعات العربية موحدة في هويتها رغم الانكسار.
في 1967، جاءت الهزيمة قاسية ومُهينة، ليس فقط عسكريًا، بل على مستوى الشعارات القومية التي سقطت أمام اختبار الواقع. ومع ذلك، فإن النكسة لم تمسّ جوهر الدولة الوطنية في العالم العربي، ولا استهدفت بنيته الاجتماعية من الداخل.
أما في 2003، فإن ما جرى في العراق لم يكن احتلالًا تقليديًا، بل تفكيكًا كاملًا لمفهوم الدولة المركزية، واستبدالًا للسلطة الوطنية بهيكلية طائفية هجينة، جرى تصنيعها وتمكينها بعناية أميركية وبتواطؤ عربي غير معلن.
مصر وكامب ديفيد: تمهيد مبكر لتحييد القطب العربي
حين خرجت مصر من معادلة الصراع بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في أواخر السبعينيات، لم يكن ذلك مجرد اتفاق سلام، بل كان بداية التحلل في العمود الفقري للنظام العربي. بذلك، أُضعف الدور القيادي لمصر وأُفرغت فكرة “القيادة العربية الجامعة” من مضمونها، مما مهّد الطريق لتآكل تدريجي في منظومة التوازن الإقليمي، وجعل سقوط بغداد لاحقًا ممكنًا دون ردّ فعل عربي موحد.
الاحتلال الأميركي للعراق: نقطة انكسار في الجغرافيا والهوية
سقوط بغداد لم يكن مجرد سقوط لعاصمة، بل كان انهيارًا لمنظومة الردع العربية. العراق، الذي شكّل طوال عقود حاجزًا استراتيجيًا بين الخليج وبلاد فارس، ووازن النفوذ الإيراني سياسيًا وعسكريًا، تم تفكيكه وتسليمه إلى قوى دينية مرتبطة بطهران.
هذا التحول لم يتم فقط بالسياسة، بل من خلال أدوات مركبة: دستور مفخخ بالطائفية، جيش منهار، جهاز إداري مخترق، وميليشيات تموّلها وتسلّحها إيران، وتحمل مشروعًا عابرًا للدولة.
من مشروع الدولة إلى مشروع الميليشيا: نهاية الكتلة العربية
في أعقاب 2003، برزت تحولات عميقة:
العراق خرج من كونه دولة مركزية ذات قرار سيادي، وتحول إلى ساحة نفوذ تتقاطع فيها أجهزة إيرانية وغربية، وتهيمن عليها ميليشيات فوق الدولة.
سوريا، التي كانت تمسك بخيوط المعادلة المشرقية، انجرفت تدريجيًا إلى الحضن الإيراني ثم انفجرت داخليًا عام 2011، لتدخل في طور إعادة التشكيل الإيراني–الروسي.
لبنان سقط فعليًا في قبضة حزب الله، وهو حزب مسلح يتبع استراتيجيا للحرس الثوري.
اليمن، منذ سيطرة الحوثيين، بات جزءًا من العمق الاستراتيجي لإيران، وورقة ابتزاز ضد الخليج.
هكذا، بدلاً من أن يكون النظام العربي مشغولًا بتحرير الأرض، أصبح غارقًا في صراعات داخلية تغذّيها إيران من الداخل، عبر “وكلاء” يحملون راية الطائفة ويخوضون حرب استنزاف طويلة ضد الدولة والمجتمع.
من الاحتلال إلى الاختراق: قراءة في عمق الهزيمة
نكبة 1948 كانت بداية صراع مع كيان استيطاني أُسّس على أنقاض شعب، أما بعد 2003، فقد أُسّس مشروع تفكيكي داخل الدول ذاتها، وبأدوات تتحدث العربية وترفع شعارات دينية. الهزيمة لم تعد تأتي من الخارج، بل من داخل الأنظمة، ومن داخل المجتمعات، بفعل تآكل السيادة، وانهيار منظومة الهوية، واستبدال الانتماء الوطني بالولاء العابر للحدود.
هل كانت بغداد لحظة قابلة للتفادي؟
ربما. لكن النظام العربي آنذاك كان يعيش حالة من الشلل الاستراتيجي، نتيجة خصومات تاريخية، وغياب رؤية مشتركة، وانقسام حول العلاقة مع واشنطن وطهران. وبينما رأت بعض العواصم في سقوط صدام تصفية لحسابات قديمة، لم تدرك أن سقوط بغداد كان يعني فتح الباب أمام انهيار المنظومة العربية بأكملها.
ما بعد 2003 ليس كما قبله
احتلال فلسطين في 1948 وضع العرب أمام عدو واضح، لكنه حفّز مشروع المقاومة. نكسة 1967 فجّرت الأسئلة حول شرعية الأنظمة، وأنتجت مراجعات فكرية. أما احتلال بغداد، فقد أنتج حالة من “اللا-مشروع”، وحالة من “اللا-هوية”، وفرض منطق الميليشيا كبديل للدولة، ومنطق التبعية كبديل للسيادة.
في ذكرى 5 حزيران، لا بد من الاعتراف بأن الخطر لم يعد فقط في تل أبيب، بل في قلب بغداد، وفي مؤسسات الدولة المخترقة، وفي العقائد الطائفية التي تحكم وتوزّع الولاءات.
استعادة التوازن العربي لن تبدأ من مواجهة إسرائيل فقط، بل من استعادة بغداد كعاصمة للقرار السيادي، وكسر القبضة الإيرانية التي تُحكم الطوق على أربعة عواصم عربية .