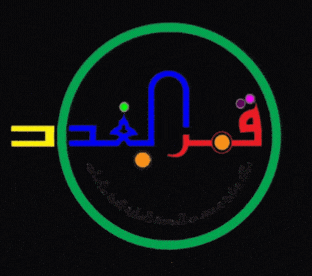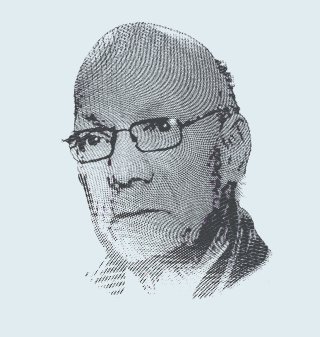سأبدأ بطرح السؤال الذي تركت للقراء الأعزاء أن يتوقعوه في عنوان المقالة الماضية. في تلك المقالة بدأت حديثاً عن الثقافة العربية الآن، وذلك لأن المقالتين اللتين سبقتا هذه المقالة كانتا بعنوان «الثقافة الغربية… هل تتراجع؟»، وكان جوابي فيهما بالإيجاب، فالثقافة الغربية كما يبدو لي ولآخرين غيري، تتراجع في هذه الأيام. وقد خطر لي أن أطرح السؤال ذاته على ثقافتنا، فهي أولى بسؤالي عن حالها، وأنا أولى بطرح السؤال عليها وعلى نفسي، وهذا ما جعلني أضع السؤال هكذا: «والثقافة العربية…؟»، تاركاً للقراء الأعزاء أن يكملوه بالسؤال الذي طرحته من قبل على الثقافة الغربية ليكون: والثقافة العربية… هل تتراجع؟
وإذا كنت قد ترددت في الإجابة، وأنا أتحدث عن الثقافة الغربية لأني لا أستطيع أن أكون فيها حكماً عدلاً، فلن أتردد كثيراً في الإجابة، وأنا أتحدث عن ثقافتنا، لاعتقادي أني أعرف فيها ما يكفي للإجابة عن السؤال، وأن ما أراه فيها الآن يراه الكثيرون. فإذا كانت الصراحة في هذه الإجابة مؤلمة، فهي من ناحية أخرى واجبة وضرورية. وإذا كان التجاهل مريحاً بعض الوقت، فنتائجه تنذر بما يجب أن نتجنب الوصول إليه والوقوع فيه، وإذن فجوابي عن السؤال هو: نعم! ثقافتنا تتراجع في هذه الأيام وتتراجع من قبلها. وقد آن لنا أن نواجه هذا الخطر مجتمعين، وأن نتدارك ما فاتنا، وإلا فالخسارة فادحة. ومن دون ثقافة حية، كيف يكون لنا في حضارة العصر حق أو مكان؟ وكيف ننتقل من موقف الشاهد المتفرج من بعيد إلى موقف المشارك المساهم؟
فإذا بقينا في موقفنا الراهن، فسوف نجد أنفسنا خارج العالم الذي ينتقل كل يوم من مستقبل إلى مستقبل.
وأنا أنظر حولي الآن، أبحث عن ثقافتنا فلا أجد إلا الغياب. لا أقارن بين ما ننتجه نحن وما ينتجه الغربيون؛ فثقافتنا لا تتحمل الدخول في هذه المقارنة الصعبة، حتى وهي في مرحلة ازدهارها والثقافة الغربية وهي تتراجع، وإنما أقارن بين ما ننتجه في هذه الأيام وما كنا ننتجه في أواسط القرن الماضي. وهنا أجد نفسي مضطراً للتعميم، لأني أتحدث عن ثقافة تشارك فيها أقطار مختلفة تتفاوت طاقاتها، فإذا نظرنا إلى ما ننتجه في مجموعه وشهدنا له أو ضده، ساوينا بين الكل، مع إدراكنا أن ما تقدمه بعض الأقطار لا تقدمه أقطار أخرى، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. ولأن شروط الإنتاج الثقافي في الأقطار العربية متباينة أو متراوحة؛ فنحن نظلم أقطاراً أنتجت وأخرى لم تنتج إذا عممنا الحكم، لأننا سننسب فيه ما قدمته بعض الأقطار لبعضها الآخر التي لم تسهم فيه إلا بالقليل.
ونحن نعرف أن النصيب الأكبر والأهم من الإنتاج الثقافي العربي الحديث، يعود لأقطار بالذات نكتفي بما تنتجه وننسب لها كل شيء؛ فنظلم غيرها ونظلم الثقافة العربية بالتعميم.
***
مصر بدأت نشاطها الثقافي في هذا العصر بعد أن رحل عنها الفرنسيون، وبدأ محمد علي مشروعه الذي سار به خطوات في الطريق إلى الاستقلال الذي كان بالضرورة مشروعاً ثقافياً، بدأ بإحياء الفصحى والترجمة، ووصل إلى ما وصل إليه من ازدهار بمختلف الميادين في النصف الأول من القرن العشرين.
وفي هذه المرحلة ذاتها، أدى لبنان دوراً شبيهاً بالدور الذي أدته مصر، وهذا ما جعل المصريين واللبنانيين يعملون معاً في الثقافة، وينجزون ما أنجزوه في الصحافة، والمسرح، والنشر. ومن مصر ولبنان، امتد النشاط الثقافي إلى سوريا والعراق وفلسطين.
ولا شك في أن النشاط بهذه البلاد كان له صداه وأثره في بقية الأقطار التي أخذت تسهم وتنتج دون أن تنال حقها من الاهتمام. أقطار المشرق في المقدمة، رغم أن نشاطها تراجع في العقود الأخيرة، أما أقطار المغرب العربي فالاهتمام بما تقدمه ما زال محدوداً، إلا أسماء قليلة نقرأ عنها أكثر مما نقرأ لها. ولهذا تفسيره. فاللغة العربية والثقافة العربية كلها كانت في أقطار المغرب محاصرة ومضطهدة، خصوصاً في الجزائر التي تعرضت للاحتلال، ثم للاستعمار، ثم ضمها المستعمرون الفرنسيون لبلادهم، مما أنتج ثقافة جزائرية باللغة الفرنسية نعرف ممن ظهروا فيها الروائي محمد ديب، والروائية آسيا جبار، والشاعر كاتب ياسين. وهذا ما لم تتعرض له أقطار المشرق التي سقطت في أيدي المحتلين الإنجليز. لكن هؤلاء لم يفرضوا ثقافتهم على البلاد التي احتلوها، وإن صنعوا في فلسطين ما هو أسوأ بكثير، إذ سلموها للعصابات الصهيونية التي خيّرت شعبها بين الموت والهجرة. ومع هذا، استطاعت الثقافة العربية في القرى والأحياء التي نجت من المذابح، أن تقدّم لنا وللعالم أمثال محمود درويش وسميح القاسم وإميل حبيبي.
***
غير أن الأحداث والتطورات المختلفة التي شهدتها بلادنا في العقود الأخيرة تحاصر النشاط الثقافي، وتحول بينه وبين التقدم والازدهار. وهذا ما أجد نفسي مضطراً للاعتراف به. فالثقافة العربية الحديثة تتراجع بالفعل في هذه الأيام.
صحيح أن هناك ما يدعو للاحتياط والتأني في الحديث عن هذا التراجع الذي قد يكون في بعض النشاط، وليس في النشاط كله، وفي بعض الأقطار وليس فيها جميعاً. وأنا لا أدعي الإحاطة بكل ما ننتجه في هذه الأيام. وفي الماضي القريب، كانت المجلات الأدبية ودور النشر تطلعنا على ما يقدم هنا وهناك. وكان مراسلوها في العواصم العربية وبعض العواصم الأجنبية يزودوننا بما يقدم فيها من أعمال. ولولا مجلة «أبوللو» المصرية، التي أصدرتها هذه الجماعة الشعرية في الثلاثينات الأولى من القرن الماضي، لما عرفنا الشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي. وهي أيضاً التي عرّفت المصريين وغيرهم، بالشاعر الكاتب الحضرمي علي أحمد باكثير الذي ولد في إندونيسيا، وقضى طفولته في حضرموت، ثم جاء إلى مصر ليكمل تعليمه العالي ويمارس نشاطه في الإبداع، ويحصل على الجنسية المصرية.
والدور الذي أدته مجلة «أبوللو» أدته طوال الثلاثينات والأربعينات مجلة «الرسالة» ومجلة «الثقافة» و«الهلال» و«المقتطف»، وغيرها.
وفي الأربعينات من القرن الماضي، وصل عدد المجلات الأدبية في مصر إلى أكثر من عشرين مجلة، اختفت كلها أو معظمها في الخمسينات والستينات.
وفي الوقت الذي احتجبت فيه «الرسالة» المصرية التي كانت تنشر لكل الشعراء والكتاب العرب، وكانت توزع وتُقرأ في الوطن العربي كله، صدرت «الآداب» اللبنانية لتؤدي الدور الذي كانت تؤديه «الرسالة»، ومعها دار النشر التي أنشأها الروائي اللبناني سهيل إدريس. وعلى صفحات «الآداب» تعرفنا على الأجيال الجديدة التي ظهرت في لبنان وسوريا والعراق ومصر، وقادت حركات التجديد في الشعر والقصة. فإذا كانت المواهب لا تزال موجودة، ولا تزال تكتب وتنظم، فكيف لنا أن نتعرف عليها إذا كانت المنابر قد اختفت؟
لكن اختفاء المنابر ليس له للأسف إلا معنى واحد؛ أن الكتابة تتراجع، وأن القراءة تتراجع؛ وإذن فالثقافة تتراجع. وعلينا أن نقف إلى جانبها لتستعيد وعيها بنفسها، وتفكر بحرّية، وتعبر بحرّية، وهكذا تتقدم وتزدهر.