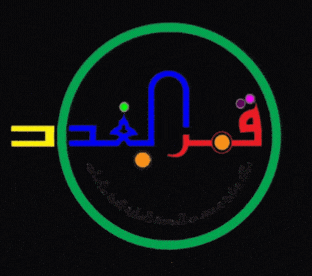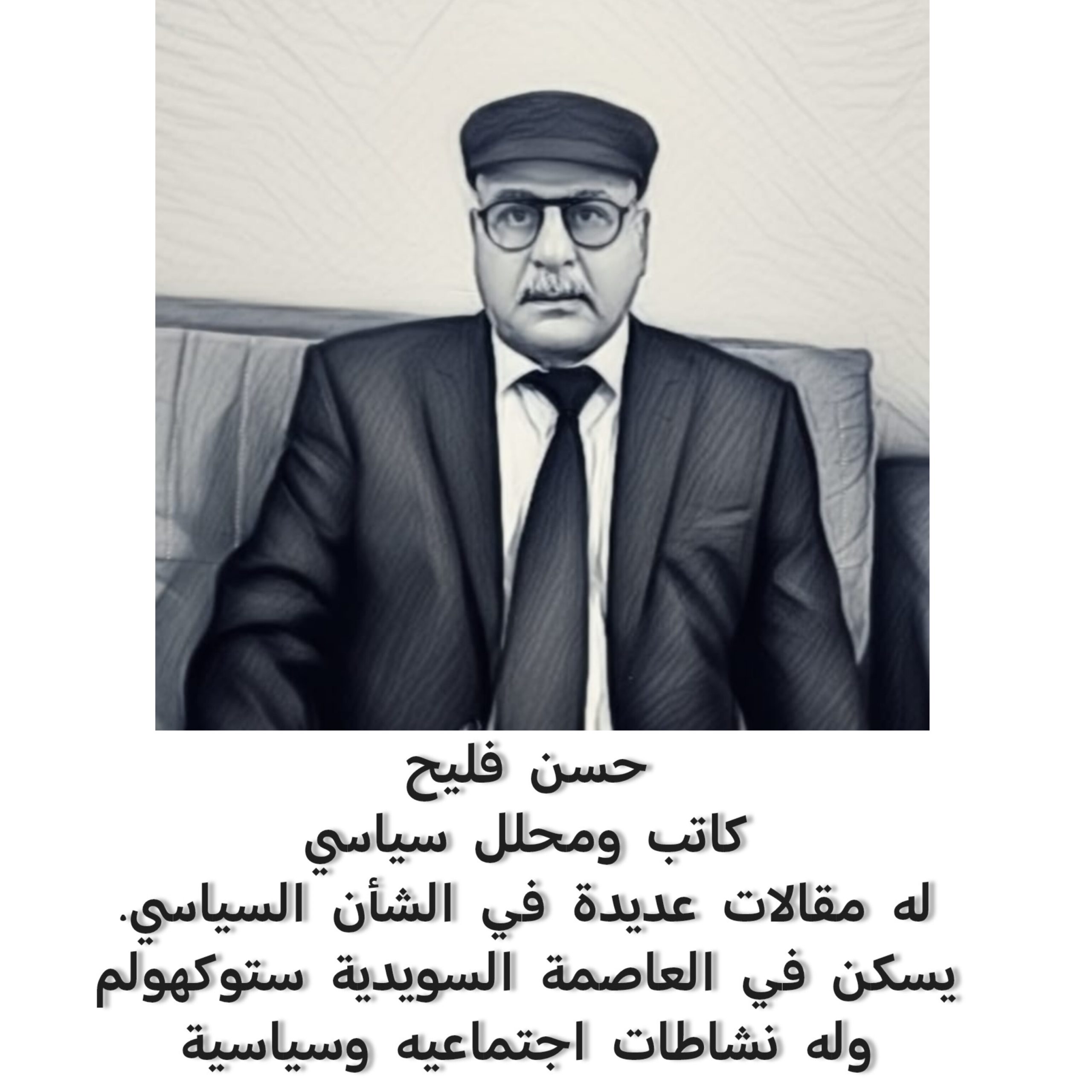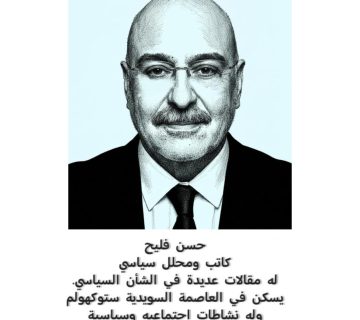في التاسع من نيسان عام 2003، شهد العراق لحظة تاريخية مفصلية عندما سقط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي. كانت اللحظة بمثابة نهاية لحقبة الدكتاتورية، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى بداية لمرحلة من الفوضى، وانهيار الدولة، وتفكك مؤسساتها. وبينما هلّل البعض لسقوط “الدكتاتور”، بدأ آخرون يدركون أن ما سقط لم يكن النظام وحده، بل سقطت معه الدولة ومقوماتها. واليوم، بعد أكثر من عقدين، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: أيهما كان أخطر على العراق والمنطقة؟ الدكتاتورية أم فقدان الدولة؟
أولاً: الدكتاتورية… شرّ متوقع بوجه مكشوف
لا شك أن نظام صدام حسين مثّل واحدة من أقسى صور الحكم الدكتاتوري في الشرق الأوسط. قمع الحريات، حروب عبثية، تهميش واسع للمكونات، وهيمنة حزبية ضيقة. لكن ما يميّز الأنظمة الدكتاتورية في الغالب أنها تُظهر وجهها بوضوح، ما يجعل التعامل معها قابلاً للمعرفة والمقاومة، وإنْ بصعوبة.
الدكتاتورية كانت تُدار من مركز واحد، تُمسك بكل مفاصل السلطة، لكنها -رغم طغيانها- حافظت على شكل الدولة: حدود مصانة، مؤسسات متماسكة، جيش موحد، وإدارة مركزية.
ثانياً: ما بعد 4/9… سقوط الدولة لا النظام فقط
سقوط النظام لم يكن وحده الحدث. الأخطر كان قرار تفكيك الدولة العراقية، بدءًا من حلّ الجيش، إلى تفكيك الوزارات، مرورًا بغياب المشروع الوطني البديل، ووصولًا إلى تسليم السلطة لمجموعة من الأحزاب التي لم تكن تمتلك رؤية دولة، بل مشروع غنيمة.
هنا تكمن الكارثة: الدكتاتورية، على ما فيها من بطش، كانت تُمسك بالدولة، أما ما تلاها فجعل العراق ساحة مفتوحة لصراعات داخلية، تدخلات خارجية، وميليشيات مسلحة أصبحت أقوى من مؤسسات الدولة نفسها.
ثالثاً: المنطقة على خط الزلزال العراقي
لم تكن تداعيات ما حدث في العراق محصورة داخل حدوده. بل انتقلت آثار زلزال 4/9 إلى الإقليم كله. النموذج العراقي أصبح تحذيراً لا يُستهان به: كيف يؤدي إسقاط نظام دون مشروع دولة بديلة إلى تفكك شامل، تُستنسخ تجاربه في اليمن، سوريا، وليبيا.
الفراغ الذي خلّفه غياب الدولة في العراق أغرى القوى الإقليمية والدولية بالتدخل، من إيران إلى أميركا، ومن تركيا إلى الفصائل المتعددة. وأصبح العراق مختبراً لتوازنات إقليمية تتجدد باستمرار، على حساب أمنه وسيادته.
رابعاً: من هو العدو الأخطر؟
حين نقارن بين الدكتاتورية وفقدان الدولة، لا يمكن تبرئة أيٍّ منهما. لكن الأخطر دون شك هو غياب الدولة. لأن الدكتاتورية يمكن إسقاطها حين تتكامل الظروف، أما انهيار الدولة، فيعني انهيار المنظومة التي تضبط المجتمع وتحمي المصالح العامة.
الدكتاتورية تقهر المواطن، لكن غياب الدولة يتركه فريسة للفوضى، للسلاح المنفلت، للفساد، للطائفية، ولصراع الهويات المتنازعة.
في 4/9 لم يسقط النظام وحده، بل سقطت الدولة، وانكشف العراق على المجهول. وبعد أكثر من عشرين عامًا، لا تزال البلاد تعاني من ذلك الفعل: لا الدولة عادت، ولا النظام القائم استطاع بناء بديل وطني جامع. وبين دكتاتوريةٍ راحلة ودولةٍ مفقودة، يبقى العراق والمنطقة يدفعان الثمن… والسؤال يبقى مطروحًا. هل يمكن تصحيح المسار قبل أن يُكتب الفصل الأخير في هذا الانهيار؟
إن الحل لا يكمن في الحنين إلى زمن الاستبداد، بل في الوعي الشعبي بضرورة بناء دولة المؤسسات، دولة القانون والمواطنة، التي تحمي الحقوق وتفرض النظام وتمنع الاستفراد أو الانفلات. فالشعب العراقي، الذي أثبت مراراً شجاعته وصموده، هو وحده القادر على إعادة التوازن، إذا ما توحدت إرادته وتجاوز الانقسامات، نحو مشروع وطني جامع، يستند إلى سيادة الدولة وعدالة الحكم ونزاهة الإدارة. إن طريق الخلاص يبدأ من الإيمان بأن الدولة ليست مجرد سلطة، بل ضمانة للحياة، وغيابها يعني غياب الوطن بكل ما فيه.