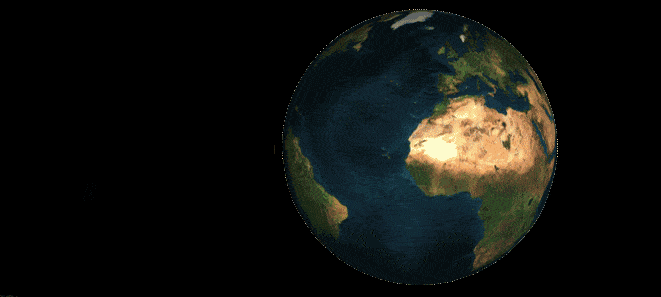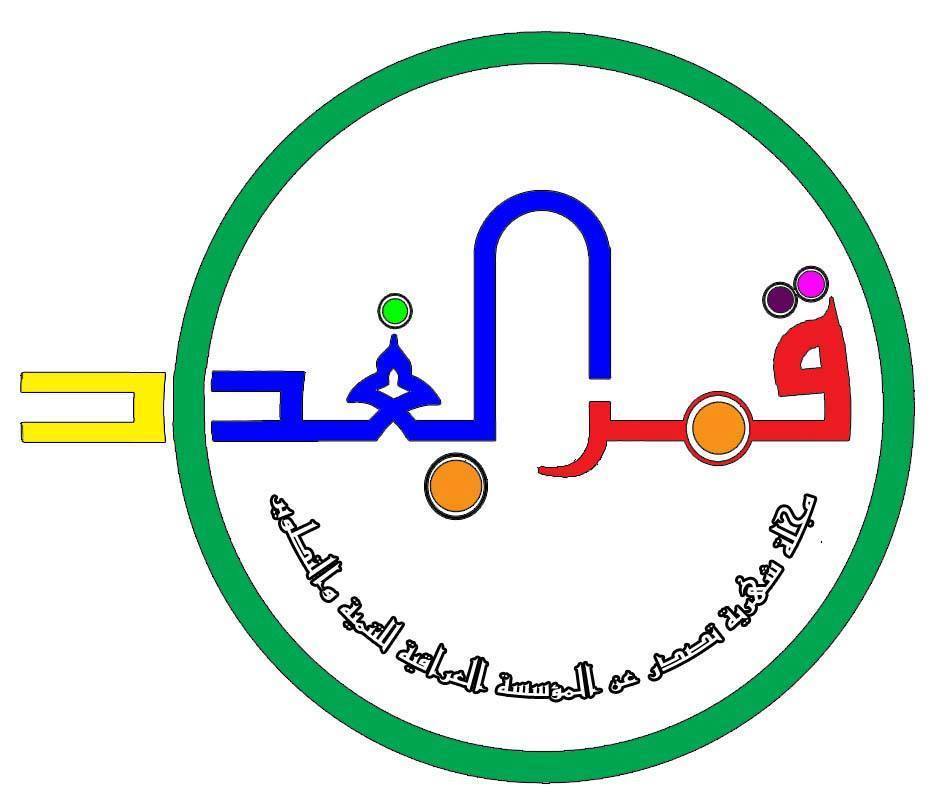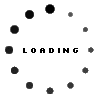المصدر: النهار العربي
طارق العبد
صورة من الأرشيف لأحد مسلحي ميليشيا الجنجويد في السودان (أ ف ب)
لا تفارق الميليشيات المسلحة تاريخ السودان منذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم، سواء في لحظات ضعف السلطة أو قوتها. فمسألة حمل السلاح وتشكيل المجموعات المقاتلة مستمرة بأوجه عرقية أو قبلية أو دينية، مع مفارقة أن البندقية التي يقاتل صاحبها إلى جانب الحكومة تنقلب ضدّها في فترات لاحقة، لتغدو الحصيلة عدداً غير محدد من الفصائل، بعضها أشبه بجسم بلا رأس، وسط غياب القيادة الفعلية والانشقاقات التي تكاد تلازم أغلبيتها.
حرب عصابات وفكرة التسليح
كانت جبهة جنوب السودان أولى المواجهات التي وجدت السلطة نفسها فيها أمام مجموعات مسلحة تقاتل بمبدأ حرب العصابات دفاعاً عن مطالبها برفع التهميش. وهي الأزمة التي تبلورت لاحقاً لتكون العنوان العريض لحركات التمرّد تحت شعار “المركز والهامش”.
هكذا بدأ أول تمرّد في جنوب السودان قبل الاستقلال في عام 1955، فتشكّلت مجموعة “الأنيانيا” (وتعني “سم الثعبان” بلغة قبائل الجنوب) بسبب قلة التنمية وتركيز الوظائف بيد الشماليين والصراع العرقي بين الهويتين العربية والأفريقية. ومع استيلاء الفريق إبراهيم عبود على السلطة في عام 1958، اشتدت قوة الهجمات في ولايات جنوب البلاد، ما دفع عبود إلى تسليح قبائل كالنوير والديلكا والشلك. فكانت هذه بدايات تكوّن المجموعات المقاتلة تحت راية الحكومة التي لن تتمكن لاحقاً من ضبط عملية التسليح.
في عهد الرئيس جعفر النميري الذي انطلق في عام 1969، بدأت سلسلة تحولات تُوجت باتفاق أدّى إلى التهدئة نسبياً مع الجنوب، الذي بات مقاتلوه منتظمين تحت راية “الحركة الشعبية لتحرير السودان”. غير أن أزمة جديدة لاحت في الأفق مع اعتداء قطاع الطرق والعصابات على المزارعين ورعاة الماشية، هذه المرّة في الشمال الغربي وصولاً للجنوب، فتشكّلت قوات “المراحيل”، وتسلّل السلاح مجدداً نحو القبائل العربية في دارفور، كقبيلة الرزيقات التي تحدّر منها أفراد سيعملون لاحقاً على تأمين قوافل التجارة والماشية، وليشكّل أحدهم بعد عقود إحدى المجموعات التي تقاتل الجيش ذاته، هو محمد حمدان دقلو، قائد “قوات الدعم السريع”.
في الوقت نفسه، كان لافتاً الامتداد القبلي بين غرب السودان وليبيا وتشاد، إضافة إلى انتقال السلاح في سلسلة بين البلدان الثلاثة، خصوصاً في الثمانينات، تزامناً مع الحرب التي شنّها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضدّ أنجمينا، واعتماده الكبير على تسليح القبائل في تلك المنطقة الصحراوية.
الدفاع الشعبي رديفاً للجيش
ازداد نمو الميليشيات أكثر بعد الانقلاب الذي نفّذه عبد الرحمن سوار الذهب على النميري في عام 1985، لتسقط الاتفاقات الموقّعة مع القيادات الجنوبية، وليتجدّد القتال فيصل للمرّة الأولى إلى قلب السودان. قرّرت الحكومة الانتقالية آنذاك تسليح القبائل العربية والنوبية في إقليم كردفان، فتزايدت الميليشيات وازداد حمل السلاح لقتال “الحركة الشعبية” جنوباً، والتي باتت أقرب إلى جيش منظّم في ذلك الوقت.
لكن الحكومة السودانية، برئاسة الصادق المهدي، اتخذت قراراً بالإشراف المباشر على عملية تنظيم المقاتلين بتشكيل “قوات الدفاع الشعبي” الرديفة للجيش، والتي تساعد في تأمين المدن والمرافق الحيوية. إلّا أن تحولاً مفاجئاً غيّر أيديولوجية هذه القوات بعد الانقلاب الأشهر في تاريخ السودان، ووصول عمر البشير إلى السلطة في عام 1989، فتعززت حينها الصبغة الدينية لـ”قوات الدفاع الشعبي”، وأصبحت أقرب إلى الخدمة الإلزامية للرجال والنساء، برعاية “الحركة الإسلامية” التي اعتبرت تشكيل هذه القوات جهاداً ضدّ مقاتلي الجنوب.
كبرت “قوات الدفاع الشعبي” بسرعة، وظهرت في داخلها مجموعات توصف بشراسة القتال، كالدبّابين التي حاربت في الجنوب بإشراف مباشر من قيادات “الجماعة الإسلامية”، واستمرت قوة موازية للجيش مع امتيازات وتمويل كبير رافقها طيلة حكم البشير، ليتمّ حلّها بعد إطاحته، وإلزامها تسليم سلاحها إلى القوات النظامية، ما يثير الشكوك حتى اليوم حيال جدّية التزام ذلك، وسط حديث عن دورها الحالي في القتال إلى جانب الجيش السوداني، ما يشير إلى استمرار احتفاظها بالسلاح أو اعتبارها أقرب إلى الخلايا النائمة.
أزمة دارفور: حمى الانشقاقات والشرارة الأولى
نجح اتفاق نيفاشا في عام 2005 في إيقاف أطول الحروب أمداً في أفريقيا، وبات جنوب السودان على سكة طويلة ستقوده بعد سنوات إلى الانفصال. غير أن تمرّداً جديداً أصاب السودان هذه المرّة في غربه، وتحديداً في إقليم دارفور، حيث يتجدد القتال بين القبائل الأفريقية المطالبة بإنهاء ما تصفه بأزمة “المركز والهامش”.
في بداية عام 2002، تكونت مجموعات مسلحة مثل “حركة العدل والمساواة”، و”حركة تحرير السودان” المكونة من قبائل الزغاوة والفور والمساليت، والتي ترأسها عبد الواحد محمد نور ونائبه خميس بابكر (عُيّن بعد اتفاق جوبا للسلام في عام 2020 والياً على غرب دارفور قبل اغتياله في بداية الحرب والتمثيل بجثته وسط اتهام الجيش للدعم السريع بذلك). لكن الانشقاق وجد طريقه إلى الحركة بعد ثلاث سنوات من تشكيلها، فانقسمت في مجموعتين، بقيت إحداهما مع عبد الواحد نور، والثانية تزعمها الأمين العام السابق مني أركو مناوي، الذي عُيّن لاحقاً حاكماً لإقليم دارفور بعد اتفاق جوبا.
أما “حركة العدل والمساواة” فاعتمدت على جزء من قبيلة الزغاوة. وبدا لافتاً ارتباط مؤسسها خليل إبراهيم بحسن الترابي، الزعيم الإسلامي المنشق بدوره عن “حزب المؤتمر الوطني” الحاكم. كما حظي بدعم لافت من القذافي قبل أن ينجح البشير باستهدافه في شتاء 2011، فانتقلت رئاسة الحركة إلى جبريل إبراهيم الذي عُيّن وزيراً للمالية بعد اتفاق جوبا، ولا يزال في منصبه.
اللافت أن عدوى الانشقاقات امتدت إلى جنوب كردفان، حين بقيت مجموعات موالية لحركات جنوب السودان تقاتل السلطة بعد انفصال الأخير، يقودها عبد العزيز الحلو، متحصناً في جبال النوبة، وكذلك في إقليم النيل الأزرق، أقصى الحدود الجديدة للسودان. فتشكّلت “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، لتشهد في عام 2017 انشقاقاً دفع بالحلو إلى كردفان مسيطراً على مواقع يسمّيها “المناطق المحررة”. أما النيل الأزرق فبات تحت سيطرة مالك عقار، الذي وقّع – خلافاً للحلو – اتفاق جوبا، ثم انفصل عنه القيادي ياسر عرمان منحازاً إلى قوى الحرية والتغيير، بعد فضّ الشراكة بين الجيش والمدنيين في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، فيما عُيّن عقار نائباً لرئيس مجلس السيادة بعد شهر من بداية الحرب.
نقل البندقية وانقلاب على البشير
حدث هذا كله وسط انتشار قديم جديد للسلاح، دفع الحكومة – حتى قبل انتهاء حرب الجنوب – إلى تكرار الخطة السابقة بتعزيز تسليح القبائل العربية في الإقليم. وجدت الحكومة نفسها في دائرة مغلقة باعتمادها على ضخ المال والعتاد الحربي للقبائل لحماية نفسها وحماية المنشآت الحيوية، وخصوصاً موارد النفط، لتكبر هذه المجموعات وتتقاتل في ما بينها، وتهدّد السلطة التي لجأت إلى موسى هلال، زعيم قبيلة المحاميد، لتأسيس “ميليشيا الجنجويد”، التي نجحت في إخماد تمرّد دارفور، مرتكبةً الانتهاكات والجرائم.
وضعت المحكمة الجنائية الدولية الجنجويد في قائمة المطلوبين التي امتدت لتشمل عمر البشير نفسه. غير أن هذا الأخير واصل الاعتماد على هذه الميليشيا، مؤسساً هيكلاً عسكرياً باسم “قوات حرس الحدود”، لمع فيها لاحقاً اسم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهو أحد أقرباء موسى هلال، والذي تصاعد دوره إلى درجة إطاحته هلال نفسه وسجنه في الخرطوم إثر خلاف عاصف بينهما في عام 2006.
عزز هذا الأمر ثقة البشير بحميدتي الذي صار العصب الرئيسي لقوات “الدعم السريع” خلال سنوات قليلة، متمتعاً بامتيازات مالية عالية ومرتبات توازي رواتب ضباط القوات المسلحة أو تتفوق عليها، وباستثمارات كبرى في الذهب والتجارة والزراعة. أثار هذا الأمر استياء جنرالات الجيش، خصوصاً بعدما صار “الدعم السريع” قوة موازية لهم. وعلى الرغم من إنها لم توجّه إليهم السلاح، غير أنها كانت تثير ريبتهم مع إصرار البشير على تنميتها ووضعها تحت إدارة جهاز الأمن، ثم تحت الإشراف الشخصي للرئيس الذي استدعاهم إلى الخرطوم أول مرّة في عام 2013، لإخماد تظاهرات مطلبية في العاصمة، خصوصاً بعدما نجح حميدتي في التمدد سريعاً وإضعاف الحركات المسلحة، خصوصاً في دارفور وجنوب كردفان، وأصبح قوة ترتكز عليها السلطة الضعيفة في الأقاليم البعيدة. وتردّد أنه أبرم اتفاقات مع قيادات في دارفور تقضي بالتهدئة في عامي 2006 و2007، من دون علم البشير ذاته.
باتت قوات “الدعم السريع” حاضرة في أغلبية الولايات السودانية، غير أن المشهد تغيّر كلياً بعد إطاحة البشير على يد حميدتي نفسه في نيسان (أبريل) 2019، وتعاظم دور الرجل الذي أصبح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي. باتت لقواته دور أساسي في حماية المنشآت الرسمية في الخرطوم، من المطار إلى القصر الرئاسي ومبنى الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي والبرلمان. وللمفارقة، هذه المباني هي أولى المواقع التي سيطرت عليها قوات “الدعم السريع” إثر اندلاع الحرب الأخيرة في نيسان (أبريل) 2023.
ولعلّ المفارقة الأكبر في الحرب الحالية هي لجوء السلطة إلى من كان عدواً في الأمس. فالحركات المسلحة التي قاتلت ضدّ الجنجويد، وهي من القبائل الأفريقية، انحازت هذه المرّة إلى الجيش السوداني، بعدما اتخذت موقف الحياد في البداية. عادت قوات “جيش تحرير السودان” و”حركة العدل والمساواة” وغيرها إلى القتال في صفوف الجيش، وإلى التحرك في جبهات أم درمان وولايات الجزيرة وسنار والقضارف، فتمكنت من صدّ هجمات “الدعم السريع” على معقلها الأخير في الفاشر، شمال إقليم دارفور، الذي شهد في الفترة الماضية كذلك إعلان موسى هلال انحيازه إلى الجيش، في خطوة شكّلت مفارقة في مسيرة الرجل الذي وقف إلى جانب البشير ثم عاد وتمرّد عليه، ليقرّر اليوم الانحياز إلى القوات النظامية.
تكرار الإشكالية نفسها
يقول الكاتب والباحث محمد مصطفى جامع لـ”النهار العربي”، إن الحكومات تكرّر الخطأ نفسه بتسليح المجموعات والميليشيات، كما يحدث اليوم عند قتال “الدعم السريع”، الذي أنشئ هو نفسه للقضاء على الحركات المسلحة وكسر شوكتها.
ويضيف: “نجح الدعم السريع بذلك، لكن كان الثمن باهظاً، وهو إساءة سمعة الحكومة، وفرض حظر السلاح في دارفور بموجب قرارات دولية. وهذا النهج، للمفارقة، استمر من إبراهيم عبود وحتى عهد الصادق المهدي، حين حصل أوسع تجنيد للميليشيات في ما عُرف بقوات ’المراحيل‘ التي أسسها وزير الدفاع آنذاك، رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، مسلحاً الميليشيات للتصدّي للجيش الشعبي”.
من الناحية العملياتية، يعتبر جامع أن هدف تكوين الميليشيات كان الاعتماد على سرعة حركتها وقدرتها على الهجوم المباغت، “وهاتان ميزتان تتمتع بهما قوات الدعم السريع، وقد حققت بفضلهما انتصارات كبرى، خلافاً للقوات الحكومية التي تتحرك بتراتبية معينة”. ويضيف: “يعتمد ذلك على سهولة تشكيل الميليشيا، فأن تجند أفراداً وضباطاً في القوات المسلحة يحتاج وقتاً طويلاً بالطرق التقليدية، أما في الميليشيات، فهذا يعتمد على الفزعة القلبية ودور الزعامات الأهلية، وفي أيام معدودة يمكن جمع أعداد كبيرة من المسلحين”.
ويستدرك جامع قائلاً، إن هذا يحلّ مشكلة آنية، مستشهداً بما حصل في الفاشر، حين تمكنت الحركات المسلحة من صدّ هجوم الدعم السريع، ويقول: “الثمن المستقبلي كبير، فلا ضمان أن تنقلب الحركات المسلحة على أي حكومة، بل على السلطة الحالية إن تمكنت من إبرام اتفاق مع قوات ’الدعم السريع‘”.
من جانب آخر، يردّ الكاتب والخبير الميداني ياسر الفضل تكوين الميليشيات في السودان إلى طبيعة الدولة السودانية. يقول لـ”النهار العربي”: “السودان دولة كبيرة جغرافياً، وكانت أكبر بلد في أفريقيا مساحة قبل انفصال جنوب السودان. لها حدود مع 7 دول، ويتألف مجتمعها من قبائل وإتنيات مختلفة، حتى داخل الإقليم الواحد، مع تفاوت كبير في درجات التنمية ورثها من المستعمر الإنكليزي”.
ووفقاً للفضل، لم يعرف السودانيون منذ الاستقلال عقداً اجتماعياً واضحاً بين مكوناته المختلفة من جهة، وبين الدولة المركزية من جهة أخرى، بشأن طريقة الحكم أو التنمية، أو تمثيلهم في أجهزة الدولة المركزية، ما خلق حالاً من عدم الرضا لدى بعض المكونات، فتمرّدت على سلطة الدولة المركزية.
ويضيف: “هذه الحركات مصبوغة بطابع قبلي حتى ولو رفعت شعارات أيديولوجية، فهي في النهاية تمثل مكونات عرقية وإتنية محدّدة تعتمد عليها في تكوين قواتها، مثل قبيلة الزغاوة في ’حركة تحرير السودان‘ – جناح مني أركو مناوي، والفور في ’حركة تحرير السودان‘ – جناح عبد الواحد محمد نور، أي إننا نتكلم عن تمرّد مكونات داخل الدولة السودانية”.
ويردّ الفضل عجز الجيش السوداني عن القضاء على التمرّد إلى تكوينه القومي ورفض بعض الضباط والجنود قتال مكونات يتحدرون منها، أو بسبب عدم امتلاكه فائضاً كبيراً من القوة، “فتلجأ الحكومة السودانية إلى التناقضات الموجودة في المجتمعات المحلية، بين بعض القبائل العربية وغير العربية في دارفور، والتي سمحت بتسليح بعض المكونات واستخدمها في مكافحة التمرّد”، خاتماً حديثه بالقول: “بعد القضاء على التمرّد، تسعى هذه الميليشيات إلى الحصول على اعتراف رسمي بالتضحيات التي قدّمتها، مطالبة بمكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية، مثل دمج أفرادها في الجيش النظامي، وهنا على الدولة التوصل إلى اتفاق معها، وإلّا يحدث التمرّد، ونعود إلى مربع الحرب الأول”