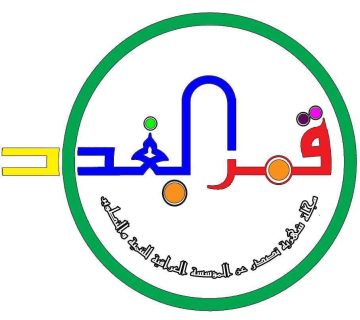صلاح سالم
في سياق تاريخي يمكننا اعتبار جمال عبد الناصر وثورة يوليو بمثابة امتداد بل استكمال لأحمد عرابي وثورته الوطنية المجهضة، التي بدأت بمطلب بسيط هو مساواة المصريين بغيرهم في الترقي إلى المناصب العلىا في الجيش، لكنها استحالت تعبيراً سياسياً عن ميلاد طبقة وسطى مصرية تؤمن بضرورة بعث العسكرية المصرية من مرقدها، تأكيداً على الشموخ الوطني في مواجهة التحدي البريطاني.
قاد الرجل ما كان قد تبقى من الجيش المصري ومن انضم إليه من الوطنيين آنذاك، محاولاً الصمود قدر الممكن، حتى انتهى الأمر بهزيمة كانت منطقية لرجل حارب جيشاً متقدماً بقوات متقادمة، وجابه إمبراطورية عالمية من داخل فضاء ولاية “خديوية”، وإن كانت مستقلة “اسمياً” عن السلطان العثماني. وعلى رغم منطقيتها، تركت الهزيمة جرحاً غائراً في الضمير المصري، حتى أن المصريين سموها آنذاك “هوجة عرابي”، متسائلين بمرارة، وإن كان السؤال مضمراً: هل يستطيع المصريون (الفلاحون) أن يستعيدوا حضورهم السياسي والعسكري في التاريخ بعد طول قطيعة؟ هل بمقدورهم أن يبنوا الجيش ويخوضوا الحروب وينتصروا فيها بفعل منظم، أم أن الأمر محض نزوة عسكرية وهوجة سياسية؟
كان جمال عبد الناصر أبرز من تصدوا للإجابة عن هذا السؤال باسم جمهورية يوليو التي جعلت من مصر دولة وطنية حديثة ومستقلة جذرياً، كما لم تكن منذ نهاية الحقبة الفرعونية، تخوض حروبها بجنودها، وتمارس السياسة بذاتها، يطلب رئيسها من المواطن العادي أن يرفع رأسه، وأن يحلم بطرد بريطانيا واستعادة قناة السويس التي حفرها المصريون بدمائهم، ولو عبر حرب انتهت بالهزيمة عسكرياً، ولكن بالانتصار سياسياً وأخلاقياً.
من ثم تبنى عبد الناصر إيديولوجية راديكالية تعلي قيم التحرر والكبرياء على ما عداها، بغية إحداث قطيعة مقصودة مع القيم الراعوية في الشخصية المصرية كالاستسلام والخضوع والقدرية والشعور بالدونية إزاء الآخر، بخاصة الأوروبي.
لعب جمال عبد الناصر، من دون شك، دوراً محورياً في تاريخ القرن العشرين وصراعاته، محاولاً أن يجد لمصر موطئ قدم بين الفاعلين الكبار في الإقليم والعالم، فقاد حركة التحرر العربي، وساهم بنصيب يذكر في دعم نضال حركات التحرر في إفريقيا والعالم الثالث، فيما كان يقود في الداخل مشروعاً تحديثياً، وإن سلطوياً، أخذ إلهامه من الحداثة الأوروبية وإن في صورتها الاشتراكية (الشمولية)، محدثاً في مصر تغييراً امتد إلى عمق المجتمع والعلاقة بين طبقاته، وإلى قلب النظام السياسي بكل مكوناته، بما فيها رموز الدولة كالعلم والنشيد الوطني. ولعله صحيح أن هذا المشروع لم يبلغ الأفق الديموقراطي قط، ولم ينفتح أبداً على تيارات الحركة الوطنية، خصوصاً حزب الوفد، بفعل الشك العميق بينهما، غير أن الأمر المؤكد أنه تبنى أكثر مطالب الحركة الوطنية نبلاً وعمقاً، كإقامة جيش وطني، وتأميم قناة السويس، وبناء السد العالي، وتحقيق الإصلاح الزراعي، وفرض التعلىم النظامي الواسع الذي كان طه حسين اعتبره “كالماء والهواء”، وكلها تنضوي في صيرورة تحديث عميقة، تمثل بدورها الشرط الضروري اللازم لأي تحول ديموقراطي حقيقي، وإن كان هذا التحوّل قد تعثر دوماً، بل غاب دهراً، تمّت فيه وقائع كثيرة انتهت برحيل عبد الناصر والذي تهاوى بعده الجسد وانطفأت الروح.
تلك هي قصة 23 يوليو، الثورة التي بدأت بتحرير مصر من محتليها، ومنحتها دفعة أمل في التقدم التاريخي نحو طليعة الأمم، قبل أن تنتهي بعصر حسني مبارك الذي وضعها في مؤخرة الأمم، إذ أورثها ركوداً ويأساً، وحرمها القدرة على الإنجازات الكبرى، مكتفياً بالتفاخر ببناء كوبري هنا أو تدشين طريق هناك. وهنا نود أن نضع ضابطين يؤطران التقييم التاريخي لهذه الجمهورية في ذكرى مئوية مؤسسها (15/1/1918):
أولهما يحسب على عبد الناصر الذي وقع في خطأ جسيم عندما استبعد تيارات الحركة الوطنية من مشروعه، على نحو حرم المجتمع المصري نخبته المدنية، وهو أمر أصاب الثقافة السياسية المصرية بضرر لم يتم جبره حتى الآن، إذ أوقعها في فخ الواحدية وغياب التنوع الخلاق بعيداً عن الفوضوية والمراهقة السياسية. وبدلاً من حقبة ليبيرالية مشوهة كانت النخبة خلالها هي الهدف والغاية على حساب المجتمع فكان لدينا رأس بلا جسد، أصبح المجتمع هو الهدف مع إقصاء النخبة، فصار لدينا جسد بلا رأس. في الأولى كانت ثمة استنارة فكرية من دون تحديث مجتمعي، وفي الثانية كان ثمة تحديث مجتمعي من دون تعددية فكرية وسياسية، الأمر الذي أبقى المشروع الناصري، على رغم عمقه ووطنيته، في إطار السلطوية البحتة، رهينة للمقادير التي أتت برجل ذي مزاج مختلف سار بمصر في طريق آخر من دون ممانعة تذكر من كتلة مجتمعية لم تكن لديها أدوات للمقاومة السلمية.
وثانيهما لمصلحة الرجل، الذي تحمّله الأحكام التاريخية المتسرعة والكتابات السياسية المتحيزة كل آفات يوليو، وكأن مسار الجمهورية كان قدراً محتوماً، تفضي بداياته إلى نهاياته بالضرورة، وهذا حكم جائر وفق تصوري. فأنور السادات كانت لديه فرصة عظيمة، خصوصاً بعد حرب أكتوبر، للخروج من كهف السلطوية إلى آفاق الديموقراطية، وهو ما حاوله بتردد شديد ومراوغة أشد انتهت به إلى المناورة بالإسلام السياسي الذي نال منه وأهدر دمه ليرحل تاركاً مصر في محنة قاتمة. كما أن مبارك الذي طال حكمه عقوداً ثلاثة أتيحت له كل فرص التحول الديموقراطي والتنمية الشاملة لكنه أطاح بها كلها.
وإذا كان ممكناً التماس العذر للسادات الذي امتد حكمه عقداً واحداً شهد دراما الحرب والسلام، فلا يمكن التماس العذر لمبارك الذي ورث حكماً مستقراً في أعقاب معاهدة السلام وخروج مصر من حالة الحرب مع إسرائيل، لكنه مع ذلك أهدر وقته في وأد حيوية 23 يوليو، وفي النيل الصريح من قيمها الجمهورية عبر مشروع التوريث الذي أفضى إلى 25 يناير.
ومن الظلم البيّن أن تُنسب إلى عبد الناصر كل سوءات مبارك، لمجرد أنه وريث يوليو. فليرحم الله جمال عبد الناصر، الذي سيبقى دائماً أحد الآباء المؤسسين للوطنية المصرية، والرواد البارزين للحركة القومية العربية.