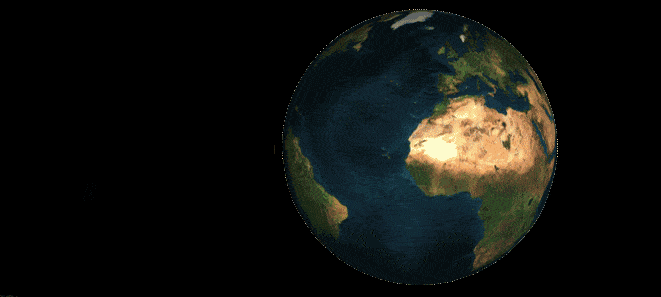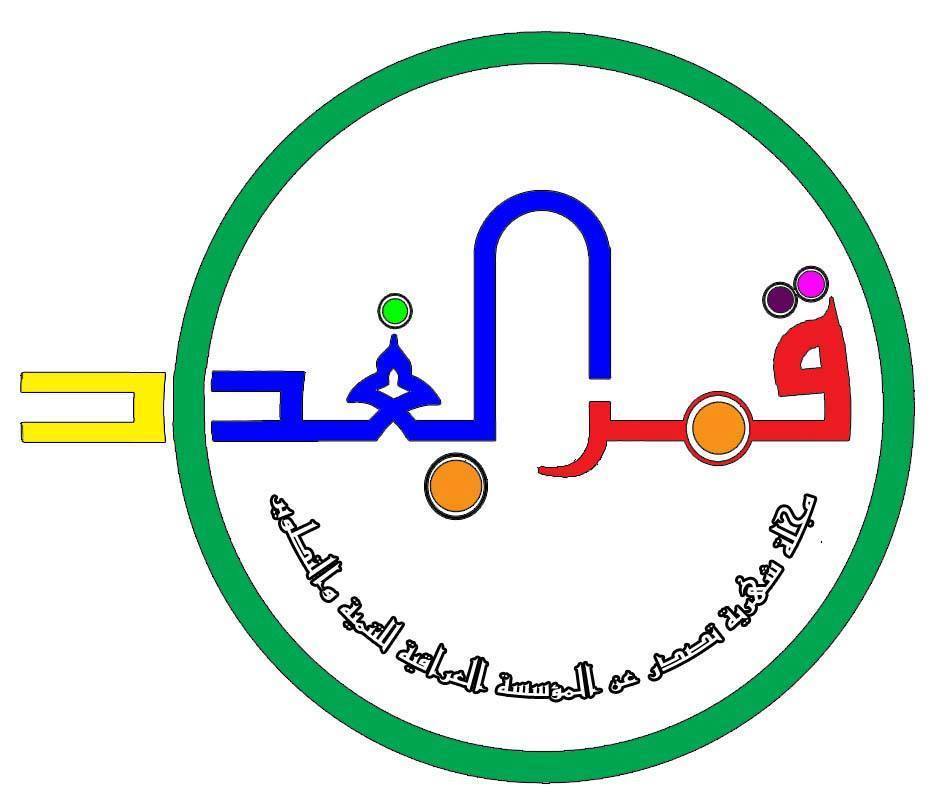عبدالله بن بجاد العتيبيكاتب سعودي مهتم بالحركات الإسلامية والتغيرات في الدول العربية، وله عدة مؤلفات حول ذلك منها «ضد الربيع العربي» وله أبحاث منها: «القابلية للعنف والقيم البدوية»، نشر في 2006. و«السرورية» 2007. و«الولاء والبراء، آيديولوجية المعارضة السياسية في الإسلام» 2007. و«الإخوان المسلمون والسعودية الهجرة والعلاقة» 2010. قدم عدداً من الأوراق البحثية للعديد من مراكز الدراسات والصحف. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، وهو خريج جامعة المقاصد في بيروت في تخصص الدراسات الإسلامية.
تقديس الشيء: جعله مقدساً بعد أن لم يكن، وفي تواريخ الأمم والشعوب مقدسات كثيرة، بعضها في أصل الديانة، وبعضها من صنع التاريخ والسياسة والمؤسسات الدينية، رغبة في سلطة دينية، أو نشراً للخرافات بأسباب متعددة وأنماط متباينة، تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال.
التراث الإسلامي مترعٌ حدّ الثمالة من ظاهرة التقديس التي جاء الإسلام نفسه للقضاء عليها: تقديس الأشخاص، وتقديس الأفكار، وتقديس الأشياء. ويتفرع عن هذه الثلاثة كثيرٌ من المقدسات الزائفة التي أضرت بالإسلام بوصفه ديناً سماوياً كريماً، وأضرت بالأمة والدولة والبشر، وكأي ظاهرة كبرى فقد كانت لظاهرة التقديس مسبباتٌ، ولناشريها غاياتٌ، ولا تختلف المسببات إلا بقدر ما تفترق الغايات، لا في النهج والهدف وإنما في التجليات والأسماء والأفكار.
ومن العجائب أن من حاربوا التقديس في تراثنا قد ابتُلوا بمن يقدسهم بعد وفاتهم، فأحمد بن حنبل الفقيه المعروف، كان يرفض التقديس، ثم وجد في بعض من جاءوا بعده مَن يقدسه. والفقيه ابن تيمية حارب التقديس ورفضه، ورد على بعض ناشريه، ثم ابتُلي بمن يقدسه ويقدس أقواله وأفكاره. وبعض من جاء بعدهما من أتباعهما حارب التقديس، فجاءت بعده مؤسسات تقدسه وترفض نقده، وربما ترفض ذكره بالاسم في غير سياق المديح والتبجيل والتقديس.
تقديس من يحارب التقديس ارتكاسٌ في الفكر، ورِدّة في الدين، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «اللهم إني أعوذ بك من الحَور بعد الكَور» وفي القرآن الكريم: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً»، وتقديس من يحارب التقديس طوال عمره ظاهرة جديرة بالدرس ضمن ظاهرة التقديس العامة، فهو تقديس داخل التقديس، فهو مبحثٌ دقيقٌ لأنه يحوي تناقضاً صارخاً.
مؤسسات المصالح التي ترتبط بالرموز الرافضة للتقديس وبفكرهم، هي التي تعيد تقديسهم وترفض نقدهم، وتحول دون أي إعادة قراءة لتاريخهم وسيرتهم وتأثيرهم، وهي مصالح مرتبطة بمناصب وسلطة دينية وبأموالٍ طائلة، وحين تمتدّ هذه المصالح لقرونٍ من الزمن ثم تلتقي بحركاتٍ وتنظيماتٍ دينية سياسية ذات طموحاتٍ سلطوية، يصبح من شبه المستحيل إجراء نقدٍ فعّالٍ للتخلص من هذا التقديس، ويتمّ التحايل لمنع ذلك النقد، ويتم استخدام السلطة الدينية والمناصب والنفوذ لمنع أي قراءة نقدية أو تحليل فكري أو تمحيص علميٍ.
السيرة النبوية والفتنة الكبرى، كُتبت عنها عشرات الكتب قديماً وحديثاً، وتمّ تناولها بمناهج تاريخية وأدبية حديثة، فكتب فيها في عصر النهضة العربية طه حسين والعقّاد، وغيرهما كثير، وكتب عنها المفكرون المعاصرون، من أمثال: محمد عابد الجابري، وعبد الله العروي، وهشام جعيط، وغيرهم كثير أيضاً، ومع الإقرار بأن لا أحد من المسلمين يصل لمقام النبوة في القداسة، ولا لمكانة الصحابة في الدين، فإنه في بعض لحظات الانحطاط في التراث الإسلامي، يصبح تناول بعض الفقهاء أو «الأحبار» بقراءة نقدية وفق مناهج حديثة، وتحليلٍ علمي دقيقٍ، وطرح أسئلة مُلحّة ومنطقية، مهمة شاقة لا تجد طريقها للنشر، بحكم قوة بعض المؤسسات الدينية المهيمنة.
شهد التراث الإسلامي تقديس الأشخاص على مستوياتٍ، فشهد تقديس الحكّام والخلفاء والملوك، ومن ذلك ما نُقل عن الحجاج بن يوسف أنه قال: «رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟» وقد علّق على هذا المؤرخ ابن كثير فقال: «فإن صح هذا عنه فظاهره كفرٌ، إن أراد تفضيل منصب الخلافة على الرسالة».
كما شهد تقديس الفقهاء، وموقف الإسلام من ظاهرة التقديس ظاهرٌ في رفضها جملة وتفصيلاً، وتحديداً رفض تقديس رجال الدين، وقد جاء في القرآن الكريم عن بني إسرائيل قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله»، وهذه ظاهرة إنسانية وُجدت في بني إسرائيل، ووُجد مثلها في التاريخ الإسلامي وفي الحديث الشريف: «لتتبعن سنن من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
وقد قدّس الناس بعض الفقهاء والأولياء في التراث الإسلامي، ومن ذلك قول الفقيه الحنبلي ابن تيمية: «فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة… كان من أهل البدع والضلال والتفرق». والعجيب في هذا السياق هو أن يصبح ابن تيمية نفسه محلاً لهذا التقديس الذي كان يرفضه ويحذر منه.
«فتنة القرّاء»، أو فتنة «ابن الأشعث»، وفتنة «النفس الزكية»، وفتنة «ابن الصبّاح» قائد «الحشاشين»، وفتنة «الإخوان المسلمين»، وفتنة «القاعدة»، و«داعش»، هي جميعاً فتنٌ وثوراتٌ قادها رجال دينٍ ودعاة، بعضهم أراد الإصلاح والصلاح، وبعضهم أراد السلطة والسياسة، وهي خطيرة في وقتها، وأكثر خطراً في آثارها، وقد غيّرت وبدّلت في التاريخ والسياسة إلى اليوم، فبعض قضايا الهوية والفكر أبلغ أثراً وأطول تأثيراً من أحداثٍ سياسية آنية، وإن كانت دموية وعنيفة.
من يقرأ تاريخ الأمم والشعوب يعرف خطورة بعض المؤسسات والتنظيمات والتيارات في التأثير على توجهات الدول ورؤى القادة، تأويلاً وتحريفاً وتزويراً، لا معارضة صريحة ورفضاً قاطعاً، حدث هذا ويحدث في شرق الأرض وغربها، وهي ظواهر معروفة تاريخياً، ومدروسة في علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي، وبخاصة حين تتحرك تلك المؤسسات والتيارات عبر المناصب والمصالح والتحالفات، وتستفيد من مناطق الفراغ لتنطلق منها وتتحرك فيها، ويزيد الطين بلة حين تلتقي الآيديولوجيا بالجهل، ويتخادمان على تعتيم الحقائق ورفض البحوث العلمية والطروحات النقدية، فتوأد الأسئلة المستحقة، ويُنشر الانحراف على نطاقٍ واسعٍ ليغرق الحقائق، ويخلط عن وعي بين المعاني والأحداث وبين الأسماء والأفكار.
حين يصبح «التنوير» تهمة، و«الثقافة» أشكالاً زاهية لا أفكاراً لامعة، و«الفلسفة» علم كلامٍ، و«النقد» مجرد أداة لغوية للفذلكة لا للوعي، فإن ترقّي الأمم والشعوب في مدارج المعرفة ومعارج الكمال يصير غاية بعيدة المنال، وهدفاً عسير التحقق.
أخيراً، فإن التأمل في التاريخ والسياسة تاريخياً وفلسفياً ونظرياً حق مشاعٌ ومهمة جُلّى، ولكن التحدي الحقيقي هو في تطبيق ذلك كله على الواقع، زماناً ومكاناً وحالاً، وطرح الأمثلة والأسماء والأحداث والتواريخ، وربط القديم بالحديث، والمقدمات بالنتائج.