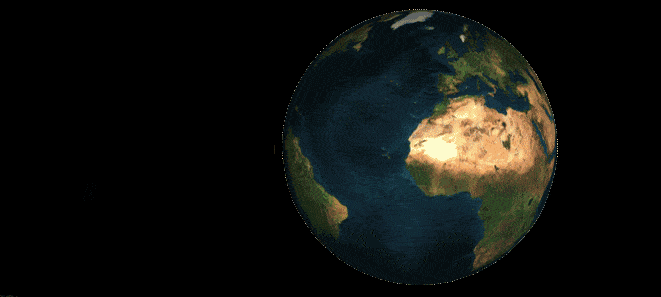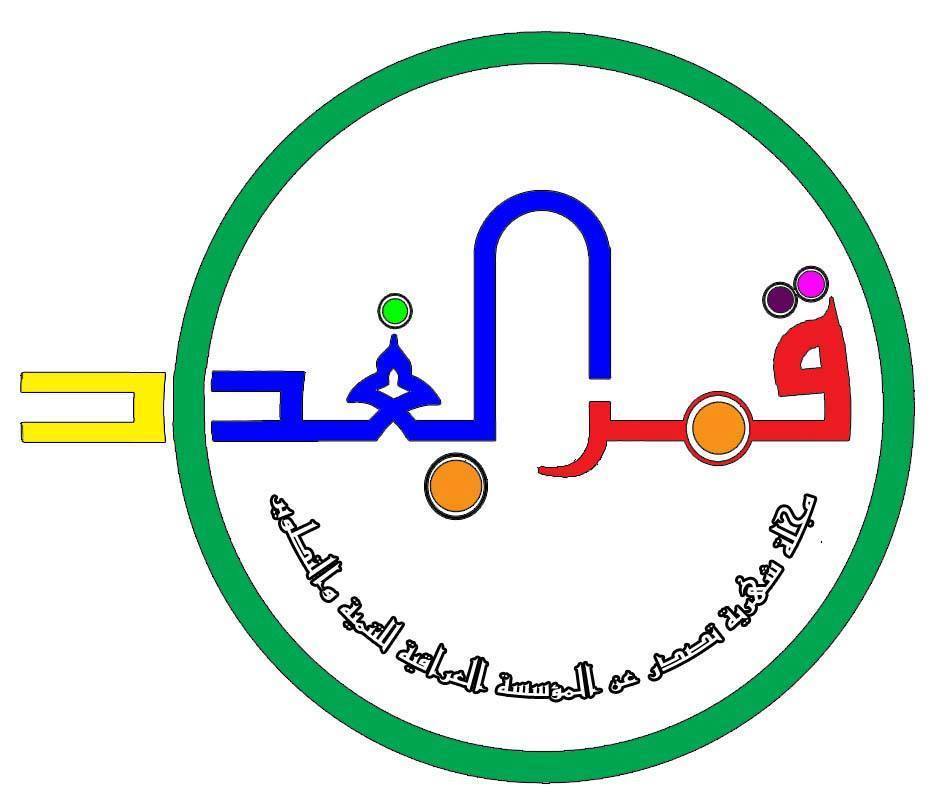محمد بدر الدين زايد
حاول كُثُر رصد الظاهرة الصينية في العقود الأخيرة، متابعين بإعجاب شديد ومستحق، كيف تحولت الصين عبر هذه العقود من دولة فقيرة مكتظة بالسكان والمعاناة إلى عملاق اقتصادي، كما ظهرت دراسات كثيرة وكذا معالجات إعلامية لا حصر لها، تتناول إمكانية تحول هذه القوة الاقتصادية الضخمة إلى قطب سياسي مؤثر دولياً، وتحدث البعض تحديداً عن أن اكتمال تبلور النظام الدولي المضطرب حالياً إلى نظام متعدد الأقطاب رهن باكتمال تحولات الصين نحو لعب دور سياسي دولي مهم.
وفي هذا الإطار، كان رصد بعض الظواهر كإقامة قواعد عسكرية خارجية، والنشاط الملحوظ لمبعوثي الصين في الأزمات العربية بوصفه تعبيراً عن هذه التحولات. وخلال مشاركتي في مؤتمر عقد أخيراً في السودان حول طريق الحرير وآثاره العربية والأفريقية، طرحت فكرة أهمية النظر إلى مبادرة الرئيس الصيني حول الحزام والطريق بوصفها التعبير الأيديولوجي لسعي الصين نحو تعظيم قدراتها الاقتصادية العالمية، وكذا تطلعها السياسي إلى الصعود قطباً دولياً مهماً وإن لم يكن مهيمناً، وأنها في هذا مثل أي قوة إمبراطورية أو دولة ساعية إلى أن تكون كذلك، يجب أن يكون لها طرحها الفكري والأيديولوجي المصاحب لخططها وتحركها الإستراتيجي الدولي، وأن هذه المبادرة قد تشكل المنطلق الدعائي لهذا التحرك. على أن اكتمال هذا الطرح له شروط وتجابهه صعوبات وتحديات، ونقطة البدء فيه تتطلب توصيف المبادرة الصينية في شكل موضوعي من دون مبالغات، فهي تتحدث عن مشروع كوني لربط الصين بالعالم القديم في إحياء عصري لطريق الحرير القديم الذي ربطها بأوروبا وأفريقيا مروراً بالعالم العربي، مغلّفة هذا بالتعايش والاعتماد المتبادل بين أطراف هذا الطريق. لكن ما يبدو حتى الآن ليس إلا تهيئة ظروف أكثر سهولة لعملية تدفق السلع والبضائع والاستثمارات الصينية، ومن ثم كان من الطبيعي أن تبدي الهند، جارتها اللدودة وخصمها التاريخي وشريكتها الحالية في الـ «بريكس»، تحفظاتها، وأن تستقبل هذه المبادرة ببرود ملحوظ. طبعاً، نعرف الحسابات الغربية المعقدة تجاه الصين وطموحاتها الكبيرة، وكيف تبذل مؤسسات الفكر والسياسة الغربية الكثير من الجهود للدعاية المضادة والمعادية للصين في أفريقيا، ويساعدها في ذلك بعض السياسات الصينية كالإغراق التجاري، وأن الطابع الغالب على الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية هو التركيز على قطاعات المقاولات والبناء، ويندر أن يمتد إلى القطاعات الصناعية، مع وجود بعض المشاريع الزراعية في بعض الأقطار الأفريقية التي تكرس وضع أفريقيا سوقاً ومصدراً للمواد الخام، وليس للمنتجات الصناعية. ومن الإنصاف القول إنه على رغم الدعايات الغربية، وكذا من بعض أقطاب القارة وبخاصة جنوب أفريقيا التي تنظر من زاوية منافسة الصين لمصالحها الاقتصادية، إلا أنه مع ذلك لم يتأكد وجود اتجاهات معادية للصين في شكل مقلق، وذلك بسبب سياسات عدم التدخل وتجنب المعايير المزدوجة التي تدمنها الدول الغربية في علاقاتها بدول الجنوب عموماً. ويؤكد هذا ما نشرته دراسة لمجلس الشؤون الخارجية الأميركي بناءً على استطلاع للرأي في عدد مِن الدول الأفريقية حيث كشفت استمرار غلبة الصورة الإيجابية للصين. لكن استمرار هذه الصورة الإيجابية ليس أمراً مضموناً دائماً أو في شكل مطلق. ففي عصر ثورة الاتصالات والتحوّلات الكونية التي يشهدها العالم لا تجعل من ثبات الصور النمطية أمراً ممكناً في ظل وجود مظاهر عدة للاعتلال، ما يجعل الصين مطالبة بمراجعة بعض سياساتها في شكل جدي، وبخاصة أنماط استثماراتها الخارجية، بما يساعد الدول التي تستهدفها اقتصادياً، أكثر قدرة على بناء شراكات حقيقية معها، خصوصاً في ما يتعلق بالتبادل التجاري المختل دوماً لصالح الصين في ما يتعلق بغالبية دول العالم.
من ناحية أخرى، بدأت الصين تتحرك في شكل أكثر إيجابية ونشاطاً في عدد من ملفات الصراع الدولي، أحدها تقليدي بالنسبة إليها وهي حال كوريا الشمالية، والثاني هو الملف السوري، بعد ما صدرت تصريحات وتلميحات عدة باستعداد الصين للمشاركة في إعادة الإعمار، وهو ما أشرنا إليه في مقال سابق حول سورية، وأن هذا الدور الصيني يمكن أن يشكل بداية حقيقية لدور صيني متنامٍ في الشؤون الدولية. ولعل النموذج السوري هنا يقدم لنا أيضاً التعبير الصحيح عن آفاق الصعود الصيني وتحدياته معاً. فصحيح أن الحسابات الرشيدة قد تبين أن هناك اعتماداً متبادلاً بين روسيا والصين في هذا الصدد، وبقدر حاجة الصين إلى مظلة روسيا، تحتاج روسيا إلى دعم طرف لديه فوائض مالية تعوّض من نقصها لدى روسيا وحلفائها، بما يتيح لهذه العلاقة التبادلية فرصة الصعود الصيني إلى منصة الفاعلين الدوليين. لكن تبقى دلالة هذا، وهي أنه على رغم القوة الاقتصادية الهائلة للصين وامتلاكها قوة عسكرية ضخمة، إلا أن نفوذها السياسي ما زال غير كافٍ للوصول إلى القوة الإمبراطورية. وهنا على سبيل المثال، فإن قوة أوروبية عظمى سابقة كفرنسا ما زالت لها مساحة من التأثير والنفوذ الدولي بما يفوق الصين. وهو ما تمكن ملاحظته في بعض البلاد الأفريقية وحتى مع الدول العربية التي تربطها بالصين علاقات ودية مستقرة وإيجابية في مجملها.
في المُحصِّلة، ليس هناك من شك في أن الصين تواصل صعودها الأسطوري كقوة اقتصادية هائلة، والأرجح أنها ستتمكن في زمن ربما ليس بعيداً، من أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم وتتحظى الولايات المتحدة في هذا الصدد. لكن أن تصبح القوة المهيمنة في العالم، فهذا ليس مؤكداً في أي شكل. هنا نذكر أن الإطار الأيديولوجي والحالة التي تمثلها الصين تتضمن نموذجاً للاعتماد المتبادل والتعايش لا يمثلها النموذج الأميركي العولمي الكوني القائم على التنافسية والتسلح. لكن تظل للطرح الصيني المضاد فرصة في إعادة صياغة العالم الذي سيتماشى قطعاً مع مصالح دول الجنوب. وبالنسبة إلى عالمنا العربي، فإنه ينبغي أن يطمح إلى استقامة مكونات الطرح الصيني، وإلى تخلي الصين عن سياسات الإغراق. الصين على أبواب إقامة أنماط جديدة من الشراكة مع دول «طريق الحرير الجديد»، وبخاصة في الجنوب، وعليها السعي إلى تحقيق المعنى الإيجابي للاعتماد المتبادل والندية، وأن تحدث تحولاً إيجابياً حقيقياً في بنية النظام الدولي، وهو أمر قد يبدو مثالياً لكنه الممكن الوحيد كي تحقق الصين طموحاتها ولا تنتهي مجرد قوة متنافسة في استمرارية لتاريخ البشرية من صعود القوى الإمبراطورية وهبوطها.