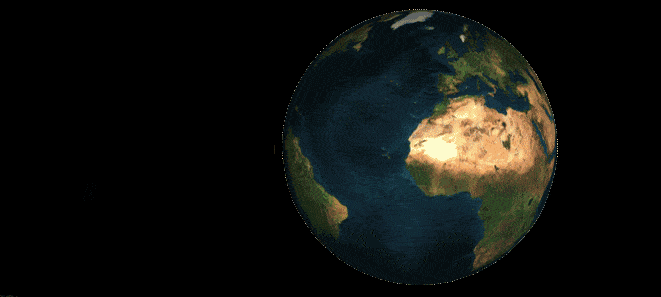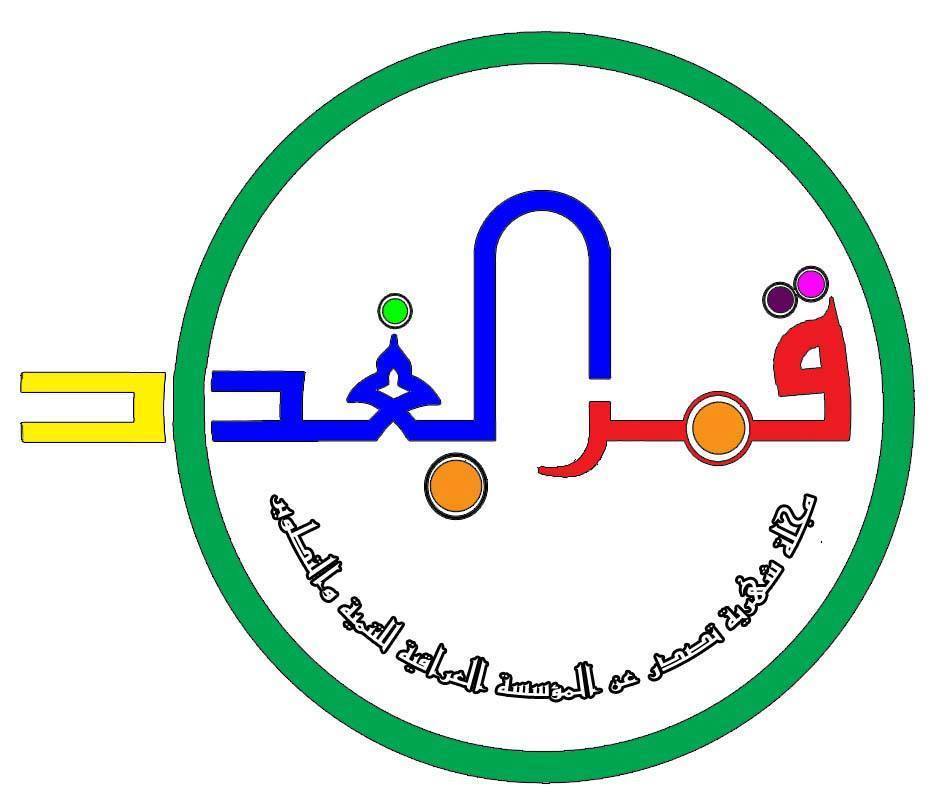د. رجب بن علي العويسي
في ظل معطيات المشهد العالمي المعاصر، يتعرض مفهوم التغيير اليوم للكثير من التدخلات والتشويهات تارة، والتحجيم والإقصاء تارة أخرى في محاولة تسييس مفهومه وتوجيه أطره إلى مقاصد أخرى ومسارات أبعد عن غاياته السامية وأهدافه النبيلة وأولوياته العصماء وأخلاقه التي تسمو بضمير الإنسان وأخلاقه وفكره وإنتاجيته، حتى أفقد هدفه وانحرف عن مساره، وضاع بين جملة المفاهيم والمصطلحات التي باتت تروجها منصات الإعلام غير المسؤول وتهيجها قنواته وفضائياته ويصرح بها صغار الساسة والمندفعون إليها والمدفوعون لها، والتي شكلت في مجملها انتكاسة لما صنعته البشرية في عقودها السابقة من توازنات، وما أوجدته من منصات التقاء وشراكات، ومؤسسات إقليمية ودولية لاجتماع الكلمة واحتواء الأفكار وضبط الخلاف ورسم معالم أقرب إلى لغة الحل وتعظيم قيمة المصالح المتبادلة والمشتركات الإنسانية.
لسنا هنا في معرض الحديث عن المشهد السياسي وحالات التغيير التي تشهدها المنطقة العربية وما زالت إرهاصاتها ومشاهدها واضحة للعيان، وإن كان مفهوم التغيير أصبح ملازما له دون غيره، فضُيّع المفهوم وضاع في عقم السياسة وترهلها، وغُيّب سلوك التغيير في مساحات ضيقة ومسارات متعرجة، في حين أن قناعتنا في التغيير أشمل وأوسع وأعمق من ذلك كله، فهو في كونه سنة كونية وقيمة إنسانية ومنهج في إدارة الحياة ونواميسها، فهو منطلق لتصحيح الممارسة ـ أيا كانت ـ وإعادة بناء الذات وتقنين الأدوات وإنتاج القوة وإعادة التوازن في تعاطي الإنسان مع مكونات عالمه ومعطيات واقعه المعاصر في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وبالتالي تنطلق الحاجة إلى التغيير من فرضية التحول التي يعيشها الإنسان المعاصر في مختلف المجالات الحياتية وما تبعها من تعدد المصالح وتباين الأولويات وتباعد الاهتمامات واختلاف الطرائق والأدوات ودخول الذاتية والفردانية في خط التغيير ورسم ملامح التوجهات، إذ ليست الحاجة للتغيير اليوم كما يتصور البعض في الأنماط والأنظمة السياسية فقط، بقدر ما هناك حاجات ماسة إليه في بناء مواطنة الإنسان وطريقة تعاطيه مع معيطات الواقع وإدارته له، لذلك سيتجه حديثنا عن صناعة التغيير في ذات المواطن وسلوكه، وفي طريقة تعامله مع متطلبات الواقع المهني والشخصي إلى حد سواء، ومستوى الجاهزية للتغيير في إدارة السلوك والقناعة به، كونه صحوة ضمير ومسارا للتجديد وزيادة مساحات الاختيار والتنويع فيها، واستشعارا بأن أي تحول يصنعه الإنسان في الواقع؛ إنما يتم وفق محددات واضحة ومراحل متعاقبة أساسها التغيير في الذات وترقية السلوك وإصلاح النفس وتحسيسها بالخطأ ومسؤوليتها عنه؛ لينطبع بالتالي على واقع الممارسة المهنية والسلوك الوظيفي، وما يطرحه اليوم من تساؤلات ونقاشات واستفسارات حول مستوى الاستجابة التي يمتلكها المواطن في التعاطي مع المتغيرات المتسارعة التي يعايشها في عالمه، ومع ذلك ما زالت مؤشراتها تعطي إشارة البطء والتعقيدات والروتين والترهل الوظيفي والبيروقراطية، لتعبر عن خلل في الممارسة وتعكس صورة قاتمة تحتاج إلى إزالة الضبابية عنها، ومسح أوجه القصور والتشوهات الحاصلة فيها، لتؤسس في السلوك ممكنات التغيير وأدواته وتبني فيه هويته النابعة من ثقافة المجتمع وأخلاقيات الإنسان فتصنع من التزاماته القوة وتتجه به إلى بر الأمان.
وفي الحالة العمانية وما تشهده من تحولات في منظومة العمل الوطني الساعية لتعزيز فرص التنويع الاقتصادي، والمتجه لتقوية البنية الأساسية الداعمة لها عبر تحسين فرص الاستثمارات الخارجية والإدارة الاستراتيجية للمدن الاقتصادية والمناطق الصناعية، والتوجهات المرتبطة برؤية عمان 2040، وجهود السلطنة في تعزيز خيارات التنويع كخيار استراتيجي تجند له خطط الدولة الخمسية، مستفيدة مما تحقق على أرض الواقع اكتمال البنية المؤسسية والتشريعية، والبنية الأساسية اللوجستية، واستثمار أفضل للمطارات والموانئ وإنشاء المناطق اللوجستية وتطوير شبكة النقل والاتصالات وشبكات الطرق وغيرها، والدعوات التي تتجه إلى ضرورة النظر في الممارسة المؤسسية وتأطيرها وتعزيز كفاءة الإنتاجية في الجهاز الإداري للدولة وما يرتبط بها من إعادة النظر في ممارسات البيروقراطية الإدارية والتطويل في الإجراءات الحكومية وكثرة العراقيل التي تقف في وجه تصحيح المسار الاقتصادي، والتثمير في فرص الدعم والتمويل، وبناء حضور أقوى للشركات الطلابية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة رسم موقعها في سوق العمل والمنافسة السوقية، والمنتج المتحقق من هذه الجهود في تشغيل الباحثين عن عمل وإدارة ملف القوى العاملة الوطنية والتعميق؛ كل ذلك وغيره يضعنا أمام مسار واحد أساسه، هل نمتلك إرادة التغيير لممارساتنا الشخصية والمؤسسية على حد سواء في تقليل فاقد العمليات المتكررة الناتجة عن البيروقراطية والترهل الوظيفي؟ وهل أحسنّا استخدام وتوظيف هذه الموارد والفرص الاستثنائية بشكل يعزز من استدامتها للأجيال القادمة، وما يستدعيه ذلك من الاستمرار في توفير حزمة من الإجراءات التغييرية ليس على مستوى الأدوات والآليات والحوافز والصلاحيات والتمكين، بقدر ما هو تغيير في القناعات والسلوك والثقة واحترام المسؤوليات؛ فمع أننا قد نشترك جميعا في الأحلام والطموحات ونتقاسم المشترك في رغبتنا في إحداث تحول ملموس في الممارسة الإدارية والتنظيمية سواء على ألسنة المسؤولين ومتخذي القرار أو من خلال الأطروحات المستمرة للكتاب والباحثين وخبراء الاقتصاد وغيرهم، وما تعكسه توصيات نواتج اللقاءات والملتقيات والندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية، في تشجيع الاستثمار وتقليل فاقد العمليات الإدارية والروتينية وغيرها؛ إذ جميعها تتجه في التعمق في المسار وتسعى إلى الإفصاح عن الهدف نفسه؛ إلا أنه في مرحلة الممارسة والتطبيق وعندما يتعلق الأمر بتقييم السلوك الحاصل في الممارسة، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسات في الحد من الترهل الوظيفي، والحد من زيادة التأخير في الإنجاز أو تعقد الإجراءات؛ تضيع أغلب هذه الأصوات في بحر لجي وتخفى في غياهب الجب؟
عليه نعتقد بأن مسألة التغيير لا ينبغي أن تقتصر على ما نقوم به داخل مؤسساتنا من تدشين البرامج وتوفير البرمجيات الحاسوبية سهلة الاستخدام ورصد المبادرات والتحديث في أنظمة العمل فحسب، بل في بناء الإنسان النموذج، صانع التغيير ومؤسس أرضيات نجاحه؛ القادر على حمل رسالة التغيير ومبادئها؛ إذ هو من يحوّل هذه المادة الخام في الأنظمة والبرمجيات المؤسسية المختلفة، والصفحات الالكترونية للمؤسسات في منصات التواصل الاجتماعي؛ إلى حركة ديناميكية وسلوك تنظيمي وأنظمة حياة، تحقق التميز، وتبني المهارة، وتقوي دافع الحافز، وتؤسس فرص المنافسة، وتصنع الموظف الذي يحقن هذه البرامج والأنشطة بأنسولين التغيير الإيجابي فيضيف إليها ويطور منها ويُحسن استخدامها، ويصنع منها محطة إنجاز، ومنطقا للمزيد من الشعور الإيجابي بجميل ما تحقق، فيعكس حضورها في ذات الآخر، استشعارا بأهمية وجودها والحاجة إلى تطويرها، وهو في كل ذلك يستقرئ فيها فرص تقوية روح المواطنة والانتماء لما يقدمه له الوطن من تسهيلات ويمنحه له من امتيازات، تظهر في سرعة الإنجاز والدقة والمعيارية في تقديم خدمة عالية الجودة، وعندها يعبر فيها عن قناعاته الإيجابية، وصدق الشعور بحجم ما تحقق من إنجاز يلامس الأذواق ويقترب من سقف التوقعات، فيكسبها من ضمير المسؤولية والأخلاق والمهنية ما يشيد بها حصون القوة، ويبني خلالها مسارات الوعي، ويصل بها إلى استنطاق القيم، وعندها تدخل الممارسة غرفة التشخيص والمراجعة والتصحيح والكشف عن ما يعتريها من مساوئ تسببت في تأخير مصالح الناس وتضييع حقوقهم أو غيرها، وتبقي مسؤولية المواطن في التغيير نافذة بما يمتلكه من ثقافة التغيير وأحكامه وحدوده، فيستشعر أنه مسؤول عن أي إخفاقات، في نطاق عمله كما أنه شريك في رسم فرص النجاح.
من هنا فإن الحديث عن صوت التغيير في حياة المواطن، لا يكفي أن يكون مجرد حالة صوتية أو فرقعات كلامية أو سلوك اندفاعي وقتي توجه سهامه نحو الأوطان والإساءة إليها والعبث بمقدراتها أو تشويه صورة المنجز الحضاري الوطني، أو توجيه الأنظار لممارسات فردية لا تمثل المؤسسات؛ بل أن يقف دوره في إدارة التغيير عبر استشعاره للمسؤولية وإدراكه بحجم النقص الذاتي وإعادة هندسة النفس وتخليها الاختياري عن نزغة الأنا والأثرة والمصالح الشخصية واستغلال الموقع والمنصب أو الوظيفة العامة؛ إلى استدراك الصالح العام والتفكير الجمعي، وتوجيه الذات نحو تلمس الصدق والأمانة والمسؤولية والمهنية والعدالة في كل خطوات إنجازها، ومحاكمتها على تقصيرها، وعندها ستزول كل البقع المضللة والشوائب المترسبة والأفكار المسيئة، لتفصح الممارسة عن ثوبها الجديد، فإن نواتج الإنجاز ستكون سليمة صالحة، متناغمة مع التوقعات مستجيبة للطموحات فتترجم الأفعال الأفكار وتزول حواجز التكامل وتذوب منغصات العمل، وتتلاشى أصوات التذمر والامتعاض وتقترب كل الجهود من استشراف الأمل الموعود والهدف المقصود المعبر بصدق عن إرادة مواطن وأخلاقه واستشعاره لمسؤولياته وحرصه عن وطنه وانتمائه وولائه، فإن التغيير الذاتي عندما يلتصق بجدار المسؤولية، ويقترب من ضمير الواجب، ويتفاعل مع حس الشعور، ويستقرئ ردود الأفعال ويدير المشاعر ويفهم ما يدور في فلك الممارسة ويستمع لهمسات من نالتهم إخفاقاتها أو من جانبهم الصواب في أدائها، وعندها لن يكون هناك حديث في المجتمع عن إشكاليات في التمويل والاستثمار وإدارة المشروعات، بقدر ما هو توظيف للفرص وصناعة للبدائل وتنافسية في المنتج وتفوق في الإدارة.
ويبقى التساؤل الذي يبحث عن إجابة له في سلوك المواطن، كيف يمكن للمواطن في ظل هذه المعطيات الاقتصادية وجدية الطرح والانتقاء للبدائل والتجريب المستمر لها وإعادة تقييم القائم منها في الانتقال لمسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الكفاءة الإنتاجية في الجهاز الإداري للدولة؛ أن يمارس دوره في إدارة التغيير بكفاءة عالية، فيوظف تنوع المعطيات والفرص المتاحة بشكل يعيد فيها إنتاج ممارسته المهنية فيكسبها القوة ويضمن التزامها المسار، ويحقق خلالها المنافسة بدلا من أن ينتظر الإملاءات ويلقي على غيره التهم في تضييع المسؤوليات؟