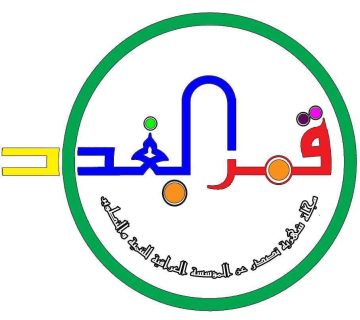الرأسمالية ووهم السعادة… لماذا يجرّعونك التفاؤل عنوة؟!


محمد علواني15 أغسطس 20229 د-ADVERTISEMENT-
ليس من العسير إيجاد رابطة/علاقة بين الرأسمالية والسعادة، أو حتى تتبع هذه العلاقة وفق حقب زمنية معينة؛ إذ يمكن القول إن إنسان القرن السابع عشر -وهو قرن الحداثة الأول تقريبًا- كان أكثر سعادة؛ فهناك كان نظام المنافسة قد بدأ أولى خطواته، كما كان العالم يعجّ بالفرص.
أما إنسان القرن الحادي والعشرين فلا شك أنه الأتعس على مر التاريخ، والعجيب أن كل شيء أمسى متوفرًا الآن، وكل شيء صار تحت أيدينا، من أجهزة تكنولوجية وأدوات تقنية ووسائل مواصلات.. إلخ، ونحن نتحكم فيها وتتحكم هي فينا، وفقًا لطرح كارل ماركس حول الاغتراب، لكن المؤكد أننا لا نتحكم في حياتنا قيد أنملة، وإنما يتحكم فيها وفينا سدنة الرأسمالية الكبار، والشركات العملاقة التي لا هدف لها سوى مراكمة الربح وتعزيز مكاسب أصحاب رؤوس الأموال.
معضلة الرأسمالية أو الشيء وعكسه
من المعروف أن الرأسمالية المتقدمة هي نظام اقتصادي وثقافي كلي يمارس تأثيرًا عميقًا على رفاهية الفرد، وصحيح أنها إلى ازدهار كبير منذ الحرب العالمية الثانية وكانت ذات فائدة كبيرة للرفاهية؛ حيث وفرت مستويات من الحرية الشخصية والسياسية، فضلًا عن البنية التحتية، والصحة، والمؤن الاجتماعية التي لم يسمع بها على مدار معظم تاريخ البشرية. ومع ذلك، أدت المستويات المتزايدة من عدم المساواة داخل بلدان الرأسمالية المتقدمة بالإضافة إلى الركود الاقتصادي، إلى تقلص الفرص وزيادة انعدام الأمن للعديد من المواطنين.
في مجتمعات الرأسمالية المتقدمة، يكون النمط الشامل للأيديولوجيا عبارة عن مجموعة من القيم القائمة على المصلحة الذاتية والأساليب الشخصية المتجذرة في المنافسة، والرغبة القوية في النجاح المالي، ومستويات عالية من الاستهلاك، والإيمان بضرورة النمو الاقتصادي.
في النموذج المقترح للرأسمالية المتقدمة والرفاهية، أصبح هذا السياق الثقافي الكلي مرتبطًا بالتحولات نحو درجات أكبر من المادية والفردية، مصحوبة بزيادة عدم استقرار الروابط الشخصية وعدم استقرار التوظيف.
وقد انخفض الأمن النفسي والاستقرار الذي توفره الحياة الأسرية والتوظيف تقليديًا في مجتمعات التكييف بشكل كبير خلال الخمسين إلى الستين عامًا الماضية.
إلى جانب هذه التطورات، فإن قيم وممارسات ثقافة المستهلك، أي عمليات التنشئة الاجتماعية الخاصة بالتيار المتردد، تحكّمت بشكل تدريجي في التنشئة الاجتماعية. يُعتقد أن التوجهات الفردية والمادية لثقافات الرأسمالية المتقدمة تساهم في صعوبات يواجهها الناس في تكوين روابط مستقرة في هذه المجتمعات.
أدى التنوير وصعود رأسمالية السوق إلى تغيير الثقافة الغربية؛ حيث أصبحت الفردية الروح المهيمنة، مع تحقيق الذات والأصالة الشخصية أعلى الخيرات، أصبحت السعادة حقًا أساسيًا، وهو الشيء الذي يحق لنا كبشر.
يتتبع كتاب “خيال السعادة” لكارل سيدرستروم، أستاذ الأعمال في جامعة ستوكهولم، المفهوم الحالي للسعادة إلى جذوره في الطب النفسي الحديث وما يسمى بجيل الإيقاع في الخمسينيات والستينيات.
يجادل بأن قيم الحركة المضادة للثقافة -التحرر والحرية والأصالة- تم اختيارها من قبل الشركات والمعلنين الذين استخدموها لتكريس ثقافة الاستهلاك والإنتاج. وهذه الثقافة الفردية المفرطة تجعلنا في الواقع أقل سعادة مما يمكن أن نكون.
تطرف التقدم في الرأسمالية
وأعجب ما في الرأسمالية أن المؤسف فيها ليس كونها لم تتقدم وإنما أنها تقدمت بشكل مفرط، وهذا الإفراط في التقدم، هو الذي أدى إلى كل هذه الكوارث التي يرزح النوع البشري تحت نيرها؛ فما إن دارت عجلة التقدم حتى انطلقت بسرعة هائلة غير متوقعة، لكنها، وللأسف، انحرفت، وبنفس السرعة، عن القضبان.
وهو الأمر الذي يعني أن المأمول صار واقعًا متحققًا، وهنا مكمن المشكلة، فالتقدم أمسى:
وضعًا قائمًا أكثر من كونه وعدًا آتيًا، بدلًا من أن نسير بخطى سريعة في مدارج المستقبل بتنا نرزح تحت وطأة حركة جامدة شرسة
الرأسمالية وكارثة المجتمع المفتوح
اعتقد كارل بوبر أن المجتمع المفتوح -قدّم كتابًا كاملًا حول هذه الأطروحة- سيؤدي مباشرة إلى الرفاهية والسعادة، وسيصل الجميع إلى حالة من السعادة القصوى، فالمجتمع المفتوح يعني ألّا حدود.
ولكن نظرًا للنتائج السلبية التي أدى إليها تقدم الرأسمالية، فقد ندد “زيجمونت باومان” بأطروحة “المجتمع المفتوح” التي قدمها كارل بوبر؛ فانفتاح المجتمع سيكون ذريعة للظلم الاجتماعي؛ إذ إن العولمة سوف تبسط جناحيها ليس على هذا المجتمع أو ذاك وإنما على العالم برمته، ولن يكون ثمة مهرب ولا ملجأ منها إلا إليها، كما أن هذا المجتمع المفتوح سوف ييسر دخول آليات العولمة، وبالتالي إحداث فروق هائلة بين سكان المجتمع الواحد، فضلًا عن تلك الفروقات بين هذا المجتمع كله وبين المراكز الميتروبوليتانية وحواضر رأسمال المال. فـ “أسواق بلا حدود، والكلمة لباومان، وصفة للظلم والخلل العالمي الجديد”.
فالعولمة، كما يقول إريك هوبزباوم في كتابه “العولمة والديمقراطية والإرهاب”، في نموذج رأسمالية السوق الحرة الذي بات الآن طاغيًا، جلبت زيادات رهيبة في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار على الصعيدين المحلي والدولي.
وقد وصفت “باسكال بروكنر” مفارقة العولمة بفصاحة منقطعة النظير أنها “التماثل في الحال دون الترابط في المآل”(باسكال بروكنر، بؤس الرفاهية، ص13) وهي هنا تشير إلى ما أشار إليه “أولريش بيك”، حين كان يتحدث عن المخاطر التي تهدد العالم الحديث، ولكن بطريقة أخرى، فالكوارث باتت تجتاح العالم برمته؛ نظرًا لأن العولمة شوهت الزمان والمكان، ولأنها، أي العولمة “تغير في السلم وفي الحدة وفي السرعة”، ولكن كل منا يمكنه حماية نفسه من هذه الكوارث بطرائقه الخاصة، وحسب موقعه الاجتماعي، وبما يمتلكه من قدرات وإمكانات.
وعلى الرغم من ذلك فإن “زيجمونت باومان” يعظنا بعدم الوقوف في وجه العولمة، فمضاداتها والوقوف في وجه سيرورات تحققها غير مجدية على الإطلاق، فـ “السؤال، كما يقول “باومان” في كتابه “الأخلاق السائلة”، ليس عن كيفية إعادة نهر التاريخ، ولكن عن كيفية الكفاح ضد تلوثه بالبؤس الإنساني، وكيفية توجيه تدفقه؛ لكي يحقق توزيعًا أكثر تساويًا لما يحمله من فوائد”.
وباختصار يتمثل الأمر أو بالأحرى المهمة الواقعة على كاهلنا في اختراع نظام عالمي جديد تُداوى فيه جراحات الجنس البشري وتتحسن فيه شروط وجوده، ويجمع بين طياته محاسن كل الأنظمة والأيديولوجيات السابقة عليه من رأسمالية واشتراكية …. إلخ.
“إن ردًا على العولمة، يقول زيجمونت باومان، لابد أن يكون عولميًا، ومصير رد عولمي كهذا يعتمد على ظهور وتمترس ساحة سياسية عولمية، ….، إن ساحة كتلك هي ما تُفتقد بشكل واضح اليوم”.
يتعين علينا، إذًا، أن نتبع نصيحة الروائي الإيطالي “إيتالو كالفينو”، وأن ندرك الجحيم، وأن نراها بعمق، لنتعلم كيفية التعامل معها، لا أن ندفن رؤوسنا في الرمل ونهرب من ميدان المواجهة.
العلم ينير الأبصار ويعميها أيضًا
لم تعد فكرة التقدم هي القانون الناظم للتاريخ، وإنما تخلت عن مكانها لصالح اللايقين والمخاطر وصنوف التهديدات، وكلها تصب بلا شك في بوتقة تعميم البؤس والتعاسة، فلقد تبدلت كل المقولات الكبرى، وفقدت الكثير من بريقها؛ فلم تعد تجذب الأسماع كما كان في الماضي، فالكثير منها بات ينطوي على تناقضات جمة وخليط من الخير والشر.
فما يسميه “إدغار موران” في كتابه “هل نسير إلى الهاوية” محركًا رباعيًا قاصدًا به: العلم، والتقنية، والاقتصاد والربح، كان من المفترض أن يخلق التقدم ويعزز السعادة، لكنه صار يدفع مركبتنا الفضائية (الأرض) إلى موت مزدوج؛ موت المجال الحيوي، والموت النووي. وإذا كان من الثابت أن العلم ينير العيون فإنه في الوقت الحاضر يعمي الأبصار.
وإزاء هذا الوضع المتردي على شتى الصعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، بات في مقدورنا الحديث عن ثلاثية متماسكة صلبة تجمع “التقدم والخوف والخطر” فهذا ثالوث مقدس، يحيل بعضه إلى بعض، من دون وجود بداية أو نهاية محددة.
السعادة والاختيار والقلق
تروّج ستاربكس للمبدأ التالي: “السعادة تكمن في اختياراتك”، ولقد قيل لنا أنه بدون الحرية لا يمكننا أن نكون سعداء، وأن الحرية، إذا اختصرت بالأساسيات، تعني ببساطة الاختيار.
أصبحت هذه السردية مركزية للاستهلاك الضروري للنظام الرأسمالي؛ إذ تصبح الحرية مقتصرة على الاختيار، وبعد ذلك يتم تقييد هذه الخيارات بواسطة الرأسمالية؛ ما يجعل الأشخاص العقلانيين عادة يبدؤون في الدفاع عن فكرة أن وجود نوع واحد فقط من الحليب، أو الهاتف.. إلخ من شأنه أن يسحق جزءًا أساسيًا منا ويجعلنا غير قادرين على الفرح أو السعادة مهما كان ثمنها أو جودتها. إنها أيضًا طريقة سهلة للغاية لتقديم وتطبيع خصخصة الخدمات.
ويترتب على المنطق أنه كلما زادت الاختيارات المتاحة، زاد عدد الأشخاص لاتخاذ الخيارات الأكثر ملاءمة لأنفسهم؛ ما يزيد من الحرية الفردية وبالتالي السعادة. تعتمد الرأسمالية على إدامة فكرة الاختيار هذه ومفهوم الاستهلاك أي السعادة من أجل الحفاظ على شراء علامة تجارية على الأخرى.
ولكن المفارقة الغريبة أن وجود علامات تجارية متعددة للاختيار من بينها يخلق مزيدًا من القلق بشأن الاختيار الصحيح، بدلًأ من طمأنة المستهلكين بشأن حريتهم أو صحة الاختيار. يتم التغاضي عن حقيقة أن معظم الخيارات ربما تكون مملوكة لنفس الشركة الأم. وهم التنوع هو نكهة الحياة المبتذلة.
لا تعتمد ديناميكية الاختيار والسعادة هذه على الرغبة في الحصول على نتيجة أفضل لعدد أكبر من الناس، أو النظام الطبيعي للأشياء: إنها ببساطة طريقة لتعزيز معايير السوق.
يؤدي الاختيار بالفعل إلى مزيد من السعادة، إلى حد معين، ولكنه ليس خطيًا أو واضحًا؛ وبالنظر إلى الخيارات المتزايدة وغير الضرورية، فإننا نصبح أكثر بؤسًا.
السعادة في ظل الرأسمالية هي وهم بقدر ما هي الخيار الذي تتوقف عليه. إن حل هذه المشكلة واضح: يجب أن نتوقف عن “اختيار” الرأسمالية.
كن سعيدًا وإلا فشلت
لا يهم النظام الرأسمالي أن تكون سعيدًا أو بائسًا، ما يهمه فقط أن تكون أكثر استهلاكًا كل يوم عن اليوم الذي قبله، ومع ذلك يشغله أيضًا التسويق لصورة مجتمع هانئ وسعيد؛ فترى في الإعلانات عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات أناسًا فاغري الأفواه، تملأ البسمة وجوههم، ولا تعرف لهذه الابتسامات سببًا، ولكن الشركات الكبرى لا تترك لك الفرصة لتفكر وإنما تسارع إلى إخبارك: منتجنا سر سعادتهم، فهيا استهكله الآن وستكون سعيدًا مثلًا.
تسهر الرأسمالية على صورة هذا المجتمع، ولذلك وجود الأشخاص البائسين يعد طعنًا في هذه الصورة، كمن يسكب سائلًا لزجًا على لوحة فنية جميلة. بهذا المعنى أمست السعادة واجبًا اجتماعيًا أكثر من كونها شعورًا داخليًا أصيلًا.
وإذا لم تكن سعيدًا فقد فشلت. هكذا تقول الرأسمالية، فما الذي ينقصك لكي تكون سعيدًا؟! هكذا بكل ببساطة. على الرغم من أن الناس الآن قلقون من الفشل، وفقدان السعادة -إذا وجدت- بالإضافة إلى خوفهم من الخسارة.
يعد التعامل مع الخسارة مصدر قلق كبير اليوم. تقول عالمة الاجتماع ريتانا سالكل: “الخسارة التي يتعين علينا جميعًا أن نتعامل معها في النهاية هي الموت. حيث لا يوجد خيار آخر. ومع ذلك، عندما نحاول السيطرة عليه، فإن ما نفعله هو إطالة أمد محاولة السيطرة على الموت”.
الثراء والاكتئاب أو خدعة الـ Life Coach
لم يكن الغرب أكثر ثراءً من أي وقت مضى، ومع ذلك فإن استخدام مضادات الاكتئاب في ازدياد لدرجة أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنها مصدر قلق رئيسي.
لا يتعلق الأمر بمرافعة عن الفقر بطبيعة الحال، ولا تبرير وجوده، وإنما يعني في المقام الأول الإشارة بأصابع اتهام واضحة إلى نظام اقتصادي لا يكف عن الكذب والتدليس، انظر على سبيل المثال إلى الكذبة المسماة Life Coach وهي بنت الرأسمالية وصناعتها، ما الذي تقدمه حقًا؟ ماذا يمكن للمرء أن يتعلم من هؤلاء الناس؟
لا شيء سوى أن يكون كذابًا، بل أن يكون أول الكاذبين على نفسه، تخلق Life Coach نسخة معيبة من الإنسان، بدلًا من أن تعمل على تغيير الواقع تقبل به على علاته، ظنًا منها أن هذا سبيل السعادة، والحق أنه أقصر طريق للبؤس.