كتاب حديث عن “أميركا والشرق الأوسط” يستعرض تناقضات السياسة الخارجية ويطرح فرضية “الحد الأدنى” للقبول بنتائج الانتخابات


رجل يحمل لافتة خارج مبنى الكابيتول الأمريكي في 5 يناير 2022 قبل أحداث الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير (أ ف ب)
بات السادس من يناير (كانون الثاني) في الولايات المتحدة تاريخاً أيقونياً آخر، لا يقل أهمية عن الـ11 من سبتمبر (أيلول). فلو أن التاريخ الأخير هو الذي أفاقت فيه أميركا على حقيقة أنها ليست القوة المنيعة التي لا يمكن النيل منها في عقر دارها، فقد أفاقها التاريخ الأول على حقيقة أن ديمقراطيتها القديمة الراسخة قد لا تكون بالقدر الموهوم من القوة، وأن قسماً كبيراً من الأميركيين لم يعد يحترم النتائج التي تنتهي إليها عملية الانتخاب الديمقراطي إذا خالفت هذه النتائج رغباتهم.
ألم يكن مثل ذلك يحدث أحياناً على النطاق العالمي، ألم تكن الإدارة الأميركية تفعل ما يوازي اقتحام الغوغاء للبرلمان اعتراضاً على نتائج انتخابات في بلاد أخرى، ألم تكن الإدارات الأميركية المتعاقبة تفضل في بلاد كثيرة حكاماً طغاة موالين لها على حكام منتخبين ديمقراطياً لكنهم غير مضموني الولاء؟
ذاقت أميركا إذن من الكأس نفسها. ولكن، ينبغي أن يكون يوم السادس من يناير ذلك يوماً غير سعيد لكل من يرتقي على هذا المستوى من الشماتة البغيضة. لأنه يوم تزعزعت فيه إمبراطورية راسخة، كما يجب أن يكون هذا اليوم فرصة لبحث سبل تحصين الديمقراطية التي مهما بلغت من القوة تبقى بحاجة إلى تجديد دعائمها.
لمناقشة علاقة الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط أو بتقديم فكرة الديمقراطية وممارستها في المنطقة، صدر حديثاً كتاب عنوانه “مشكلة الديمقراطية: أميركا والشرق الأوسط وصعود الفكرة وانهيارها” للباحث الأميركي، مصري الأصل، شادي حميد، زميل معهد بروكينغز والمحرر في مجلة “ذي أتلانتيك” وكلاهما من معاقل الليبرالية الأميركية، لكن الكتاب يصلح أيضاً مبرراً للنظر من جديد في مفهوم الديمقراطية ذاته. هل الديمقراطية في غاية ذاتها، أم هي محض وسيلة؟
في استعراضه للكتاب (غارديان 18 يناير 2023) يوجز جوناثان فريلاند طرح شادي حميد في سؤال كبير: هل يجب أن تطالب الولايات المتحدة بلاد العالم بالليبرالية، أم يجب أن تكتفي بالديمقراطية؟ يكتب فريلاند أن القضية التي يطرحها شادي حميد هي أنه عندما يتعلق الأمر بمواقف الولايات المتحدة تجاه العالم الخارجي، والشرق الأوسط بصفة خاصة فإن ثمة “معضلة ديمقراطية” تتمثل في “أننا نريد الديمقراطية نظرياً، لكننا لا نريد بالضرورة نتاجاتها عملياً”.
الربيع العربي والانقلاب
ويستشهد حميد بالربيع العربي في عام 2011، وبتجليه في القاهرة على وجه التحديد، فيقول إن صناع السياسة الأميركيين كانوا يناصرون الديمقراطية في مصر خطابياً أشد المناصرة، إلى أن جاءت الديمقراطية بمحمد مرسي رئيساً لمصر، فكان هذا الاختيار إنذاراً لواشنطن، إلى حد أن الولايات المتحدة لم تأسف حينما شهدت إطاحة مرسي في غضون 12 شهراً من انتخابه. فإذا بباراك أوباما الذي كان قد ذهب إلى القاهرة مسلحاً بمواهبه الخطابية متغنياً بأمجاد الديمقراطية، يرفض حتى أن يطلق على إطاحة مرسي انقلاباً.
لكن قراءته تلك للأحداث يمكن وصفها على أقل تقدير بأنها خلافية، ما لم توصف بالمغرضة. فلم يكن موقف الولايات المتحدة من الإسلاميين في مصر بهذا الرفض القاطع، ولم يكن رفض أوباما وصف إطاحة مرسي بالانقلاب العسكري نتيجة كراهية من الولايات المتحدة لذلك الحكم الإسلامي، لكنه كان محض مجاراة لقانون أميركي يمنع الولايات المتحدة من تقديم أي دعم لنظام حكم انقلابي، فكان مجرد استعمال الإدارة الأميركية مصطلح “الانقلاب” كفيلاً بإرغامها على وقف مساعداتها لمصر المستمرة منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، أي إن كلمة كانت كفيلة إن تفوه بها أوباما أن تغير وضعاً مستقراً في الشرق الأوسط منذ عقود، وهو أمر ما كان ليروق لإسرائيل، ولا كان ليخدم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ولا كان ليمر بغير رد فعل مصري غير مرغوب فيه أميركياً وإسرائيلياً.
ربما كان ليخدم شادي حميد فكرته بمثال آخر يدلل به على أن أميركا لا تقبل بنتائج الديمقراطية في الشرق الأوسط إذا ما خالفت أهواءها، وهو واضح في حالة “حماس”، فقد أدت انتخابات ديمقراطية روقبت عالمياً، وأجريت بنزاهة شهد بها مراقبوها، إلى أن تمكنت “حماس” قبل سنين قليلة من الفوز فصار يحق لها بقوة الديمقراطية أن تقود الإدارة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، ولم يتسن ذلك، ولم تقبله الولايات المتحدة. وربما يكون من المفيد أيضاً أن يتأمل شادي حميد موقف الإدارة الأميركية من نتيجة انتخابية كريهة أخرى هي التي رجعت بنتنياهو، أخيراً، إلى الحكم في إسرائيل على رأس حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لكن أميركا هذه المرة لن ترفض التعامل مع هذه النتيجة الانتخابية البغيضة. وإذن فالأمر يتعلق بدرجات من البغض في النتائج، ويتعلق بمناورات سياسية كثيرة، ويتعلق أولاً وأخيراً باعتبار مهم هو القدرة على رفض النتائج أصلاً.

خلال فض اعتصام لأنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي (أ ف ب)
على أي حال، ربما يخطئ شادي حميد لأسباب تخصه، في ضرب المثال لكنه لا يخطئ في مضربه. نعم، الولايات المتحدة لا تقبل بنتائج الديمقراطية في العالم، وفي الشرق الأوسط بالذات، حينما تستطيع أن ترفضها. والولايات المتحدة تجد أن الديمقراطية في بعض الأحيان تفرز نتائج لا تبرر دعمها، أي دعم الديمقراطية نفسها.
وليست هذه المعضلة مقصورة على الشرق الأوسط. فكثيراً ما يحدث أن يجد الديمقراطيون أن الوسائل الديمقراطية تؤدي إلى نتائج غير ليبرالية، وكثيراً ما حدث ذلك في الفترة الأخيرة حيث وضعت الانتخابات الحرة السلطة بين أيدي ساسة ينتمون إلى أقصى اليمين المتطرف، بل حدث ذلك في الولايات المتحدة نفسها قبل ست سنوات فقط.
يواصل فريلاند إيجازه لطرح “مشكلة الديمقراطية” قائلاً إن حل حميد معضلة الديمقراطية في رأيه يتمثل في الفصل بين الديمقراطية، أي طريقة الشعوب في تحديد اختياراتها، والليبرالية، وعلى رغم تأكيد حميد أنه على المستوى الشخصي يبقى ليبرالياً، ملتزماً بحقوق الإنسان، والحرية الفردية، والمساواة الجندرية، فإنه يرى أنه لا ينبغي أن تستمر الولايات المتحدة في وضع هذه المبادئ في حزمة واحدة مع الديمقراطية، ولا ينبغي أن تستمر في مطالبة البلاد الأخرى بالحزمة كاملة، بل يجب بدلاً من ذلك ألا تطلب واشنطن أكثر من “الديمقراطية في حدها الأدنى”، أي أن تطالب للشعوب بكلمة عادلة في من يحكمونهم.
ولمزيد من الإيجاز لمقترح حميد، يمكن القول إنه “الديمقراطية في حدها الأدنى” أو الـdemocratic minimalism. يكتب فريلاند أن هذه الفرضية قد تتعثر في عقبة مبكرة، فـ”في ضوء ما تم تلقينه للأميركيين في السنين القليلة الأخيرة من تعليم حول أهمية المعايير الديمقراطية، هل يمكن أن يعد نظام حكم ديمقراطياً حقاً في حال تجرده من المظاهر الليبرالية؟ في الواقع، حينما نتكلم عن ’الديمقراطية’ أليست هذه الكلمة اختصاراً لـ’الديمقراطية الليبرالية’ التي تتضمن حرية الصحافة والقضاء المستقل وحرية التجمع؟”.
يتوقع حميد ذلك التحدي لكنه، في ما ينقل عنه فريلاند، يرى أن أساسات الديمقراطية مدرجة في الحد الأدنى لتطبيق المصطلح، وأن على صناع السياسة الأميركيين الانصراف عن السعي إلى تحقيق نتائج ليبرالية في البلاد حديثة العهد بالديمقراطية، فقد “تصدر حكومة ديمقراطية جديدة في دولة عربية ما تشريعاً يسمح على سبيل المثال للنساء بأن ترث أقل مما يرث الرجال، لكن لو أن ذلك ما صوت لأجله شعب تلك الدولة، فيجب أن تتقبله الولايات المتحدة، وتترك الدعم العسكري مستمراً”.
يكتب فريلاند أنه “لن يتوقع كثيرون أن تتحول فرضية (ديمقراطية الحد الأدنى) عما قريب إلى سياسة خارجية للولايات المتحدة. فمن الصعب أن نتخيل جو بايدن وهو يقول لنشطاء الحزب الديمقراطي، إنهم يجب أن يرضوا بدعم دول تقيم انتخابات بغض النظر عن انتهاكات حقوق المرأة أو المثليين، لكن من المؤكد أن حميد محق في قوله إن استمرار النهج الراهن والقديم- أي ترحيب الولايات المتحدة بشراكة مع نظم حاكمة لا هي ديمقراطية ولا ليبرالية- لا ينبغي أن يكون خياراً من الأساس”.
في استعراض للكتاب منشور في موقع معهد بروكنغز، يكتب سفير أميركا السابق لدى روسيا مايكل مكفول، معترفاً أن الولايات المتحدة فشلت في الارتقاء بالشرق الأوسط إلى مستوى مثلها التي فرضتها على نفسها، فـ”حينما تصل إلى السلطة أحزاب إسلامية عبر انتخابات حرة، كثيراً ما تتخذ الولايات المتحدة مواقف متناقضة أو معارضة، مفضلة عليها طغاة مرنين”.
ويكاد مكفول، يجد في طرح حميد طوق نجاة، فـ”قبل قراءتي كتاب حميد الجديد، كنت أومن بتواشج الليبرالية والديمقراطية، وبضرورة انفكاك الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، لكنني الآن أرى قيمة دعم (ديمقراطية الحد الأدنى). فالحقيقة أن دعم هذا المفهوم الجديد إذا ما تبنته الولايات المتحدة على المستوى الرسمي سيحل مشكلتها لا في الشرق الأوسط وحده، وإنما في مناطق كثيرة من العالم باتت الديمقراطية فيها تفرز من يعبرون عن أحط المعتقدات والنزعات”.
فمشكلة الديمقراطية- كما يكتب مكفول نفسه “لم تعد مقصورة على الشرق الأوسط وحده، إذ إن آثار الاستقطاب على الهوية والثقافة والدين تستولي على أرسخ بلاد العالم الديمقراطية. وفي أميركا يدرك عدد متزايد من الناس أن احترام نتائج الانتخابات عند فوز الفريق المنافس أيسر نظرياً منه عملياً”.
خطاب أبراهام لينكون
في استعراضه للكتاب (مجلة كومنتاري – ديسمبر 2022)، يكتب برايان ستيوارت أنه في ثنايا قراءته لكتاب “مشكلة الديمقراطية” لم يتوقف عن استحضار خطاب أبراهام لينكون الشهير الذي أعلن فيه الأب الأميركي المؤسس أن كراهيته للعبودية تقوم على أنها تحرم “مثالنا الجمهوري من نفوذه المستحق في العالم” ذلك أن العبودية “مكنت أعداء الحرية من معايرة أميركا ووصفها بالنفاق، وشككت كذلك أصدقاء الحرية في إخلاص أميركا، ودفعت كثيراً من الأميركيين إلى حرب مفتوحة مع أخص مبادئ الحرية المدنية”.
يكتب ستيوارت أنه “لو أن خيانة أميركا لمثال الديمقراطية في مسألة العبودية قد شوهت صورتها آنذاك، فإن ظاهرة مماثلة قد تكون جارية الآن بشكل معكوس، لأن إهمال أميركا للأخلاقيات الديمقراطية في الشرق الأوسط أدى إلى تفاقم فقدان الأميركيين أنفسهم الإيمان بالديمقراطية في الوطن” ولعل هذا ما بلغ ذروته في أحداث السادس من يناير.
يرى حميد، بحسب ستيوارت، أن استرداد أميركا لـ”النفوذ العادل” في العالم، وحل مأزقها أو تخفيفه على الأقل، يتطلب الفصل بين الليبرالية والديمقراطية، للسماح للولايات المتحدة بالتركيز على الدفاع عن الديمقراطية وحسب. ويكتب أن “ديمقراطية الحد الأدنى هذه من شأنها أن تعلي الديمقراطية بتركيزها في تفضيلات الأغلبيات أو التعدديات من خلال انتخابات منتظمة وتدوير للسلطة على الليبرالية التي تعطي الأولوية للحريات الفردية والاستقلال الذاتي والتقدمية الاجتماعية”.
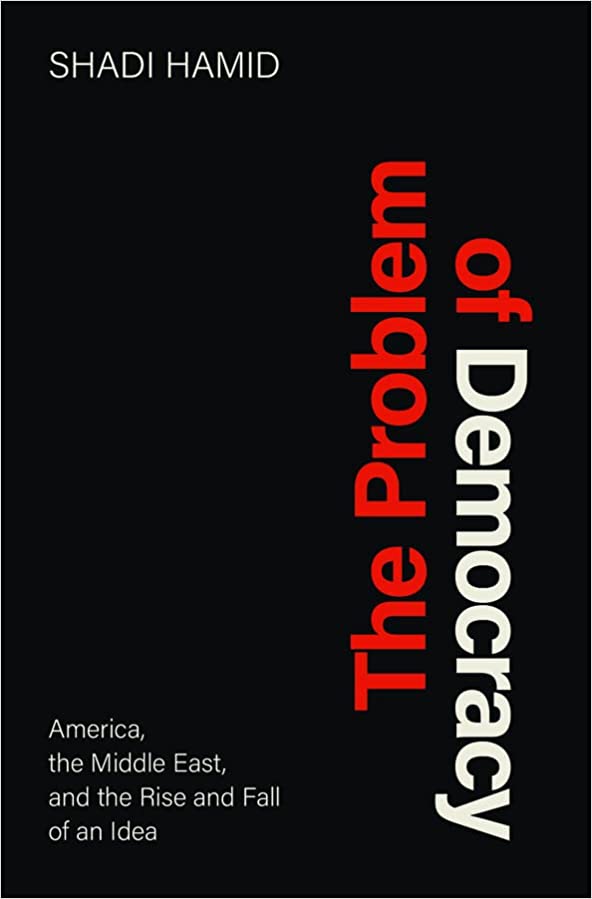
غلاف الكتاب (موقع أمازون)
وإذا كان حميد يرى في مفهوم “ديمقراطية الحد الأدنى” غير المنحازة إلى النتاجات الأيديولوجية الحقيقية مخرجاً لأميركا من أزمتها الديمقراطية، فإن ستيوارت يرى أنه تنازل لا يمكن أن يقدمه الأميركيون، “على الأقل مع الحفاظ على إخلاصهم لفلسفة المؤسسين. ففي إعلان الاستقلال، أكد الأميركيون أن جمهوريتهم قائمة على مسألة، وهذه المسألة ليست حكم الأغلبية، لكن هي أن جميع الأشخاص خلقوا متساوين في امتلاكهم لحقوق طبيعية”، وإذن فالليبرالية توشك في التصور الأميركي أن تكون عنصراً أصيلاً في تكوين الديمقراطية.
وهنا في تقديري تكمن قيمة حقيقية لهذا الكتاب، أي دفعه إلى التفكير في الديمقراطية ذاتها. هل الديمقراطية غاية أم وسيلة؟ هل نذهب إلى صناديق الاقتراع مثلما يذهب الحجيج إلى مزاراتهم المقدسة، هل نطالب بصوت لكل فرد، ورقابة على المؤسسات، واستقلال لفروع الحكم المختلفة، وضمان تداول للسلطة، وسيادة للقانون على الجميع، وكل ما يندرج ضمن اشتراطات الديمقراطية ومكملاتها، لأن هذه الأدوات جميعاً خير في ذاتها، هل لأننا نريدها هي، أم لأنها محض وسيلة إلى غاية؟
البديهي أن الديمقراطية وسيلة لغاية، بديهي أننا لا نريد حق الانتخاب لننتخب من يكممون أفواهنا أو يقيدون حركتنا أو يتدخلون في عقائدنا أو يضيقون علينا أسباب حياتنا. بديهي أننا نريد الديمقراطية لأننا نريد تأكيد حق كل مواطن في وطنه، وأمنه على نفسه وعلى غده، وطمأنينته إلى أنه لن يكون ضحية من هو أقوى منه، بديهي أننا نريدها لتوفير بيئة يثق فيها كل مواطن في أنه شريك في ملكية وطنه قادر على تحقيق ذاته فيه. فلو أخليت الديمقراطية من كل هذا لما صار لها معنى، فكل الإجراءات الديمقراطية إنما تكتسب قيمتها من قيمة ما تفضي إليه من نتائج. فما المغري في أن يكون لبلد ما حاكم مثل هتلر وصل إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية أو مثل دونالد ترمب، ما العزاء في الديمقراطية هنا؟
يكتب حميد، “إن العنصرين الجوهريين في الديمقراطية الليبرالية- أي الليبرالية والديمقراطية- يتباعدان منذ بعض الوقت”. فهل هذا التباعد مقبول؟ هل الديمقراطية من دون الليبرالية قابلة أصلاً للوجود، هل الليبرالية بالذات هي ما ينبغي أن تقاس به قيمة الديمقراطية؟
في ظني، ليس بالضرورة، فقد يتفق شعب على جملة من المبادئ الأساسية يرى أنه لا غنى له عنها، وعلى جملة من خطوط الحمراء التي يقدر أنه لا صلاح له باختراقها، وعلى جملة من الأعمدة الأساسية لعقد اجتماعي ما، وحينئذ يأتي دور الديمقراطية لضمان حماية هذا العقد الاجتماعي.
قد يكون هذا العقد الاجتماعي هو الليبرالية، وقد يكون الإسلام، وقد يكون الشيوعية، وقد يكون خليطاً من الأيديولوجيات، لكن المؤكد أنه لن يكون ثابتاً ودائماً، فمن المؤكد أن التطور الطبيعي سيغير من تفضيلات أي مجتمع وأولوياته وحاجاته، وإذن يجب أن تضمن الديمقراطية احترام هذا التغير، وتضمن حماية هذا الحراك، أعني أن من ضمانات نجاح الديمقراطية أن تصحبها دائماً عملية إعادة نظر في الثوابت بحيث يظل مجتمع ما دائم التساؤل عن كل شيء، ليضمن دائماً أن الديمقراطية تحمي ما يريد حمايته فعلاً، وهذا ما يجعل من حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاعتقاد والحريات جميعاً جزءاً لا يمكن فصله عن ديمقراطية ذات معنى.
قد تكون “ديمقراطية الحد الأدنى” حلاً للولايات المتحدة، يحفظ لها ماء وجهها محلياً، ويتيح لها قدراً أكبر من مرونة الحركة عالمياً، غير أن “الحد الأدنى” نفسه هو الذي يجب أن يرتفع بعض الشيء، لكي لا تصبح الديمقراطية اسماً آخر للقهر.
عنوان الكتاب: The Problem of Democracy: America، the Middle East، and the Rise and Fall of an Idea
تأليف: Shadi Hamid
الناشر: Oxford University Press




