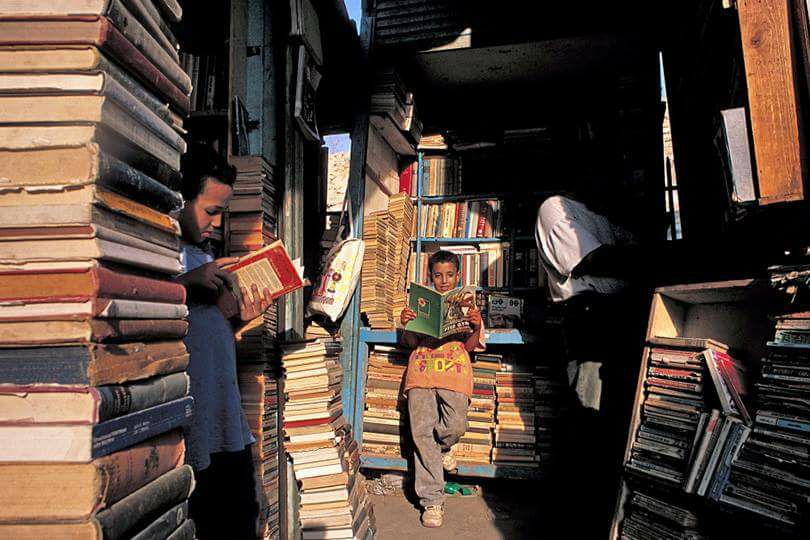محمد علي جواد تقي
ما هي أحلى الاوقات التي يعيشها الانسان في حياته؟، ربما يكون وصول خبر سار، مبعث على السرور والارتياح، او يكون الرجل بين أطفاله وزوجته في أجواء ملؤها الود والاحترام، فيشعر بالرضا والسعادة، او حتى يحلّ عليه عزيز على قلبه، فتنشرح أساريره، بل ربما ينسى همومه ومشاكله خلال هذه الزيارة، هذا وغيره بامكانها ان ترسم تكون من بواعث السرور والارتياح على قلب الانسان، ربما تجلب له الراحة النفسية، بيد ان المطلوب ايضاً؛ انعكاس هذه اللحظات الطيبة على أبعاد الحياة الاخرى حتى لا تكون عابرة ومنحصرة بالمكان والزمان.
ولذا يقول الفقهاء إن أفضل أوقات الانسان واكثرها تأثيراً على حياته؛ أوقات المحنة ومواجهته للضغوط والتحديات، لأنه في ظل اجواء كهذه، يستخرج مكنوناته من قدرات على الصبر وتجاوز الحاجات الانسانية والغريزية، كما يختبر فيها قدرته على الابداع والتفكير بايجاد البدائل، أو الحلول، ولعل هذا يكون مصداق الحديث الشريف أن “للمؤمن فرحتان؛ فرحة لدى الإفطار (في شهر رمضان)، وفرحة لدى لقاء ربه”، وعلى مستوى المجتمع والأمة، فان أفضل ايامها وأكثرها تخليداً؛ الثورة او الانتفاضة الجماهيرية، وهنا ايضاً ستواجه الامة التحديات العنيفة من قمع واعتقالات وإعدامات وتشريد وغيرها كثير، وفي ظروف كهذه، تستخرج الامة – كما رأينا ذلك في تجارب شعوب عدّة – من رصيدها الثقافي والحضاري ما تستعين به لإنجاح مشروع التغيير بالتمسك بالصبر والتعاون والتكافل والإيثار.
واذا راجعنا تاريخ شعوبنا في القرن الاخير – على الأقل- وجدنا الميل الشديد الى حياة الدعة والرفاهية بعيداً عن الضغوط والاختبارات الصعبة، وحتى نلاحظ – ويلاحظ الباحثون في هذا الشأن- ان ثمة هروباً واضحاً من أي نوع من تغيير الواقع مهما كان سيئاً، والاكتفاء بالموجود، ربما متأثرين بالقاعدة الفلسفية: “ليس بالإمكان افضل مما كان”، وأن “الديمقراطية” وإطلاق حرية العمل والسكن والكلام بمختلف اشكاله في العراق – مثلاً- كافية لتحقيق العيش الكريم، علماً أن هذه الشعوب إنما خاضت تجربة التغيير مع أنظمة ديكتاتورية عنيفة ودموية، مارست مختلف اشكال التضليل والتغرير، فهي مارست سياسة “العصا الجزرة” وشيّدت منظومة ثقافية متكاملة ضمنت على اساسها مستقبلاً سياسياً طويل الأمد، فكيف يمكن – والحال هكذا- ان يفكر الواحد منّا بالركون الى الراحة والاطمئنان على الحاضر والمستقبل؟
إن استعجال النتائج في مسيرة التغيير، هي التي تنقل بلادنا من ديكتاتورية الفرد الواحد، الى ديكتاتوريات الاحزاب السياسية، ومن الثقافة المستوردة من الحاكم الديكتاتور، الى الثقافة المستوردة من تجار السوق، وإلا ما الذي يفسّر استيراد ودخول مظاهر الابتهاج بأعياد ومناسبات لا علاقة بالمجتمعات الاسلامية بها، مثل عيد رأس السنة الميلادية، أو عيد الحب، او حتى الاحتفال بمهرجان الألوان القادم من بلاد الهند؟!
ويبدو أن هذه الحالة النفسية لها جذور في تاريخ الحضارة الانسانية، فالقرآن الكريم يحدثنا عن إحدى مثالب بني اسرائيل ومعوقاتهم المريعة للرسالات الإلهية ومحاربتهم لجهود الإصلاح والتغيير الحقييين، منها؛ أنهم، ولمجرد عبورهم البحر ونجاتهم من فرعون وجيشه في القصة المعروفة، وبعد لم تجف أقدامهم من مياه البحر، حتى طالبوا نبيهم وقائدهم؛ موسى، عليه السلام، بأن يكون لهم إله خاص لهم، حتى لا يتخلفوا عن قوم آخرين رأوهم في الطريق يعبدون الاصنام!
هذه الانتكاسة الايمانية كشفت مستوى التغيير في نفوس بني اسرائيل من حياة الذل والعبودية والقمع في عهد فرعون، الى حياة العزّ والكرامة التي هيئها لهم نبيهم بفضل من الله –تعالى- إذ بانت الشوائب العالقة من الثقافة الصنمية، بل حتى مشاعر الضِعة المتجذرة، بحيث فشلوا في الارتقاء الى المستوى الرفيع الذي يعبر عنه القرآن الكريم: {…وأني فضلتكم على العالمين}، فهم واجهوا النظام الفرعوني وتحملوا الأذى للتحول الى التوحيد ونصرة النبي موسى، بيد أنهم لم ينجحوا في تطبيق القيم السماوية على حياتهم اليومية، فكانت الاحكام والنظم التي يتحدث عنها نبيهم، في وادٍ، وسلوكياتهم وأخلاقهم وطريقة تفكيرهم في وادٍ آخر.
هذا ما كان من تجارب الأمم السابقة، أما نحن؛ فبقدر تخلّينا عن رواسب الماضي، وتعميق الروح الايمانية، والأهم؛ المداومة على الإصلاح في منظوماتنا الثقافية، نكون سعداء بالتغييرات الحاصلة في بلادنا، ومنها؛ العراق، لاننا سنترك بذلك بصماتنا على مجمل الاوضاع الجارية والنظام العام، وفي المقدمة؛ النظام السياسي القائم، فالشعب العراقي الذي تمكّن في الواقع الخارجي من تغيير الصورة النمطية، التي طالما حاول الكثير ترسيخها في العالم، بأنه فيه شعب بلا إرادة، وغارق في التناحر الطائفي، ومقبل على التقسيم، وأثبت جدارته بتضحيات ابنائه، من تطهير أرضه من عناصر تنظيم ارهابي، ليس من اللائق أن يفشل هذه المرة في تطهير ثقافته من الافكار الدخيلة والغريبة عليه، وهو قادر على ذلك لما يمتلكه من رصيد ثقافي وحضاري عظيم يغبطه عليه سائر الشعوب والأمم في العالم؛ فلديه الطف، ولديه الغدير، ولديه تجارب العلماء والثائرين والمصلحين التي من شأنها ان تخلق الحياة السعيدة بشكلها الحقيقي.