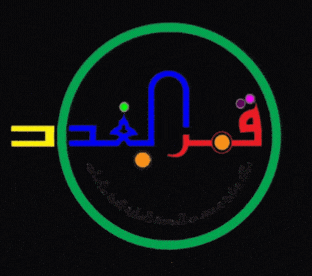العزلة… كم أُسيء فهمها! كم صُوّرت في عقولنا على أنها الهروب، أو الانطواء، أو حتى نوع من الكآبة! كأنما لا يجد سكينته إلا من أخفق في التوافق مع الآخرين. لكن الذين جرّبوا الخلوة حقًا، لا باعتبارها عقوبة بل نعمة، يعرفون أنها ليست انسحابًا، بل إقدامًا على الذات. هي المساحة التي نتخلّى فيها عن صخب الخارج، لا لنغلق الأبواب، بل لنفتح النوافذ على الداخل.
العزلة، حين تُختار بوعي، تصبح كما يقول بعض الفلاسفة: فنًّا داخليًا يعيد الإنسان إلى ذاته، ويمنحه القدرة على رؤية العالم بعيون أقل تشويشًا وأكثر صدقًا. في عالمٍ صارت فيه الضوضاء شرطًا للوجود، والظهور معيارًا للقيمة، تبدو العزلة فعلًا مضادًا، لا لأنها انقطاع، بل لأنها مقاومة لما يستهلكنا دون أن نشعر.
الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتين، في تأملاته العميقة، ابتكر وصفًا لهذه الخلوة الداخلية، سماها “غرفة خلف الدكّان”. إنها استعارة لركن داخلي لا يدخله أحد سوانا، غرفة لا نُمارس فيها دور الأب أو الموظف أو الصديق، بل نكون فيها مجرّد أنفسنا. يقول مونتين: “ينبغي أن نحتفظ بغرفة خلف الدكان، تكون ملكًا لنا وحدنا، نمارس فيها حريتنا الحقيقية، ونقيم بها وحدتنا بعيدًا عن كل ما يُملى علينا من الخارج.”
وليست هذه الفكرة نظرية أو خيالية، فقد جسّدها فعليًا كارل يونغ، حين بنى برجًا حجريًا على ضفاف بحيرة زيورخ، وسماه “برج بولينغن”. هناك، بعيدًا عن المدينة، عاش فترات طويلة متأمّلًا، يكتب ويتأمل في النفس البشرية والرموز واللاوعي الجمعي. قال عن ذلك المكان: “في بولينغن، أكون نفسي.” وكأن الخلوة كانت له مفتاحًا لفهم النفس لا هربًا منها، وسبيلاً للكتابة لا انقطاعًا عنها.
وإذا كان مونتين ويونغ قد دعوا للخلوة كضرورة للفكر والنفس، فإن الكاتبة الإنجليزية فرجينيا وولف ذهبت أعمق من ذلك، حين ربطت الخلوة بحرية المرأة في كتابها “غرفة تخص المرء وحده”. لم تكن دعوتها للعزلة بمعناها الجسدي فحسب، بل لامتلاك حيّز ذهني تكتب فيه المرأة دون رقابة، دون أعين العائلة أو التزاماتها التي كبّلت الإبداع الأنثوي قرونًا طويلة.
ومع كل هذا التمجيد للعزلة، فإن من الضروري أن نضع خطًا تحت هذا المعنى: الخلوة التي نعنيها ليست بديلًا عن المجتمع، ولا دعوة للانسحاب من الحياة، بل فسحة مؤقتة لترتيب الداخل واستعادة التوازن. وكما قال ابن خلدون: “الإنسان مدنيٌّ بطبعه”، فإن من ينعزل كلية عن الناس يوشك أن يفقد إنسانيته نفسها. العزلة التي نقصِدها لحظة، لا نمط حياة دائم، هي مرآة مؤقتة، لا جدار دائم.
وقد لا تكون العزلة الحقيقية في أن تغيب عن الناس شهورًا، بل أن تعرف متى تنسحب منهم يومًا لتستعيد صوتك الداخلي. هذا ما فعله المهاتما غاندي، الزعيم الروحي الذي لم يمنعه انشغاله بقيادة أمة من أن يخصص يومًا كاملًا كل أسبوع للصمت التام. بدأ هذه العزلة الأسبوعية بدافع عملي، ليتفرغ لمراسلاته، لكنه سرعان ما اكتشف أن الصمت المنتظم تحول إلى حاجة روحية لا تقل أهمية عن التنفس. وقد قال:
“في البداية، بدأت يوم الصمت الأسبوعي كوسيلة للحصول على وقت للعناية بمراسلاتي. لكن الآن، أصبحت هذه الأربع والعشرون ساعة حاجة روحية حيوية. إن فترة الصمت الدورية ليست تعذيبًا، بل نعمة.”
في خلوته الصامتة تلك، لم يكن يعتزل الناس لأنه ضاق بهم، بل لأنه أراد أن يعود إليهم أنقى، أصفى، وأكثر اتزانًا.
وقد رأينا في تراثنا الفكري كيف كانت العزلة ممرًا للعمق لا الانفصال؛ فابن خلدون حين اعتزل الناس كتب “المقدمة”، والغزالي حين انسحب من حلقات الدرس كتب “المنقذ من الضلال”.
وفي هذا السياق، لا أخفي أنني، في بدايات قراءاتي، حين وقعت عيناي على أقوال آرثر شوبنهاور في تمجيد العزلة والانكفاء عن المجتمع، شعرت بشيء من الإعجاب والتصديق. بدا لي، آنذاك، أن ما يقوله صائب بالضرورة، كيف لا وهو صادر عن فيلسوف مرموق، تُترجم أفكاره وتُدرّس في كبريات الجامعات؟ لكن شيئًا ما جعلني أعود إلى سيرته الذاتية، وأتمعن في خلفيته النفسية والإنسانية، لأكتشف أن دعوته للعزلة لم تكن بالضرورة تعبيرًا عن حكمة متزنة، بقدر ما كانت صدىً لمرارة شخصية عميقة، لصراعات عائلية، وخيبات اجتماعية، ونظرة متشائمة للطبيعة البشرية رافقته منذ شبابه.
عندها أدركت أن أقوال الفلاسفة، مهما بلغت رصانتها، لا ينبغي أن تُؤخذ كحقائق نهائية، بل كأصوات بشرية نابعة من سياقات وتجارب ومعاناة. فمن واجب القارئ، لا سيما في زمن تدفّق الاقتباسات الجاهزة، أن يُعيد قراءة الأفكار لا بمعزل عن أصحابها، بل وهو يضع نصب عينيه سؤالًا بسيطًا: “ما الذي جعلهم يقولون هذا؟”
فالعزلة التي مدحها شوبنهاور، لم تكن عزلة التأمل بقدر ما كانت انعكاسًا لعزلته الوجودية. وهنا يكمن الفرق: بين خلوة تُصلح الداخل وتُعدّك للعودة، وعزلة تُشيّد جدارًا بينك وبين العالم، فلا ترى سواه ظلامًا.
إننا اليوم في أمسّ الحاجة إلى إعادة الاعتبار للعزلة، لا كترف زاهد أو تمرّد صامت، بل كأداة للعودة إلى الذات. أن نُطفئ كل الأصوات، لا لننكرها، بل لنسمع ما بين سطورها. أن نعرف كيف نصمت، كي نعود وقد عرفنا كيف نتكلم.
فلتكن لنا غرفة خلف الدكان، لا نعيش فيها، لكن نعود إليها. نخرج منها لا لكي نهرب، بل لنحبّ أكثر، ونفكر أصفى، ونكون لأنفسنا أولاً ثم للآخرين.