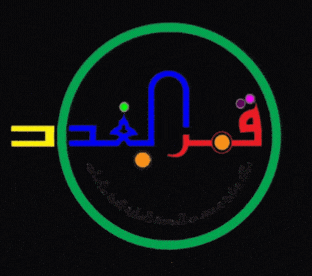ما الذي تعلمته القوى الذرية الساعية إلى شراء الأسلحة من غارات إسرائيل على إيران؟
فيبين نارانغ
براناي فادي
نظام صاروخي إيراني في موقع غير محدد داخل تلك البلاد بتاريخ أغسطس 2025 (رويترز)
ملخص
أدت ضربة إسرائيل وأميركا للمنشآت النووية الإيرانية في حرب الـ12 يوماً، إلى تعزيز النموذج الكوري الشمالي الذي استند إلى سرعة الوصول إلى القنبلة الذرية للحصول على ردع إقليمي ودولي مناسب، مع إمكان التفاوض من موقع قوة مع واشنطن، فيما استندت إيران إلى مسارات تفاوضية مع أميركا والغرب عن برنامج معلن عن أنها دولة على مشارف العتبة النووية، مما سهل ضرب برنامجها، بل ربما أغرى بذلك. وتعزز تلك التناقضات ربما الميل لدى دول ترغب في السلاح النووي لاتباع نموذج بيونغ يانغ.
خلال الأشهر التي تلت حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، دخل محللون وأجهزة الاستخبارات في نقاشات واسعة عن مدى الضرر الذي أصاب البرنامج النووي الإيراني والنظام القائم في تلك البلاد. ولا يزال من غير الواضح مدى نجاة البنية التحتية النووية الإيرانية من تلك الحرب، والسرعة التي تستطيع فيها إعادة بنائها، إذا توصلت إلى ذلك إطلاقاً. ولكن على المستوى الاستراتيجي، فإن تأثير الحرب لا جدال فيه: لقد أنهت استراتيجية نووية اتبعتها الجمهورية الإسلامية بنجاح نسبي منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وطوال عقود، جسدت إيران نموذجاً متطوراً عن استراتيجية العتبة النووية [خيار الاحتفاظ بالقدرة من دون تصنيع القنبلة]. وسعت وراء المعرفة والتكنولوجيا بغية دفع برنامجها النووي إلى مستوى إنتاج أسلحة، لكنها أحجمت عن ذلك لأسباب سياسية. ولبعض الوقت في الأقل، بدت هذه الاستراتيجية ناجحة. وعلى رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة كلاهما معاً حاولتا باستمرار إعاقة البرنامج النووي الإيراني عبر أعمال تخريبية واغتيالات موجهة، فإن أياً من البلدين لم يضرب المنشآت النووية الإيرانية بصورة معلنة. ثم عام 2015، مع توقيع “خطة العمل المشتركة الشاملة”، بدا كأن مقامرة النظام الإيراني تؤتي أكلها. ونالت إيران إعفاءات مرغوباً فيها بشدة من العقوبات مقابل قبول فرض قيود على برنامجها النووي. وتآزر الخطر المتولد من مزيج التحوط الإيراني مع رغبة إدارة الرئيس أوباما خلال عهدته الثانية، في التوصل إلى حل دبلوماسي شامل. وأفضى ذلك المزيج إلى مفاوضات ناجحة أدت إلى صفقة مثلت علامة بارزة على طريق إبعاد إيران من صنع قنبلة نووية.
وفي المقابل، منذ حرب الـ12 يوماً، تمزقت تلك الاستراتيجية إرباً. وتسببت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية في إحداث دمار أساس لمنشآت محورية في نطنز وفوردو وأصفهان، وشلت بنية القيادة العسكرية الإيرانية. وقللت إيران من حجم رغبة واشنطن في دعم العمل العسكري الإسرائيلي، والمشاركة بنفسها في الحملة على إيران. واليوم، تجد إيران نفسها منكشفة أمام هجمات إقليمية تهدد وجودها، إضافة إلى جهود لتغيير النظام. وصارت القنبلة نائية عن متناول يدها، وبات موقفها التفاوضي مع الغرب أضعف من كل وقت مضى.
اقرأ المزيد
هكذا فشلت القوات الخاصة الأميركية في مياه كوريا الشمالية
أخطار اليأس الإيراني
لماذا تفشل القوة في الحد من التسلح النووي؟
عصر ما بعد إيران في الشرق الأوسط
الجمهورية الإيرانية تلتقط أنفاسها
إيران ودروس الحرب الإسرائيلية
إن فشل إيران كدولة تقف على أبواب التسلح النووي يعتبر انتصاراً لاستراتيجية أخرى يتبناها خصم آخر للولايات المتحدة تمثله كوريا الشمالية. وعلى عكس طهران، تجنبت بيونغ يانغ إلى حد كبير أي تأخير في الدفع ببرنامجها النووي صوب إنتاج أسلحة. وانتظمت في مسار ثابت للتقدم نحو صنع قنبلة. واستخدمت الدخول بصورة دورية مع أميركا كي تختبر مدى تصميم الولايات المتحدة على اتفاقات محتملة. واعتمدت بصورة روتينية على تكتيكات المناورة والمماطلة. وعبر ذلك المسار، استطاعت إنهاك ضغوط دبلوماسية واقتصادية ضخمة. وحينما توقفت الدبلوماسية، عمدت كوريا الشمالية إلى تسريع التقدم في برنامجها، فبات نظام كيم مستعداً لمقاربة أي دخول مستقبلي من موقع أكثر قوة. وفيما يحاول المرشد الأعلى علي خامنئي إعادة تجميع نظامه في إيران، يبرز زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بوصفه مثلاً عن الكيفية التي كان ممكناً تسيير الأمور بها، عبر صنع إحدى الترسانات العالمية الأعلى سرعة في التنامي والتنوع، مع شركاء دوليين في بكين وموسكو. وبالنسبة إلى الدول التي تسعى إلى السلاح النووي، تبدو الدروس واضحة بصورة خطرة: لا تتأخر في صنع القنبلة وتمسك بافتراض أن قوى كبرى ستهاجم ولا تثق بالمسار الدبلوماسي. وبكلمات مختصرة، تتمثل تلك الدروس في احتذاء كيم وتجنب مثال خامنئي.
لحظة ضائعة
منذ أوائل السبعينيات، امتلكت إيران الطموح الضروري والخبرة اللازمة لتوسيع برنامجها في الطاقة النووية ليصل إلى إمكان كامن في تحقيق أهداف عسكرية. وبدأ ذلك البرنامج قبل عقدين من تلك الحقبة تحت قيادة محمد رضا شاه بهلوي، ثم انضمت إيران إلى “معاهدة حظر الانتشار النووي”، عام 1970. وأثناء الحرب بين إيران والعراق إبان حقبة الثمانينيات من القرن الـ20، شرعت “الجمهورية الإسلامية” بصورة سرية في استكشاف تقنيات أشد محورية وحساسية على غرار تخصيب اليورانيوم، واستمرت في اكتساب خبرات بمساعدة بلدان أخرى. وابتداء من عام 1989، صاغ النظام الإيراني ما سمي خطة “آماد” AMAD التي أرست خريطة طريق للعمل النظري والهندسي اللازم من أجل تحويل البرنامج النووي إلى وجهة عسكرية، بمجرد أن تخصب من اليورانيوم ما يكفي لصنع قنبلة.
ولكن إيران لم تتخطَّ عتبة التسلح في برنامجها النووي. وبقيت دونها لأسباب سياسية أكثر من أنها تقنية. وبعد انكشاف نشاطات إيران النووية السرية في بداية القرن الـ21، جمد القادة الإيرانيون خطة “آماد”، وفضلوا مقايضة السعي إلى القنبلة بإعفاءات اقتصادية ودبلوماسية. واستمر أولئك القادة في استخلاص أن تخطي عتبة الوصول إلى برنامج تسلح النووي لا يخدم مصالح إيران الأمنية والاستراتيجية، مع أنها دولة موقعة على “معاهدة حظر الانتشار النووي”، على رغم تصاعد الوجود العسكري الأميركي وحريته للعمل في الشرق الأوسط. وفي المقابل، احتفظت إيران بكلفة مرتفعة، بالخبرات التقنية والمكونات البيروقراطية والبنية التحتية الصناعية اللازمة للتقدم في البحوث النووية المدنية وإنتاج النظائر المشعة الطبية وتوليد الكهرباء، مع إعادة صياغة أهداف ذلك البرنامج كي يوضع للاستخدام العسكري إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وراهن النظام على أن برنامج العتبة النووية قد يخدم ثلاثة أهداف جيوسياسية. أولاً، ربما يعطي إيران القدرة على تطوير سريع للقنبلة إذا بدا أن هناك خطراً وجودياً داهماً. ثانياً، قد يردع هجوماً عسكرياً تشنه إسرائيل أو الولايات المتحدة عبر إبقاء الدولتين كلتيهما غير متيقنتين حيال مدى اقتراب طهران من صنع قنبلة. وثالثاً، قد يستخدم كأداة في التوازن مع خصومها في الغرب عبر استعمال القيود على البرنامج كورقة رابحة في التفاوض من أجل الإعفاء من العقوبات الاقتصادية.
وعلى مدى ما يقارب عقدين منذ تعليق خطة “آماد”، توقفت إيران طوعاً عن تجاوز الخط الفاصل نحو امتلاك السلاح النووي. وعلى رغم أن علماءها النوويين تصوروا امتلاك ترسانة أولية من خمس قنابل، ظل القادة السياسيون في طهران مترددين حول ما إذا كان هدف البرنامج النووي هو الوصول إلى ترسانة نووية أو استخدام أجزاء كبيرة منه كورقة تفاوض للحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية. ومع ذلك، كانوا مقتنعين إلى حد كبير بأن الوقوف على عتبة التسلح النووي سيحمي البلاد من هجوم وجودي. وعقب أعوام من سياسة حافة الهاوية مع إدارتي جورج دبليو بوش (الابن) والإدارة الأولى لأوباما، بدا قادة إيران محقين. وتوصلوا إلى اتفاق “خطة العمل المشتركة الشاملة” الذي أتاح لطهران مبادلة أجزاء من برنامجها مقابل تعزيز اقتصاد البلاد وسمعتها.
ولكن لم تقضِ “خطة العمل المشتركة الشاملة” بأن تلتزم الإدارات الأميركية مستقبلاً ذلك الاتفاق. ومع ولاية ترمب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق عام 2018. وعقب ما بدا لها كخيانة واضحة، شرعت إيران في تكديس كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك أنواع يصل نقاؤها إلى المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية. وأدت تلك الأعمال إلى تكوين أداة ضغط للتفاوض حول صفقة مستقبلية، إضافة إلى ما تحمله من إمكان تحولها إلى ضمانة سياسية ضد الإدارة الأولى لترمب المتقلب، وإسرائيل التي لم تخفِ رغبتها في مهاجمة إيران. وأدى القتل الموجه للجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة عام 2020، إلى ترسيخ تلك الهواجس في عقول قادة إيران.
وعقب محادثات غير مباشرة وغير حاسمة إبان إدارة بايدن، ومع تزايد الأعمال العسكرية الهجومية الإقليمية لإسرائيل في خضم هجمات وقحة شنتها حركة “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، سرعت إيران خطواتها وباتت على بعد أيام من القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يكفي لصنع قنبلة. وأخيراً، مع عودة الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض عام 2025، أصبح احتمال شن هجوم أميركي مدعوم من إسرائيل على إيران واقعاً ملموساً، بالتالي، فقد انكشفت بجلاء عثرات وأخطاء استراتيجية العتبة النووية. وفي يونيو الماضي، دفعت إيران ثمن التخاذل فيما ضربت الولايات المتحدة، للمرة الأولى في الحقبة النووية، منشآت نووية في دولة أخرى. ولو أن إيران عبرت “نهر الروبيكون” [كناية معروفة عن تجاوز خط أحمر بما يجعل الأمور غير قابلة للتدارك] عام 2003، لربما تجنبت الولايات المتحدة مثل هذا الصدام المباشر الذي ينطوي على أخطار جسيمة عند مهاجمة خصم يمتلك سلاحاً نووياً.
نجمة الشمال
ضمن ذلك السياق، تضحي تجربة كوريا الشمالية مثالاً موجهاً. فخلال ستينيات القرن الـ20، واجهت بيونغ يانغ على حدودها حليفاً [كوريا الجنوبية] للولايات المتحدة متفوقاً في التسلح التقليدي. وفي ظل هدنة، وليس السلام، أطلقت كوريا الشمالية برنامجاً ركز على الطاقة الذرية. ولكن في زمن “الحرب الباردة”، سعت بيونغ يانغ إلى نيل مساعدة من الاتحاد السوفياتي والصين لتطوير سلاح نووي. وأشعلت كوريا الشمالية أزمة في مطلع التسعينيات من القرن الـ20 حينما رفضت التعاون مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” حول التعامل مع إعلاناتها غير المكتملة المتصلة ببرنامجها النووي، مما أثار ريبة دولية بأنها تنفذ أنشطة غير مشروعة تتعلق بالتسلح. وعام 1993، فكرت الولايات المتحدة جدياً في ضرب مفاعل “يونغ بيون” الكوري الشمالي، بل إنها رسمت خططاً عسكرية لمهاجمة ذلك الموقع بذخائر اختراقية تحملها قاذفات قنابل شبحية تخفى عن الرادار. ولكن إدارة كلينتون أجهضت تلك الفكرة خشية من أن يؤدي ذلك الهجوم إلى رد انتقامي ضد كوريا الجنوبية، بالتالي إثارة حرب أوسع نطاقاً. وبدلاً من ذلك، سعت أميركا إلى حل دبلوماسي. وأوصل ذلك إلى “الاتفاق الإطاري” عام 1994 الذي يطلب من كوريا الشمالية تجميد العمل على تركيب مفاعلات نووية يشتبه في أنها تستعمل لإنتاج أسلحة. وكذلك قضى الاتفاق بوضع ما تملكه بيونغ يانغ من قدرات في إنتاج البلوتونيوم، تحت نظام التحقق الذي تنهض به “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة وشركاء آخرون على تقديم مفاعلات نووية بقدرات متدنية لا تتيح لها إنتاج أسلحة وتزويد كوريا الشمالية بالوقود لتلبية حاجات الطاقة التي ذكرها الزعيم الكوري الشمالي كيم إيل سونغ كمبرر لبناء المفاعلات النووية.
ولكن بيونغ يانغ تعاملت مع “الاتفاق الإطاري” (وكل مبادرة دبلوماسية لاحقة) بطريقة تخلو من المصداقية، مستخدمة في الغالب تكتيك المماطلة. وكذلك عمد الخلفاء المتتالون في سلالة كيم إلى إعطاء الأولوية لبرنامج الأسلحة النووية، وأفردوا ما استطاعوا من مصادر لمصلحة السعي إلى امتلاك أسلحة نووية. وعلى عكس إيران، لم تُبدِ كوريا الشمالية اهتماماً يذكر بمقايضة أجزاء مهمة من برنامجها مقابل تخفيف العقوبات قبل امتلاكها للسلاح النووي، بعد انهيار “الاتفاق الإطاري” عام 2003.
وعندما كانت وكالات الاستخبارات الأجنبية أو المراقبون الدوليون يكشفون عن نشاط غير معلن خلال المفاوضات النووية، كانت كوريا الشمالية تصعد الضغط عبر اختبار الصواريخ أو استفزاز كوريا الجنوبية. وعندما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يهددون بالرد أو الهجوم – كما حدث في أزمة يونغ بيون، أو عندما وضعت الولايات المتحدة قاذفاتها في حال تأهب رداً على إعادة تشغيل كوريا الشمالية لمنشآت كانت مغلقة بموجب “الاتفاق الإطاري” وانتهاكها لالتزاماتها بموجب “معاهدة عدم الانتشار النووي” وانسحابها من المعاهدة عام 2003 – كان كيم إيل سونغ، ولاحقاً كيم جونغ إيل، يتحولان نحو الدبلوماسية، ويعدان بصورة خادعة بوقف الأنشطة المتعلقة بالأسلحة والدخول في مفاوضات بنية حسنة.
وفي الوقت نفسه، كانت كوريا الشمالية تواصل تطوير بنيتها التحتية النووية وتصاميم الأسلحة وبرامج الصواريخ، وغالباً ما كانت تسرع وتيرة العمل بين اللحظات البارزة من الدخول الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
واليوم، يقف كيم جونغ أون فوق إحدى أسرع الترسانات النووية تنامياً وتنوعاً في العالم. ويمتلك خيارات متنوعة لضرب كوريا الجنوبية واليابان، تشمل إمكان استخدام أسلحة نووية تكتيكية وصواريخ بعيدة المدى تستهدف الولايات المتحدة. ومع تلك الترسانة، بات قائد كوريا الشمالية أشد ثقة بقدرته على ردع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية أو أية محاولة لتغيير نظامه. وتغاير تلك المشهدية الوضعية الإيرانية على نحو صارخ. ومع نظام هش وبرنامج نووي وعسكري متحطم، موقتاً في الأقل، دفع خامنئي ثمن الفشل في حماية الضمانة النووية. وقد يشعر المتشددون في إيران بأن انتهاج الدبلوماسية مع القوى الكبرى والفشل في التسلح، جعلا إيران منكشفة أمام تلك الأنواع من الهجمات التي تجنبتها كوريا الشمالية بفضل إسهام من استراتيجية مصممة على التسلح النووي.
التخفي
بحسب ما أظهرته تجربة إيران، تبدو استراتيجية الوقوف عند عتبة التسلح النووي غير كافية لردع القوى الساعية إلى مواجهة الانتشار النووي، بل ربما تدفعها أيضاً إلى شن هجوم وقائي لإجهاض ذلك البرنامج ما دام أنها تفتقر إلى معلومات دقيقة حول مدى تقدم التسلح النووي. إن الحفاظ على الأساس التقني الذي يتيح تطوير أسلحة نووية بسرعة – وهو ما يسميه الاستراتيجيون النوويون “القدرة الكامنة” – لا يوفر رادعاً فاعلاً بقدر امتلاك قدرات نووية فعلية، بل على العكس، يشكل البرنامج النووي الكامن هدفاً مغرياً لخصوم يسعون إلى منع التسلح ويغريهم ربما بالتحرك بسرعة قبل أن يغلق باب الفرصة وتصبح الدولة قادرة على التهديد بردع نووي.
ورأت إسرائيل تلك النافذة في يونيو الماضي واستفادت منها إلى الحد الأقصى. ونفذت ضربة كثيراً ما حلم بها نتنياهو واليمين الإسرائيلي أعواماً طويلة. والدروس المستخلصة بالنسبة إلى الدول الطامحة لامتلاك السلاح النووي كانت واضحة: التلويح ببرنامج نووي في وجه قوى عسكرية أقوى بكثير، من دون امتلاك قنبلة تردع الهجوم الوقائي، لعبة محفوفة بالأخطار. ومن غير المرجح أن تكرر الدول الطامحة هذا الخطأ. فإضافة إلى عدم تأجيل التسلح كما فعلت إيران، من المرجح أن تعطي دول مثل بولندا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا الأولوية لأمن عملياتي أعلى، وستسعى إلى إخفاء برامجها عن أعين الدول المناهضة للانتشار بصورة أكثر فاعلية مما فعلت إيران.
وعلى عكس برنامج إيران الذي لم يتمكن من البقاء سرياً خلال فترة التردد الطويلة وعملية التفاوض المتقطعة التي أجبرت طهران على قدر من الشفافية، قد لا تكشف هذه البرامج المستقبلية في مراحل ما قبل التسلح كورقة تفاوض، بل فقط بعد الإعلان عن السلاح النووي – أو حتى اختباره. ومن المحتمل أن تكون الدول الطامحة للسلاح النووي مستعدة للتضحية بالسرعة مقابل الأمان، من خلال دفع برامجها بالكامل إلى العمل تحت الأرض، وإعادة توظيف ما يمكن من صناعتها النووية المدنية وتقنياتها. وربما يكون هذا النهج أسهل بالنسبة إلى الأنظمة المغلقة مقارنة بالديمقراطيات. ومع ذلك، من الممكن حتى للديمقراطيات أن تمتلك برامج تسلح سرية صغيرة وفاعلة – فالهند وإسرائيل (بحسب المزاعم) وجنوب أفريقيا، جميعها خاضت جهود تسلح سرية. وقد تكون الدول هذه، بما في ذلك الديمقراطيات، مستعدة لتحمل الإدانة الدولية التي تترتب ربما على انتهاك أو الانسحاب من اتفاقات عدم الانتشار، باسم الأمن القومي.
خذ على سبيل المثال سوريا في عهد بشار الأسد. فخلال العقد الأول من القرن الـ21، وبينما كانت إيران أوقفت خطة “آماد”، سارعت سوريا إلى بناء برنامج تسلح نووي سري، وكادت أن تكمله. لكن عام 2007، عثرت الاستخبارات الإسرائيلية – عن طريق الصدفة – على أدلة تشير إلى وجود مفاعل نووي سوري، كان نسخة مصغرة عن منشأة “يونغ بيون” الكورية الشمالية، وكان موجوداً ضمن مجمع بسيط فوق الأرض في منطقة نائية قرب نهر الفرات. ومع اقتراب المفاعل من أن يزود بالوقود (مما كان سيجعل ضربه خطراً بيئياً)، قامت إسرائيل بتدميره بضربات جوية. ومع ذلك، قدمت هذه الحادثة درساً صارخاً في البرامج السرية: فعلى رغم أن سوريا كانت تحت رقابة مشددة من الغرب في ما يخص الانتشار النووي، فإنها نجحت في الحفاظ على أمن عملياتي مثير للإعجاب لمفاعل نووي فوق الأرض. ولم يكشف عن البرنامج إلا بفضل جهد استخباراتي حثيث – وكثير من الحظ. وحتى لو لم تسلك الدول الطامحة للسلاح النووي طريق كوريا الشمالية السريع نحو القنبلة، فمن المرجح أن تقتدي بالنموذج السوري السري أكثر من النموذج الإيراني الشفاف نسبياً.
عرض نهائي
إضافة إلى رسمها نهاية استراتيجية العتبة النووية، سيتولد من حرب الـ12 يوماً نتيجة مهمة أخرى. ويعني ذلك أنها ستفاقم بصورة استثنائية صعوبة اتباع الدبلوماسية في المستقبل للتعامل مع الدول الراغبة في التسلح النووي. وفي حال إيران، ربما أضحى المتشددون الآن أكثر قوة داخل النظام وأشد تأثيراً في المرشد الأعلى. وكذلك ربما يتوصلون إلى رسم صورة مقنعة عن الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد ضربتا طهران أثناء دخولها في محادثات مع واشنطن، بوصفهما غير قادرتين ولا راغبتين في إيجاد مسار دبلوماسي للمضي إلى الأمام. وبالفعل، تواجه طهران وواشنطن الآن ما أطلق عليه الباحث جيمس فيرون تسمية “مشكلة الالتزام”. وربما يفضل الطرفان المخرج الدبلوماسي لكنهما يمتلكان حوافز قوية لتجنب المفاوضات، خصوصاً أن كلاهما يفتقد الثقة بالآخر ويعتقد بأنه سيتنكر لأية صفقة في المستقبل. وفي الولايات المتحدة، سيستمر الانقسام الاستقطابي الشرس في صد السبيل عن أي بديل مناسب ومتفق عليه بين الحزبين، عن “خطة العمل المشتركة الشاملة”.
بالتأكيد لن تزيد حرب الـ12 يوماً، من ثقة المرشد الإيراني بالولايات المتحدة أو “مجموعة 5 +1″، وهي الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي المشاركة في صفقة عام 2015، بل بات اليوم يعتقد بأن السلاح النووي يشكل الضمانة الوحيدة التي يحترمها خصوم إيران. ويرجح أنه يرغب في متابعة أية مفاوضات مستقبلية من موقع القوة. ففي وقت تسعى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “بسرعة” رداً على عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، يدرس المجلس، البرلمان الإيراني، تشريعاً يوصي بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في تكرار للخطوة الحاسمة التي اتخذتها كوريا الشمالية في طريقها إلى امتلاك قنبلة نووية قبل عقدين من الزمن.
ولا يزال بإمكان صانعي السياسات في الولايات المتحدة ثني الدول الطامحة عن السعي وراء القنبلة النووية. فقد صمدت ركائز أساسية في سياسة منع الانتشار الأميركية أمام اختبار الزمن حتى في أصعب أيام الحرب الباردة وما بعدها. وإن التمسك ببنية الردع الموسع للولايات المتحدة وتعزيزها يمكن أن يطمئن الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا، فلا يسعون إلى مظلة أمان نووية خاصة بهم، مما قد يعرضهم لهجمات خطرة إذا حاولوا ذلك. وينبغي للمسؤولين الأميركيين أن يوضحوا الكلف الباهظة لمثل هذا السعي لأية دولة تفكر في الانتشار النووي، بما في ذلك قطع المساعدات العسكرية ووقف التجارة المرتبطة بالأنشطة النووية وفرض العقوبات والتهديد بالعمل العسكري. والأهم من ذلك أن على القادة الكبار الاعتراف بسجل معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الدولي لمنع الانتشار واحترامه: فواقع أن تسع دول فقط تملك أسلحة نووية اليوم، وليس 25 كما توقع الرئيس الأميركي جون كينيدي يوماً، لم يكُن نتيجة الحظ، بل ثمرة عقود من الاهتمام الرئاسي المباشر خلال الحرب الباردة، حين كان الملف النووي مسألة استراتيجية كبرى، وأولوية للدبلوماسية الأميركية القوية والمتواصلة في مجال منع الانتشار.
وفي المقابل، سيؤدي تخلي الولايات المتحدة عن 80 عاماً من سياسة ناجحة إلى حد كبير في حظر الانتشار، مع خبراتها وممارساتها إلى تحفيز الحلفاء والخصوم على حد سواء أن يتولوا بأيديهم أمر سياسات الضمان النووي. ولسوف لن تفلح حرب الـ12 يوماً في ثنيهم عن ذلك. وبالنسبة إلى الراغبين المحتملين في الحصول على السلاح النووي، فإن الاعتماد على الولايات المتحدة في المستقبل للوفاء بوعودها حول صفقة كتلك التي وقعت مع إيران عام 2015، سيبدو رهاناً سيئاً. وبالنتيجة، استنتج كيم جونغ إيل أن أخطار التعامل مع الولايات المتحدة والنظام الأميركي المتخبط، لا تتساوى مع المنافع المتوقعة منه. ولقد سرع ابنه كيم جونغ أون الخطى في ذلك الاتجاه. وربما افترض المسؤولون الإيرانيون أن ترمب قد يسعى إلى الدبلوماسية بقوة أكبر خلال ولايته الرئاسية الثانية، فيما بدا أن تقرب إدارته من إيران خلال ربيع عام 2025 يؤشر على ذلك المنحى. وفي المقابل، تبدد ذلك الأمل في يونيو، مع تدمير المنشآت الرئيسة التي أوصلت إيران إلى عتبة السلاح النووي أكثر من أي وقت مضى.
ومع ذلك، وعلى رغم هذه النكسة القاسية، فإن التقدم التقني الإيراني وقاعدة المعرفة الكبيرة التي راكمتها، إضافة إلى الكميات الضخمة من المواد النووية التي خزنتها سابقاً، ربما ما زالت قائمة. وقد تجد طهران نفسها أمام فرصة لإعادة المحاولة، وإذا حصل ذلك، فمن المرجح أن تسلك النهج الكوري الشمالي وألا تتوقف قبل الوصول إلى القنبلة. وفي تلك الحال، قد تشق إيران مسارها الخاص في سياسة الضمان النووي المناسب لزمن نووي جديد وفوضوي. والمفارقة أن العمل العسكري الأميركي ضد البرنامج النووي الإيراني ربما سرع وشدد وأخفى في الوقت ذاته مسيرة الطامحين إلى القنبلة.
فيبين نارانغ هو بروفيسور في كرسي فرانك ستانتون يحاضر في الأمن النووي وعلم السياسة، وهو مدير “مركز سياسات الأمن النووي” في “معهد ماساشوستس للتكنولوجيا”. وبين عامي 2022 و2024، شغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الفضائية، ثم قائماً بأعماله.
براناي فادي هو باحث بارز في الشؤون النووية في “مركز سياسات الأمن النووي” التابع لـ”معهد ماساشوستس للتكنولوجيا”. وبين عامي 2022 و2025، شغل منصب المدير الأول للرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأميركي.
مترجم عن “فورين أفيرز”، 5 سبتمبر (أيلول) 2025