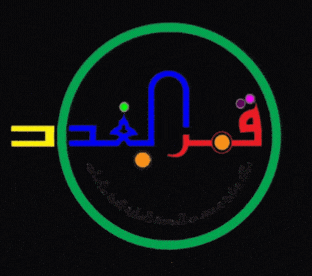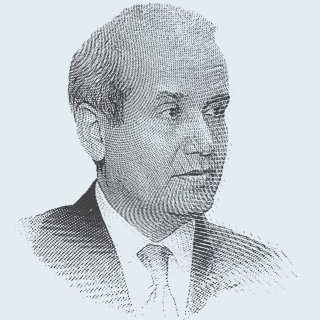لطفية الدليمي
أظنّكم جميعاً مررتُمْ بهذه التجربة المثيرة والمخيفة معاً. ترى تأريخ اليوم فتدركُ أنّ عشرة شهور تقريباً مضت من هذه السنة 2025، ولم يتبقَّ منها سوى القليل الذي سيمرّ مثل رصاصة. ستنتهي السنة عمّا قريب. تتساءل: ما الذي فعلتُهُ خلالها؟ تنتابُك مخاوف عميقة بأنّك لم تعُدْ تمسكُ بلجام الزمن الذي صار يتبدّدُ كالبخار في الهواء. الزمن ليس عنصراً محايداً أو رقماً بمستطاعنا تهميشهُ أو غضّ الطرف عنه. هو مرتبط عضوياً بأعمارنا، ورؤيتنا لأنفسنا وما صنعناه بحياتنا وما أنجزناه في سنوات. الزمن يتقدّم على المكان، وهو العنصر الأساسي (بمعنى الأوّل) في كلّ نظرية فيزيائية حقيقية، كما أنّه العنصر المرجعي الأوّل في كل خبرتنا الحياتية وتقديرنا لأنفسنا وما صنعناه بحياة مُنِحت لنا كجائزة كونية، وعلينا عدمُ التفريط بها أو التعاملُ معها بخفّة النزقين وعبث الطائشين.
يتشارك الزمن خصيصَتَيْ الجوهرية والوَهْم. هو بمقدار جوهريته الأساسية فهو وهم خالص. ليس مهمّاً أن يكون وهماً نفسياً أو ذهنياً. يبقى وهماً في كلّ الأحوال. لن أستعين بالمثال السائد عن آينشتاين وتعبيره عن النسبية بسرعة مرور الزمن عندما نعيش أوقاتاً طيبة، وبثقل هذا الزمن ذاته عندما نعيش أوقاتاً تعيسة. الأمرُ أكبر من هذا المثال القياسي البديهي. لنفكّرْ مثلاً عندما كنّا صغاراً في المدرسة: كان يوم الجمعة يبدو سريعاً لأنّه متخمٌ ببهجة التحلل من الإلتزامات المدرسية الثقيلة، ثم مع بدء السبت يعود الزمن لإيقاعه المتثاقل؛ لكننا عندما نتذكّرُ الآن أيام الجمعة في تلك السنوات البعيدة تبدو لنا وكأنّها سنة كاملة بالقياس مع أيام الجمعة الحالية. أما العطلة الصيفية أيامذاك فكانت أقرب لعَقْد من السنوات بالمقارنة مع عطل الصيف الحاضرة. وهل بقيت عطلة صيفية حقيقية هذه الأيام؟ صارت أيامنا الحاضرة نسخة مكرورة حتى باتت مصداقاً حياً لقول الشاعر ( تشابَهَ يوماه علينا فأشكلا ……. ولا نحنُ ندري أيُّ يَوْمَيْه أفضلُ).
المعضلة هذه لها جذورها العميقة في علم النفس الإدراكي والعلوم العصبية، وبخاصة في شأن ميكانيكية عمل الذاكرة والروتين، أي بعبارة دقيقة: كيف يعمل الدماغ البشري في معالجة المعلومات وتخزين الذكريات؟ الأمر الجوهري يختصُّ بتأثير الإدراك في أحساسنا بالزمن من حيث كثافة الإدراك وجدّة عناصره. منذ عقود بعيدة تأكّد علماء النفس من أنّ إحساسنا بفترة زمنية معينة عند تذكّرها لاحقاً يعتمد بشكل كبير على كمية وتنوع المعلومات الجديدة التي سجّلها الدماغ خلال تلك الفترة: بالنسبة للطفل، العالَمُ كلّه هو مكان جديد. كلّ يوم يحمل تجارب غير مسبوقة: أول يوم في المدرسة، أول ركوب دراجة، التعرف على وجه جديد، تعلّمُ كلمة جديدة،،،. يتطلّبُ الدماغ كمية هائلة من الطاقة لمعالجة وتشفير هذه الأحداث كـذكريات تفصيلية ومستقلة. هذه الكثافة العالية في التشفير تخلق ما يسمى «ذاكرة كثيفة»، وعندما نتذكرها تبدو الفترة الزمنية التي استغرقتها أطول بكثير بالمقارنة مع أزمان لم نفعل فيها شيئاً. ثمّ تأتي مرحلة البلوغ والروتين المصاحب لها. مع التقدم في السن تصبح الحياة أكثر روتينية: العمل اليومي، المهام المنزلية، الطرق المعتادة. على المستوى العصبي يواجه الدماغ كمية أقل من التجارب الجديدة التي تتطلب تشفيراً مكثّفاً، وبدلاً من تسجيل كلّ يوم كحدث فريد يبدأ الدماغ في تجميع الأيام المتشابهة في «ملف ذاكرة» واحد وغير مفصّل. هذا النقص في الذكريات البارزة والمميزة يقلل من كثافة الذاكرة، وبالتالي، عند التفكير في العام الماضي المليء بالروتين نشعر أنه مرّ بسرعة البرق. لنختصر القول: كلّما كانت حياتنا (ذاكرتنا) مشحونة بذكريات نوعية خلقت انعطافات مميزة في حياتنا كان شعورنا بالزمن أكثر امتلاء وكثافة. الحياة الخاوية الروتينية تخلق ذاكرة يصبح فيها الزمن وكأنّه عنصر مشاعي مجاني لا نشعر به.
ثمّة عنصر آخر في ميكانيكية التعامل مع الزمن. إنّه الإنتباه. يلعب الانتباه دوراً حاسماً في إدراك الزمن. عندما نركّزُ على مهمة ممتعة ومحفزة، يقلُّ انتباهنا لمرور الزمن . يحصل أمرٌ معاكس تماماً عندما نشعر بالملل أو ننتظر، حينها نصبح واعين بكل ثانية تمرُّ ببطء مؤلم. مع التقدّم في العمر يزداد عدد المهام الروتينية التي يمكن إنجازها «تلقائياً» دون تركيز كامل من جانبنا؛ ممّا يقلل من وعينا اللحظي بالزمن. في المقابل يزداد الإنشغال بالحياة ومتطلباتها (العمل، الأسرة، المسؤوليات)؛ مما يشتّت الإنتباه بعيداً عن مراقبة «عدّاد الزمن الداخلي»، وهذا يساهم في الشعور بمرور الزمن دون ملاحظته.
هناك أيضاً تفسير رياضياتي لمعضلة إدراكنا للزمن. هذا التفسير هو الأكثر بساطة وإقناعاً. جوهر هذا التفسير أنّ الإنسان يُدرك مدة العام الواحد مقارنة بإجمالي المدة التي عاشها حتى تلك اللحظة، وكلما زادت الفترة الزمنية التي عشتها قلت القيمة النسبية لأي وحدة زمنية جديدة؛ مما يقلل من أهميتها الإدراكية في عقلك. هاكُم مثالاً: يمثل العام الواحد خُمْسَ حياة طفل بعمر الخامسة؛ في حين تتضاءل قيمته النسبية في الأعمار المتقدّمة.
بالإضافة إلى العوامل النفسية، تشير بعض الأبحاث إلى وجود تغييرات بيولوجية في الدماغ قد تؤثر على نظامنا الداخلي لتوقيت الزمن. يحصل في العادة تباطؤ في معالجة البيانات الحسية. يرى بحّاثة كثيرون أنّ إحساسَنا بالزمن ينبع من السرعة التي يتمُّ بها معالجة الصور الذهنية. مع التقدم في العمر تتدهور الشبكات العصبية الدماغية ويتضرر المسار الذي ينقل الصور الحسية؛ مما يؤدي إلى تباطؤ في معالجة هذه الصور. ستكون النتيجة المتوقّعة هي التالية: يحتاجُ دماغ الشخص المسن “وقتاً” أطول من الوقت الذي يجتاجه الطفل للمعالجة البصرية للمشهد الواحد الذي يريانه، وهذا بالضبط ما يجعل المتقدّمين بالأعمار يشعرون بأنّ الوقت الخارجي يمرّ أسرع من عدّاداتهم الزمنية الذاتية التي تسمّى في الأدبيات السائدة (الساعة البيولوجية).
لنغادر الآن النظريات العصبية والإدراكية الخاصة بظاهرة تسارع الزمن مع تقدّم العمر؛ إذ يمكن للراغب في الإستزادة منها أن يقرأ بشأنها في كتب مرجعية عديدة. السؤال الأهم: هل يمكن إبطاءُ الإحساس بالزمن؟ هل يمكننا تخفيفُ هذه الظاهرة التي تصيبنا بإكتئاب مَرَضي عندما نشعر أنّ الزمن يتسلّلُ من أيدينا كخيط دخان في الهواء؟ نعم يمكن ذلك. الإحساسُ بتسارع الزمن مع التقدم في العمر ليس قدراً محسوماً؛ بل هو ظاهرة تعتمد في المقام الأول على نوعية التجارب المكتسبة، وطبيعة الحياة التي عشناها. إذا كان السبب الرئيسي لهذا التسارع هو الروتين ونقص الذكريات الجديدة فإنّ العلاج يكمن في إحداث تغيير جذري في نمط الحياة. كلمة السرّ تكمنُ في اكتساب تجارب جديدة باستمرار: ممارسة هوايات جديدة، السفر إلى أماكن لم تُزَرْ من قبل، التسجيل في دورات تعليمية (وما أكثرها اليوم على الشبكة العالمية، وبالمجان!!)، أو تعلّم مهارة جديدة تماماً. هذه الأنشطة ترغِمُ الدماغ على العمل بجهد لتشفير معلومات غير مألوفة؛ مما يخلق ذكريات كثيفة تجعل الفترة الزمنية تبدو أطول عند تذكرها. نحن بعملنا هذا نخلق مثابات مرجعية تكثّفُ احساسنا بالزمن وتنفي عنه صفة العنصر المشاعي الروتيني رخيص الثمن. حتى التغييرات البسيطة -مثل تغيير المسار اليومي للعمل أو تناول الطعام في أماكن مختلفة- يمكن أن تساعد في «إيقاظ» الدماغ من حالة التلقائية السلبية الكسولة. ثمّ هناك التأمل والوعي اللحظي: التركيز على اللحظة الحالية ومحاولة إدراك كل التفاصيل الحسّية المحيطة يمكن أن يقوي ارتباطنا بـ «الآن» ويقلّلُ من الشعور بأنّ الحياة تنساب منّا دون وعي، مثل لصّ يتسلّلُ في ليل. الحياة تضيع وتصبح خسارة مؤكّدة وعذاباً مؤبّداً عندما نتغافل عن الحاضر ونغرق في استذكار مرارة الماضي أو التحسّب القاتل لقلق المستقبل.
لا تجعلْ حياتك ملفاً لذاكرة مهملة في دماغك. افتح ملفات جديدة. لا تجعل حياتك رهينة مأسورة بماضٍ ومستقبل. عش الحاضر واستزد في ثراء خبراتك بكلّ الأشكال الممكنة. حينها فقط لن تأسى على زمنك (عمرك) الذي يتبدّد كخيط دخان تحسبُ نفسك عاجزاً عن اللحاق به.