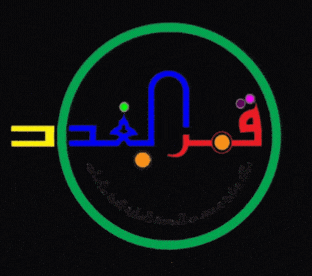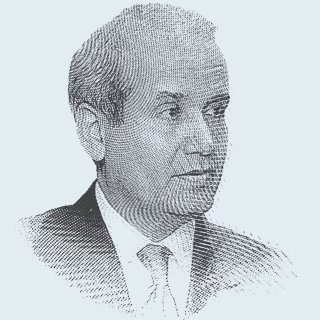إن هشاشة السلام في مجتمعات ما بعد الصراع تنبع من تحدٍّ ثلاثي الأبعاد، يتمثل في استمرار العنف الهيكلي الذي لم يُحَلَّ، والمعضلات المعقَّدة لتطبيق العدالة الانتقالية، والحواجز الاجتماعية – النفسية المتجذرة التي تعيق المصالحة الحقيقية.
ولعلَّ تحليل هذه العقبات المترابطة يكشف عن سبب بقاء العديد من المجتمعات في حالة هشة من السلام السلبي، معرضة بشكل دائم لخطر الانتكاس والعودة إلى الصراع العنيف.
وقد نفهم أسباب هشاشة السلام في بعض الدول في منطقتنا العربية (سوريا، العراق، لبنان، اليمن)، سواءً كانت الصراع الطائفي والقومي، أو غياب حل سياسي شامل، وغياب العدالة الانتقالية، واقتصاد منهار وبطالة وفقر، ونفوذ المليشيات، فهو استقرار قابل للانفجار إن لم تعالج جذور الصراع.
إن الإنهاء الرسميَّ للصراع المسلَّح، والذي غالباً ما يرمز إليه بتوقيع اتفاق سلام وإسكات الأسلحة، يمثل منعطفاً حاسماً للمجتمعات الخارجة من فترات العنف الشديد، وهذا ما تشهده منطقتنا العربية، وتُعرَّف هذه الحالة، التي تتميز بغياب الحرب المباشرة، في إطار دراسات السلام والنزاعات بأنها “السلام السلبي” (غالتونغ، 1969).
وعلى الرغم من أن السلام السلبي خطوة أولى لا غنى عنها، إلا أنه حالة غير مستقرَّة وغير مكتملة بطبيعتها، فالهدف الأسمى لبناء السلام المستدام هو ترسيخ “السلام الإيجابي”، وهو حالة أشمل بكثير تتَّسم بوجود مؤسَّسات عادلة، وهياكل اجتماعية منصفة، والقدرة على حلِّ النزاعات الراسخة بالوسائل السلمية.
أحد العوامل الرئيسة التي تقوِّض الانتقال إلى السلام الإيجابي هو استمرار العنف الهيكلي لفترة طويلة بعد انحسار العنف المباشر، لقد صاغ يوهان غالتونغ (1969) مفهوم العنف الهيكلي على أنه الضرر والظلم المتأصِّلين في النُّظُم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي تمنع الأفراد بشكل منهجي من تحقيق كامل إمكاناتهم.
فالصراعات لا تنشأ من فراغ، بل تكون تجسيداً لمظالم متجذِّرة تتعلَّق بالتهميش السياسي، أو التفاوت الاقتصادي، أو التمييز العرقي، أو التوزيع غير العادل للموارد.
ولا يخفى أن اتفاقيات السلام، خاصة تلك التي يتم التفاوض عليها تحت ضغط دولي مكثَّف، لا تهتم بالإصلاحات الداخلية، ونتيجة لذلك، تظل الأسباب الجذرية للصراع دون معالجة إلى حدٍّ كبير.
على سبيل المثال، قد تؤسس اتفاقية السلام لترتيبات تقاسم السلطة بين النخب، لكنها تفشل في إصلاح القضاء الفاسد، أو تنفيذ إصلاحات زراعية ضرورية للتخفيف من حدَّة الفقر في بعض طوائف المجتمع.
وإنه في أعقاب العنف الجماعي، تواجه المجتمعات ضرورة مؤلمة للتعامل مع الفظائع المرتكبة في الماضي، وهي عملية تُعرف على نطاق واسع بالعدالة الانتقالية.
من جهة أخرى، فإن التركيز المفرط على الآليات التصالحية، مثل لجان الحقيقة والمصالحة التي تمنح العفو مقابل الإدلاء بالشهادة، قد يكون ضرورياً لإنشاء سجل تاريخيٍّ مشترك، ولكنه قد يُعزِّز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يترك الضحايا يشعرون بأن معاناتهم قد تم تجاهلها، وذلك بسبب الفشل في التعامل بفعالية مع معضلة “السلام مقابل العدالة”، لأن هذا الفشل يمكن أن يرسخ الانقسامات المجتمعية، وبهذا تظل الدوافع العاطفية للصراع السابق قوية وفعالة، وهذا العداء المستمر يترك المجتمع عرضة للاستغلال، وإعادة التعبئة، مما يضمن أن أي سلام يتم تحقيقه ليس سوى هدنة مؤقتة في دائرة عنف أطول أمداً.
وبعيداً عن الأطر المؤسسية والقانونية، فإن أعمق العوائق التي تحول دون تحقيق السلام الإيجابي غالباً ما تكون جراح الحرب غير المرئية، يلحق الصراع العنيف صدمات نفسية-اجتماعية عميقة ودائمة بالأفراد والمجتمعات؛ مما يحطم الثقة الاجتماعية، ويُعزِّز الهويات الجماعية العدائية.
في الختام، إن الرحلة من السلام السلبي الهش إلى السلام الإيجابي الدائم هي مسعى متعدد الأبعاد وشاق؛ فاستقرار مجتمعات ما بعد الصراع مهدد باستمرار بالإرث الذي لم يتم حله من العنف الهيكلي، وعملية الموازنة الدقيقة للعدالة الانتقالية، والندوب النفسية-الاجتماعية العميقة التي خلَّفتها الحرب.
والحقيقة أن هذه التحديات ليست منفصلة، بل مترابطة بعمق، فالفشل في معالجة عدم المساواة المنهجية يؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجموعات، في حين أن الشعور بغياب العدالة يمكن أن يؤجِّج الجراح النفسية ويمنع المصالحة.
لذلك فإن الحل المستدام يتطلَّب نهجاً شموليّاً ومتكاملاً وطويل الأمد، إذ يجب أن تتجاوز جهود بناء السلام تحقيق الاستقرار الأمني قصير المدى، وأن تسعى بنشاط إلى إصلاحات تحويلية تعالج المظالم الاقتصادية والسياسية الجذرية.
كما يجب أن يُستكمل ذلك- وهذا هو الأهم- باستثمار مستمر في برامج المصالحة على المستوى المجتمعي، تلك البرامج التي تعمل على إصلاح الثقة الاجتماعية وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.