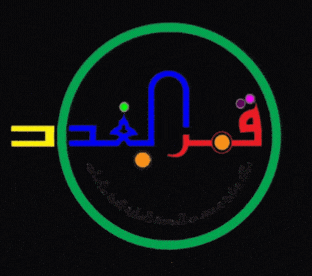الشرق الأوسط
شفق نيوز- دمشق
تنتصب محطة الحجاز في بداية “شارع النصر” وسط العاصمة السورية دمشق، كوثيقة بصرية دامغة تسرد فصلاً معقداً من تاريخ الهندسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويمثل هذا الصرح، الذي دُشّن مطلع القرن العشرين، ذروة الطموح العثماني في توظيف التكنولوجيا لخدمة “الجامعة الإسلامية”، مشكلاً ظاهرة معمارية واقتصادية تستحق التفكيك والدراسة المعمقة، بعيداً عن السرديات العاطفية المجردة.
وتُعد كتلة مبنى محطة الحجاز بدمشق نموذجاً فريداً لما يُعرف في أدبيات العمارة بـ”النزعة التوفيقية” أو (Eclecticism)، حيث نجح المصمم (المعماري الإسباني فرناندو دي أراندا) في صهر مفردات العمارة الأوروبية الكلاسيكية مع الروح الشرقية العثمانية.
ويتميز المبنى باستخدام “الأبلق” الدمشقي (تناوب المداميك الحجرية السوداء والبيضاء) بأسلوب يحاكي القصور المملوكية، مع توظيف ذكي للأقواس المقنطرة (Arches) التي تعلو النوافذ، ما يمنح الواجهة إيقاعاً بصرياً متناغماً.
ويجمع الفضاء الداخلي والسقف التصميم الداخلي بين الرحابة الوظيفية لمحطات القطار الأوروبية والزخرفة الإسلامية، حيث تبرز الأسقف الخشبية المزخرفة (المعشقة)، والأعمدة الرخامية ذات التيجان المنحوتة بدقة، والزجاج الملون الذي يكسر حدة الضوء، مما يحيل صالة الانتظار إلى فضاء شبه مقدس يمهد لرحلة الحج.
ورغم توقف الوظيفة الأصلية (النقل السككي)، حافظ “الهيكل الإنشائي” على تماسكه، وتخضع الفراغات الداخلية حالياً لبرامج “إعادة الاستخدام التكيفي” كمركز إداري وثقافي.
خطط مستقبلية
بدوره، قال باسل محاميد، وهو موظف في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك خططاً مستقبلية قريبة لتحويل البناء بشكل كامل إلى متحف عن طريق شركات تركية متخصصة في ترميم الأبنية التاريخية، لضمان استدامة الأثر وصيانته وفق المعايير الدولية.
وأضاف أنه “طُرحت سابقاً مبادرات لإعادة تأهيل أجزاء من الخط لأغراض سياحية وثقافية، وربط دمشق بدرعا تحت اسم “قطار الحجاز السياحي، إلا أن الظروف السياسية والأمنية كانت عقبة أمام التنفيذ”.
ومن منظور الاقتصاد السياسي والتاريخ المالي، شكلت سكة حديد الحجاز “حالة دراسية” نادرة في زمنها، إذ تحدت الهيمنة المصرفية الأوروبية عبر نموذج تمويل ذاتي مستقل من خلال الاستقلال المالي فبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع قرابة 4 ملايين ليرة عثمانية ذهبية (رقم فلكي بمقاييس القوة الشرائية لذلك العصر).
واللافت أن التمويل لم يعتمد على القروض الأجنبية المكبلة للسيادة (كما حدث في مصر وتونس)، بل اعتمد على “اكتتاب إسلامي عام”، وتبرعات، وعائدات طوابع، وجلود الأضاحي، مما يجعله أحد أكبر مشاريع “التمويل الجماعي” في التاريخ الحديث.
واختزل الخط الزمن اللازم لرحلة الحج ونقل البضائع من 40 يوماً عبر القوافل التقليدية إلى أيام معدودة (نحو 72 ساعة)، ما أحدث ثورة في “سلاسل الإمداد” بين الشام والجزيرة العربية، وعزز مكانة دمشق ك “ميناء جاف” ومركز توزيع تجاري إقليمي، رابطاً إياها بميناء حيفا والمدينة المنورة.
ولم يكن الخط مجرد مشروع ديني، إنما كان تحركاً إستراتيجياً عسكرياً بامتياز ضمن رؤية السلطان عبد الحميد الثاني، أما عسكرياً فهدف الخط إلى نقل الجنود والمؤن بسرعة إلى الولايات الجنوبية (الحجاز واليمن) لتثبيت النفوذ العثماني وتأمين البحر الأحمر بعيداً عن قناة السويس التي كانت تحت السيطرة البريطانية.
وامتد الخط الرئيسي جغرافياً من دمشق عبر درعا (التي شكلت عقدة مواصلات محورية ونقطة تفرع نحو حيفا والأردن) وصولاً إلى المدينة المنورة، بطول تجاوز 1300 كم، وبعرض سكة ضيق (1050 ملم) لتقليل التكاليف وتسريع الإنجاز في التضاريس الصحراوية الوعرة.
وانتهت الوظيفة التشغيلية للخط تدريجياً عقب التخريب الممنهج الذي طاله خلال الحرب العالمية الأولى (الثورة العربية الكبرى) لدواعٍ عسكرية، وتحولت المحطة في دمشق اليوم من “بنية تحتية حيوية” إلى “أصل تراثي” ورغم تعثر مشاريع الربط السياحي الحديثة (مثل قطار الحجاز السياحي) بسبب الظروف الأمنية والجيوسياسية المعقدة، تظل المحطة وثيقة معمارية حية وشاهداً على حقبة حاولت فيها المنطقة صياغة مستقبلها بسواعدها وأموالها، وتنتظر الآن رؤية استثمارية تعيد دمجها في النسيج الاقتصادي والثقافي المعاصر لدمشق.