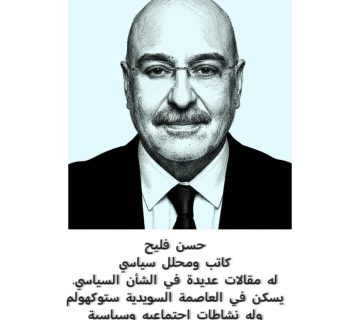الكارثة على أبواب الشتاء
يعيش ملايين من السوريين والعراقيين في مخيمات النزوح المجاورة لمدنهم المدمّرة. ظروف إقامتهم في مخيماتهم رهيبة على ما كشفت الأمم المتحدة في بيانها أول من أمس، عندما تحدثت عن مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية. ونحن اليوم على أبواب فصل الشتاء، وهو ما يجعل الكارثة أكبر، إذ إن المناطق الصحراوية التي تنتشر فيها هذه المخيمات تعيش شتاء قارساً أين منه حرها في الصيف.
والحال أن فكرة المخيم صارت جزءاً من مشهد عادي بفعل الحروب التي لم تكف منذ سنوات عن الفتك بمدننا، وعن تحويلها أكواماً من الحجارة. ولا يبدو أن نهاية الحرب تعني عودة السكان. ثمة مدن مثل الرمادي مثلاً ما زالت العودة إليها غير ممكنة على رغم القضاء على «داعش» الذي كان يحتلها. والعودة غير الممكنة سياسية أيضاً، ذاك أن المنتصرين في الحروب على المدن لا يأمنون إلى عودة السكان، وأحياناً لا يريدون عودتهم لأسباب ديموغرافية سياسية. هذه حال حمص مثلاً، والأرجح أن تكون حال سكان الشاطئ الأيمن من الموصل، والذي تبلغ نسبة الدمار فيه نحو 90 في المئة. كما أن العودة تعيقها في حالات أخرى ما خلفه التنظيم من ضغائن بين السكان، فالمدانون بالعلاقة مع التنظيم ليسوا أفراداً قليلين، وفي بعض المدن قد تفوق أعدادهم أعداد ضحايا التنظيم.
في وجه العودة عقبات كثيرة. إعادة الإعمار إذا ما توافرت النية لمباشرتها، وهي غير متوافرة، أكلافها تفوق قدرات الدول صاحبة المدن وصاحبة الدمار. التقديرات تقول أن المبلغ المتوقع لإنجازها في كل من سورية والعراق يتجاوز الأربعمئة بليون دولار، ولم يشر أصحاب هذا الرقم إلى ما إذا كانوا احتسبوا فيه نسب الفساد المتوقع أن يتخلل الإعمار إذا ما بوشر به.
إذاً علينا التعامل مع هذه المخيمات بصفتها مستقراً لسكانها لا بصفتها أمكنة إقامة موقتة. وهو ما يعني أيضاً أن البؤس المرافق لهذه الإقامة سيتحول نمط عيش للجماعات المقيمة فيها، وليس لحظات استثنائية في مسار حياة طبيعية. العيش في المخيم، ووفق الظروف البائسة لجهة الدواء والغذاء والتعليم، سيكون نمط عيش، وسيترافق مع انعدام الشرط الأمني وما يعنيه ذلك من احتمالات استثمار في هذه البيئة. ونحن هنا نتحدث عن ملايين السكان، ونتحدث عن مدنهم المدمرة في جوار سكنهم الجديد، وبعض هؤلاء صار له في المخيم نحو خمس سنوات. الأطفال الذين وصلوا دون سن العاشرة الى المخيم صاروا اليوم على أبواب المراهقة. خمس سنوات من دون تعليم. وهذه الحقيقة ليست استحقاقاً تربوياً وحسب، إنما استحقاق أمني وثقافي واجتماعي. فنحن نتحدث عن أجيال جديدة من الأميين، وعن أهل يفوقون أولادهم تعليماً، وعن علاقات جيلية عنيفة، وعن ضغائن اللجوء.
سيسهّل هذا الوضع المهمة على أي راغب في تحويل البؤس حرباً، وفي الاستثمار في الجهل والأمية. ووسط كل هذا الخراب سيلوح مسخ «ما بعد داعش». الكثير من الشروط متوافرة، وأكثرها إلحاحاً هو ظروف العيش في هذه المخيمات. فالشتاء يقترب، والفتية على أبواب مرحلة يختمر فيها بؤسهم ويتحول عنفاً مُستأنفاً وموصولاً بعنف من سبقهم.
المخيمات هي مستقبل المنطقة المنكوبة، وستكون قريباً مستقبل المنطقة. الكارثة التي حلت في المدن ستولد كوارث موازية. زيارة سريعة إلى أي مخيم تعزز هذا الاعتقاد، بل تحسمه. النظر في وجه طفل على أبواب الفتوّة سيأخذك فوراً إلى مستقبله. لا أحد سيأخذ بيد هذا الفتى إلى مستقبله سوى المستثمرين في الخراب. وبعد سنوات قليلة سيأتي من يبحث عن مصادر الحرب والتطرف والغلو، ولن يلفته أن هذا الفتى كان طفلاً منتظراً في مخيم بائس، وأنه لم يجد من يسعفه ومدرسة تستقبله، وأن أفق عنف هو ما أتيح له، فكان ما كان.