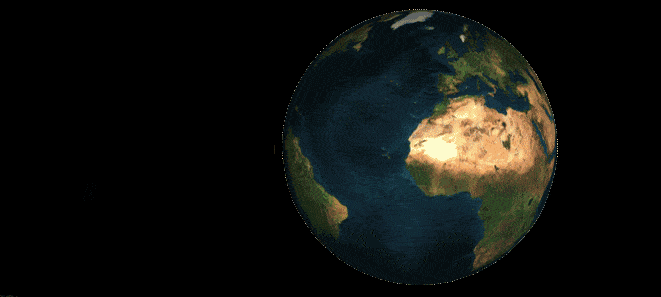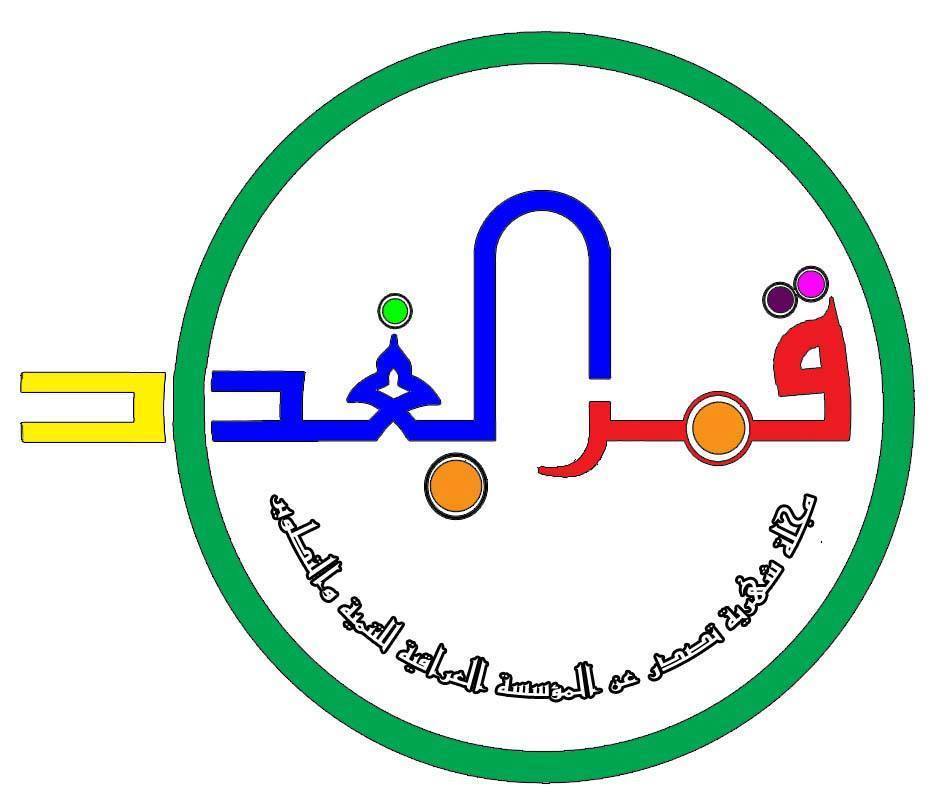فهد الدغيثر
تعددت الأقوال حول شرعية الحكومات، وخصوصاً في محيط الدول النامية في الـ50 عاماً الماضية. أقول الدول النامية لأن الدول العظمى حسمت مواقفها بعد الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من دمار مروع ووضعت خطوط المستقبل في قبضة دولة القوانين والمؤسسات حيث التعايش المشترك والتركيز على التنمية وبناء القوة. أذكر في سنوات المراهقة أن شعار «الناصرية» المتمثل بالوحدة العربية وطرد الاستعمار كان يمثل الشرعية الأقوى لبقاء حكومة جمال عبدالناصر. كان شعاراً مدوياً ألهب عقول العرب آنذاك لكنه بقي مجرد شعار. أيضاً في السياق الزمني ذاته، تأسست منظومة ما كان يسمى «دول عدم الانحياز» برئاسة الهند ويوغسلافيا ومصر وكان دورها عبارة عن وجود تكتل أممي يحاول الوقوف ضد أطماع الدول العظمى في الأمم المتحدة. في الحالة المصرية تحديداً، وبخلاف بناء السد العالي الذي افتتح في عام ١٩٧٠ وهو بلا شك مشروع تنموي عظيم، لم تشهد مصر تنمية حقيقية مستدامة تسير وفق خطط وأهداف ومؤشرات محددة. كان تركيز الدولة آنذاك منصباً نحو الاستمرار في تأميم الممتلكات ورفع شعارات الديموقراطية ومحاربة الأنظمة «الرجعية».
شعار «الوحدة العربية» فشل في أول تجربة وحدوية مع سورية لأنه افتقد إلى الركائز الأساسية المتمثلة بالقوة الاقتصادية والعمل المشترك الذي يصب في هذا الوعاء. مواجهة العدو الإسرائيلي التي تحولت وإلى يومنا هذا شعاراً للتكسب والبقاء كما يدعي نظام الأسد، هي الأخرى تحطمت في حرب الأيام الستة كونها وقعت من دون مراجعة حقيقية لحسابات النصر والهزيمة واعتمدت كثيراً على الحماسة والخطب الرنانة وفي ما بعد على التزوير الإعلامي.
كان مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا واليابان الذي أعلن عنه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة الأركان الأميركية عام ١٩٤٧ المحرك الأعظم لما نشاهده اليوم من تنمية شاملة وصناعة متفوقة واقتصادات منيعة في الغرب واليابان. هذا المشروع اقتصادي بحت لا يحتوي على أي شعارات غير الأرقام ونموها ومتابعة الخلل في بعض جوانبها وتقويمه. الصين الغارقة في الأيديولوجيا الشيوعية وبعد تفتت الاتحاد السوفياتي، تبنت أخيراً النهج ذاته مع محاولاتها المستميتة للمحافظة على الحد الأدنى من ثقافتها، على رغم قوة أعاصير التغيير.
أكتب هذه المقالة أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا بعد انتهاء زيارته مصر. لو نتابع معظم المقالات والتقارير التي نشرت قبل وأثناء هذه الزيارة عن هذه الشخصية الفذة سنجدها تركز كثيراً على أن المحرك الأهم في ما يقوم به من تحولات هائلة داخل السعودية هو الاقتصاد. مبادرات التسامح الديني وكبح التطرف وإسكاته، إضافة إلى أمن الوطن والمواطنين والممتلكات، أتت بسبب الحاجة للتنمية وجذب رؤوس الأموال وخلق البيئة المناسبة للاستثمارات.
الانفتاح الاجتماعي بسبب الحاجة لرفع مستوى سعادة الناس ولتعظيم دورة رأس المال الداخلية وإنفاق المواطنين في داخل مدنهم وبلادهم. الرسوم الجديدة على المواطنين والمقيمين، ورفع الدعم عن بعض السلع، أتت بسبب الحاجة إلى الإقلال من الهدر المالي وزرع المسؤولية وكفاءة الإنفاق لدى الأفراد ولدى المنشآت العامة.
لا توجد مبادرة واحدة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠ ترتبط بشعارات قومية أو أيديولوجية. هنا تكمن قدرة الحاكم على وضوح الرؤية وملامسة الأهداف وتحقيقها. هنا بالتالي تولد شرعية الحاكم والحكومات وكيف يبرز القائد في أي مكان في العالم يتبع هذا النهج ويتحول إلى صانع تاريخ.
في منطقتنا العربية وخلافاً لدول الخليج العربي التي عاشت مخدرة لعدة عقود بسبب النفط ومداخيله، ما زلنا نمارس امتطاء الشعارات مع الأسف، ما عدا عدد قليل جداً من النماذج الخجولة. بل وحتى في دول الخليج نشاهد حالة الكويت مثلاً وصراع الحكومة مع مجلس الأمة الذي يراه البعض هناك شعاراً رمزياً كبيراً للحرية، بينما يراه الكثير من العقلاء سبباً في تأخر التنمية هناك رغم المحاولات الجديدة هذه الأيام لإعادة توجيه البوصلة. في السعودية وبفضل انتشار ما يسمى «الصحوة الإسلامية» في العقود الأربعة الماضية وعلى رغم تطوير مدينتي الجبيل وينبع وتأسيس العملاقة «سابك» وغير ذلك من المنجزات الضخمة، كان الشعار الأهم الذي طغى فوق كل شيء هو شعار نشر الإسلام ومعاداة غير المسلمين وتجييش الناس عاطفياً لمواجهة «الظلم» و «الطغيان». الإنجاز الذي كان يشعر به الكثير من الأفراد بل وحتى بعض المسؤولين في تلك الفترة كان يعتمد على الشعور والتباهي العاطفي وليس على الأرقام. استمر ذلك حتى بدأت الأرقام تفرض حضورها بقوة. فالأموال تخرج من الاقتصاد ولا تعود والسكان يزداد عددهم والبطالة كشرت عن أنيابها. حذر الكثيرون من هذا المشهد قبل ظهوره بعقدين غير أن الضجيج فــــــي ذلك الوقت كان أعلى ومثل هذه التحذيرات كانت تقابل بتــخوين من يتحدث عنها واتهام من يدعمها أو يتبناها بالانحياز للأنظمة الرأسمالية العلمانية. بمعنى أن المطالبة بالتنمية كان يرد عليها بعبارات أيديولوجية لا عــــلاقة لها بأي رسوم بيانية أو إيضاحات علمية.
نخلص هنا إلى القناعة بأن التنمية الاقتصادية الممتثلة للزمان والمكان والمعتمدة على القدرات المتاحة وليست الشعارات الفارغة، هي الشرعية الوحيدة لبقاء الحكومات بل واستمرار الدول وتطورها. ها نحن نشاهد ما تمر به إيران من غضب شعبي في الداخل تحاول حكومة روحاني التقليل من أهميته بلا نجاح يذكر. هذا ما لفت الانتباه عالمياً إلى شخصية ولي العهد الذي وجد أن البلاد لا تحتمل غير القفز، ولا أقول السير، إلى الأمام بلا تردد. وكما أشار في مقابلة نشرتها أخيراً، صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عندما أفصح الأمير عن أسباب السرعة الهائلة في تطبيق التغييرات داخل السعودية، قائلاً: «عندما يكون لديك جسد مصاب بالسرطان في كل أعضائه، سرطان الفساد، عليك استخدام العلاج الكيماوي، وإلا فإن السرطان سيلتهم الجسم». وما يقال عن الفساد يقال عن شح الوظائف وهرب الأموال للخارج وتفشي حالات التستر التجاري والهدر في الطاقة والمواد المدعومة.
في تصوري أن ما يحدث في دول الخليج العربي، وخصوصاً في الإمارات التي كانت سباقة في تبني نهج التطور والبحرين والسعودية أخيراً، والكويت سيتحول إلى نموذج عالمي يحتذى به. لا يوجد مكان آخر في العالم يشبه هذه الحال. دول ومجتمعات تعيش في ظل ثروات هائلة من الموارد الطبيعية لا يساورها أي قلق مالي لعقود متصلة ثم تضطر فجأة وبسرعة إلى التحول إلى مجتمعات منتجة. تحديات هائلة بكل المقاييس ومن سينجح في تجاوزها سيخلده التاريخ كشخصية عظيمة قد لا تتكرر.