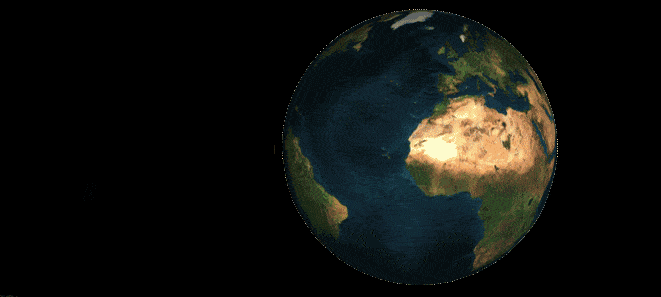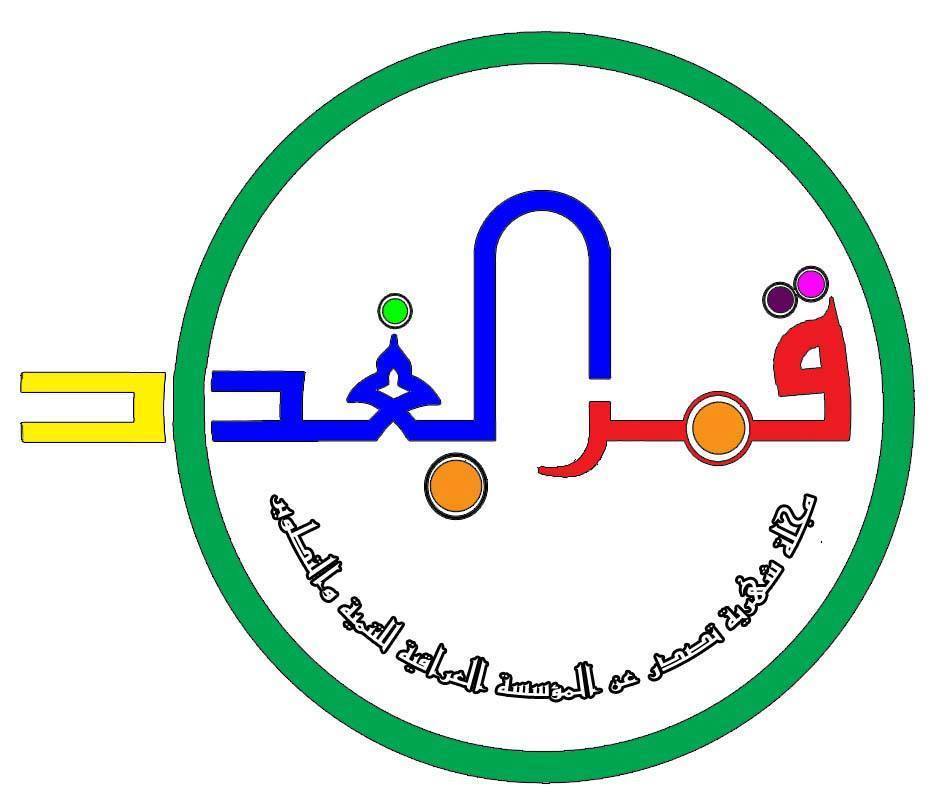الفيلسوف الألماني انتقد هيغل وبلغ بالوجدان أقصى مراتب الاختبار الروحي


الفيلسوف الألماني شلينغ (متحف الفلاسفة الألمان)
فريدريش ڤيلهلم يوزف فون شِلينغ (1775-1854) من أصعب فلاسفة الألمان الحديثين مَنالاً وأعظمهم قدرةً على استجلاء طبيعة الذات الإنسانية الكهفية الغامضة. ظلمه مؤرخو الفلسفة حين صنفوه في عداد الفلاسفة الألمان المثاليين، على غرار فيشته (1762-1814) وهيغل (1770-1831). ذلك بأن فلسفته تعيد النظر في حقيقة المذهب المثالي عينه، وتحثنا على تصور مثالية الذات الإنسانية في حدود انبساطها التاريخي. في كتاباته الأخيرة كشف أن الميتافيزياء المثالية لا تستطيع أن تُنصف غنى الوعي الذي يحمله الإنسان في صميم كيانه. ومن ثم، طفق يطلب إلى طلابه الجامعيين أن ينظروا نظراً ناقداً في مثالية الذات المقتدرة. غير أنه كان يدرك أن هيمنة هيغل لن تتيح له أن يصوب مسار المثالية المتطرفة. عاد الناسُ إلى اكتشاف صوابية فلسفته في القرن العشرين حين عقدوا العزم على التحرر من سطوة الميتافيزياء الغربية التي تنصب العقلَ سيداً مطلقاً على الكون.
الموهبة الفطرية الخارقة
وُلد شِلينغ في مدينة ليونبرغ الألمانية، وانتسب إلى المدرسة اللاتينية في نُرتينغن حيث أدرك أساتذته باكراً أن ذكاءه الاستيعابي الخارق يُعفيه من واجبات التعلم والامتحانات. في العام 1790 التحق بمعهد تُبينغن الإكليريكي البروتستانتي من أجل دراسة اللاهوت والفلسفة. فتعرف إلى هُلدرلين (1770-1843) وهيغل وصادقهما. انتشله فيشته من دراسة اللاهوت ودعوة الخدمة الكنسية على خطى والده القسيس، وحرضه على الاعتناء بالفلسفة. وما لبث أن نشر في العام 1794 بحثه الأول “في إمكان شكلٍ من الفلسفة على وجه الإطلاق” (Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt).

كتاب “روح العالم” بالترجمة الفرنسية (فناك)
تأثر بفلسفة كانط، لا سيما “نقد ملَكة الحكم”، وبفلسفة فيشته، خصوصاً “نظرية العِلم”. من جراء شهرته الفلسفية، وكلت إليه جامعة يانا كرسي أستاذ الفلسفة. فأتاح له التدريس الجامعي هذا أن يخالط الشعراء والفلاسفة الألمان، من أمثال الأخوين شليغل ونوڤاليس (1772-1801). في أثناء لقاءات الصداقة التي ربطته بأسرة الأديب الألماني أوغوست ڤيلهلم شليغل (1767-1845)، جذبته امرأة هذا الشاعر كارولينا ميخايليس-شليغل، فغُرم بها غراماً فائق الوصف، حتى إنه دفع بها إلى الطلاق والاقتران به العامَ 1803. في العام نفسه اضطر إلى مغادرة يانا والانتقال إلى مدينة ڤُرتسبرغ من أجل مواصلة التدريس الجامعي. ولكن بعد سقوط المدينة وإخضاعها للإمبراطورية النمسَوية-الهنغارية في العام 1805، غادر إلى مُنشن واستقر فيها حتى العام 1841، ما خلا فترةً انتقاليةً قطن في أثنائها بمدينة إرلانغن.
أصدر في العام 1809 دراسته الثمينة في الحرية الإنسانية (Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit). ولكنه فُجع بوفاة امرأته كارولينا، فاجتاحته مشاعر الحزن والإحباط. لم يستطع أن يتعافى من الصدمة الوجودية هذه إلا بعد أن عاد فاقترن بباولينا التي رافقته حتى الرمق الأخير من حياته. بعد وفاة هيغل في عام 1831، استُدعي إلى برلين ليجلس على كرسي أستاذية المعلم، ويكب على إعادة النظر في عمارته الفلسفية برمتها. في جامعة برلين استقطبت محاضراتُه أبرز طلاب الفلسفة، وفي مقدمتهم كيركغارد (1813-1855)، وألِكساندر هومبولت (1769-1859)، وباكونين (1814-1876)، وإنغلز (1820-1895). في برلين أيضاً انتُخب أمينَ سر أكاديميا الفنون الجميلة (1807-1820).

هيغل وشلينغ وهلدرلن (متحف الفلاسفة الألمان)
في أثناء إقامته في مُنشن، أخذ ينشئ منذ عام 1827 فلسفةً جديدةً مطبوعةً بالفكر المسيحي، فاجأت الكثير من زملاء جامعة يانا وطلابها الذين كانوا يعاينون فيه فيلسوفَ وحدة الوجود على الطريقة السبينوزية. ذاع صيتُه في أرجاء أوروبا، فانهالت عليه مبادرات الإكرام، وعُين رئيسَ أكاديميا العلوم في مُنشن، واختاره البلاط لتعليم ولي العهد البروسي الأمير ماكسيميليان. وما لبثت السلطات الأكاديمية أن عينته العامَ 1841 في جامعة برلين، عاصمة الهيغلية التي كان يعاين فيها تشويهاً لأفكاره الأُوَل التي صاغها في حقبة يانا. توفي عن عمر 79 سنة في باد راغاتس من مقاطعة سانكت غالن بسويسرا.
من الأحداث التي طبعت مسيرته الجامعية أن طلابه كانوا يحفظون أماليه الجامعية التي كان يتردد في نشرها. فإذا بالطبعات القرصنية تتكاثر وتثير حفيظة الفيلسوف، ومنها طبعة صديقه باولوس الذي نشر الأملية من غير موافقة المعلم. لذلك رفع شلينغ دعوى القرصنة أمام القضاء، وما لبث أن خسرها، فاضطر إلى الاستقالة من الجامعة والانكفاء إلى عزلته. تجدر الإشارة إلى أنه في سنوات تدريسه الجامعي لم يُمسك نفسَه عن تجربة الإنشاء الأدبي، فباشر بكتابة روايته “كلارا” من غير أن يُنهيها. اللافت أيضاً أنه منذ عام 1813 كف عن نشر مخطوطاته، ولو أنه واصل الكتابة من أجل ضبط عمارته الفلسفية.
التطور الإنضاحي في بناء العمارة الفلسفية
يجمع الباحثون على صعوبة الإمساك بالخيط الناظم الذي حاك به شلينغ نسيج تصوراته الفلسفية. ذلك بأن تعاقب الآراء المتباينة في مؤلفاته تمنع القارئ من الفوز بوحدة الأنظومة الفلسفية. قد يكون أصلُ التباين مرتبطاً بالرغبة في الانعتاق من كل أصناف البناء الأنظومي المتماسك. لا غرابة، والحال هذه، من أن يتحول الإعراضُ عن البناء الممنهَج أسلوباً في التمرد على الفلسفة وعلى دعوتها التقليدية المأثورة. حين يعلن هايدغر نهاية الفلسفة وبداية الفكر، يحيلنا في وجهٍ من الوجوه على العصيان الأصلي الذي انتهجه شلينغ. ومع ذلك، يُصر أهل الاختصاص على تمسك شلينغ بفكرة الأنظومة، إذ يبين الفيلسوف الفرنسي كزاڤييه تيلييت (1921-2018) في كتابه “شلينغ: فلسفةٌ في صيرورةٍ” (Schelling. Une philosophie en devenir)، والفيلسوف الألماني مانفرد فرانك (1945-….) في دراسته “مدخلُ فلسفة شلينغ” (Eine Einführung in Schellings Philosophie)، أن بناء الأنظومة لم يعد يستند إلى وظيفة العقل التأصيلية الشمولية المنطوية على ذاتيتها المهيمنة، بل أضحى هذا البناء بالأحرى مساراً من الانفتاح الحر الذي لا يستطيع المفهوم التجريدي الشمولي أن يسيطر عليه.

كتاب بالألمانية (فناك)
على رغم غزارة الإنتاج وتبدل الآفاق وتنوع التناولات، اجتهد بعض أهل الاختصاص في استجلاء أربع حقَب إنضاجية مهرت فلسفة شِلينغ: الأولى (1794-1800) تأثرت بفيشته وبمثاليته الموضوعية، واكتملت في كتاب “أنظومة المثالية الترانسندنتالية” (System des transzendentalen Idealismus)؛ الثانية (ابتداءً من 1801) انطبعت بالانفصال عن فيشته في كتاب “استعراض أنظومتي الفلسفية” (Darstellung meines Systems der Philosophie)، وإنشاء فلسفة الطبيعة وفلسفة الهوية، وكلتاهما أُلصقتا إلصاقاً بفكر شِلينغ على رغم إصراره على إنكارهما لاحقاً؛ الثالثة استُهلت عام 1809 بإصدار كتاب أبحاث فلسفية في ماهية الحرية الإنسانية والمشكلات المرتبطة بها، وانفردت بطابعٍ صوفي روحي تجلى في كتاب “أزمنة العالم” (Die Weltalter) ومساعي تأريخ الفلسفة؛ الرابعة نشطت عند عودة شِلينغ إلى مُنشن عام 1827 وانصرافه إلى تدبر الفلسفة الإيجابية أو التاريخية وصوغها صوغاً يوحي ببلوغ الفيلسوف قمة نضجه الفكري.
فلسفة الطبيعة
في كتاب “فلسفة الطبيعة” (Naturphilosophie) اعتنى شلينغ في مستهل إنتاجه الفلسفي باستجلاء مقام الطبيعة وقوانينها في مسار المعرفة. تأثر بتصور نيوتن (1643-1727) الرياضي الخاضع للقوانين الفيزيائية، وقد عاين فيها انتظاماً راسخاً يضمن صحة المعرفة الإنسانية. ولكنه أيضاً شارك في معالجة الانقسام الحاد الذي أنشأه كانط (1724-1804) بين عالم الظواهر (phenomenon) وعالم الجواهر (noumenon). فإذا به يميل إلى تصورٍ دينامي يعاين في الطبيعة حقلاً من التفاعل الحر الذي يتجاوز مجرد التجاوز الشيئي الجامد بين الموجودات المتناثرة. بفضل الدينامية الحرة هذه، كان شلينغ يروم أن يتخطى الانسداد الذي تسببت به تصورات كانط حين أثبتت التعارض الحاد بين حقل الفهم الإنساني المشروط بالحتمية السببية (الفلسفة النظرية)، وحقل الحرية الأخلاقية (الفلسفة العملية) المستند إلى عفوية الذات في تحديد مصيرها.
خصوبة الروح
قبل شلينغ حاول فيشته أن يوحد العقل النظري والعقل العملي في دينامية الوعي الذاتي الذي يفرض الأنا فعلاً أصلياً حراً منعتقاً من أي تحديد سابق. ينبثق هذا الأنا من ذات جوانية تفوز بإدراكه فوزاً حدسياً يشبه الوعي الذاتي. ومن ثم، كل كائنٍ يقوم بفضل الذات التي تنشئ ذاتَها بقدرة وعيها الخاص، بحيث تصبح الطبيعةُ انعكاساً لفعل الوعي الذاتي الناشط في صميم الأنا. لذلك نُعتت مثاليةُ فيشته بالمثالية الذاتية. على رغم تأثر شلينغ بهذه المثالية، إلا أنه سعى إلى توحيد العقل النظري والعقل العملي سعياً مختلفاً عن فيشته. فأبان أن ما يوحدهما إنما هو عزمُ الروح على تمثل الكون والاضطلاع به. ذلك بأن الروح ليس كياناً غامضاً جامداً، بل خصوبةٌ حيةٌ منتجةٌ لا حدود لإشعاعها. في صميم هذه الخصوبة تنغرس طبيعة الروح البشري الذي يحتضن الصورة والمادة، المفهوم والحدس، الغاية والمعنى. ومن ثم، تنطوي طبيعتنا الإنسانية على حيويةٍ خلاقةٍ تستند إلى الحدس الإلهامي الذي يوحد فينا كل الأبعاد. لا بد حينئذ من أن تنبري المخيلة الإنسانية الخصبة لتزودنا طاقاتِ المعرفة النظرية والقدرةَ على القرار الحياتي. أما النواة الأصلية الهادية فتتجسد في الفعل الحر المنبثق من الذات التي وعت ذاتها في الطبيعة وعياً مباشراً.
الاقتدار الكوني الفاعل
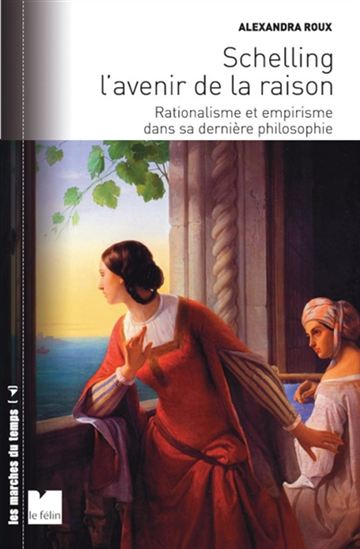
“مستقبل العقل” بالترجمة الفرنسية (فناك)
من الواضح أن فلسفة الطبيعة هذه لا تستند إلى وعي الذات الانعزالي، بل إلى الخصوبة التي افترضها شلينغ منغرسةً في الطبيعة وعهد إليها بتدبر التعارضات الناشطة بين الداخل والخارج، بين الذات والموضوع، بين الحدس والعقل، بحيث تُفضي العملية التوحيدية إلى مؤالفةٍ انفتاحيةٍ تضم الأطراف كلها. أما الحركة التي تضمن انبثاق هذه المؤالفة فيعاينها شلينغ في الاقتدار الكوني الفاعل المتجلي على ثلاثة مستويات: القوة المغناطيسية، والاقتداح الكهربائي، والتفاعل الكيميائي الذي يفترض اضطرام الاثنَين. وعليه، يمكن القول إن فلسفة الطبيعة التي استخرجها شلينغ من خصوبة الطبيعة تمنح مثاليتَه الطابعَ الموضوعي الذي يقابل مثالية فيشته الذاتية.
تاريخ الوعي الذاتي يعاين مصالحة حرية الأنا الذاتية وحتمية الطبيعية الموضوعية. حين بلغ شلينغ هذا المبلغ، طفق يسأل نفسه في كتابه “أنظومة المثالية الترانسندنتالية” عن ضرورة إبطال مبدأ الأنظومة عينه، إذ كيف يمكن الذات التي وعت نفسها وعياً كاملاً أن تعي اللحظة الأصلية التي انبثقت منها والتي ما برحت مغمورةً في ظلال البدايات المجهولة العسيرة المنال؟ إذا كان الوعي لا يستطيع أن يُدرك شرط انبثاقه الأول من ظلمة هذه البدايات، وإذا كان أصل وعينا مغموراً باللاوعي لا نستطيع أن ندركه بوعينا ولا أن نضع له الأصل الملائم، فإن كل أنظومة فلسفية إنما تسقط في محنة العجز البنيوي.
هل يمكن الفن أن يحل محل الفلسفة؟
من الواضح أن شلينغ وصل في هذه الحقبة إلى طريق مسدود، إذ أدرك أن الفلسفة لا تستطيع أن تعثر على أصل حركة الوعي. في كتابه “فلسفة الفن” (Philosophie der Kunst)، طفق منذ عام 1802 ينعطف إلى الفن، عله يعثر في فضاءاته على ما يتجاوز به حدود المعرفة الفلسفية. لماذا الفن بعينه؟ لأن الفن يرفض أن يقيد نفسَه بأقوالٍ يستحيل إنشاؤها في وصف المؤالفة بين الوعي وأصله، بين الموضوع والذات، بين العقل والحدس، بين الطبيعة المنضبطة بالقوانين والحرية المنعتقة من القيود. خلافاً لهذا المسعى، يرتاح الفن إلى الكشف، فيتحول إلى “أداة الفلسفة ووثيقتها الأبديتَين”، على ما كان يذهب إليه شلينغ. على قدر ما يصور الفن “اللامتناهي اللاواعي”، يتسنى له أن يؤالف مؤالفةً خلاقةً بين الطبيعة والحرية. لا شك في أن مثل هذا التصوير يتخطى نشاط الوعي الذهني التمثلي، فيستحيل علينا أن نحصره في مقولاتٍ عقليةٍ مجردة.
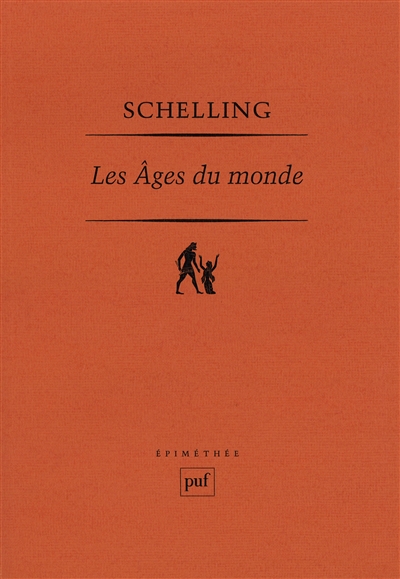
“عصور العالم” بالترجمة الفرنسية (فناك)
ولكن صعوبة الفن تكمن في أننا لا نستطيع أن نفهم إنتاجه بالاستناد إلى أحكام وقواعد سابقة ثابتة. ليس من معياريةٍ هاديةٍ تساعدنا في إدراك ماهية الفن، وقد تجلت في ما يفيض عنه كشفاً يتجاوز مجرد القول الإبلاغي. في الفن يتألق تجلي الكائنات وتنحسر تعريفات الأشياء. لذلك تشبه الأعمال الفنية حياة الأجسام الحية التي تبني جسر التواصل بين اللاوعي والوعي. المشكلة أن هذا الجسر لا يمكن وصفه وصفاً كلاميا، بل نكتفي بإظهاره إظهاراً يعاند كل الأحكام التي نصوغها في تعابيرنا التحليلية. اللافت في المقاربة الجمالية هذه أن شلينغ خالف هيغل الذي كان يَعد الفن من آثار الماضي، ولو أن الإنتاج الفني ما فتئ ناشطاً حتى اليوم. سببُ إدانة هيغل أن الفن فقد صلته بالمطلق، وأضحى في مرتبةٍ أدنى من مرتبة المعرفة الفلسفية التي تدرك ماهية المطلق. أما في نظر شلينغ فالفن والفلسفة يختلفان في كيفية التعبير عن حقيقة المطلق، إذ ينفرد الفن بمقامٍ كشفي إبداعي يصور الماهيات من غير أن يحبس عليها في المقولات.
فلسفة الهوية المحايدة
ومن ثم، اختبر شلينغ انعطافاً واضحاً إلى الهوية المنحجبة وراء الكائنات. لا بد في هذا السياق من التذكير بالتفكير الذي ساقه الأديب الألماني هُلدرلين حين نشر في عام 1795 مقالته الشهيرة في “الحُكم والكينونة” (Urteil und Sein)، وقد أظهر فيها أن الحُكم على الموجودات يُبنى أصلاً على فهمٍ عميقٍ يصيب الكينونة المنغلة في الكائنات. مثل هذه الكينونة لا تَقبض عليها أحكامُ العقل، إذ إنها تتجاوز عمل الوعي التفكري. لا بد إذاً من أصلٍ أعمقَ يتيح للإنسان أن يختبر انكشاف الكائنات، على حد ما عبر عنه هايدغر المتأثر باجتهاد هُلدرلين الفلسفي هذا.
بفضل هذا الانعطاف، أعرض شلينغ عن فلسفة الأنا التي كان ينادي بها فيشته أصلاً لحيوية الطبيعة، وراح يتحرر من كل تصور ذهني تمثلي يحصر عمل الوعي في التقريب بين الذات والموضوع. ذلك بأن مشكلة الفلسفة تكمن في تعليل انبثاق العالم المحدود من أصلٍ غائرٍ يستحيل ربطُه بأي عاملٍ من عوامل الطبيعة. كان شلينغ حريصاً أيضاً على الانعتاق من كل ضروب الثنائيات التسويغية، وفي ظنه أن الوقت قد حان لكي نربط عالمنا بهوية محايدة لا اسم لها ولا عنوان على الإطلاق، تتمرد على منطق الأخذ العقلي الذي بلغ حده المطلق في فينومينولوجيا هيغل. من الضروري، في نظر شلينغ، أن نتصور عالمنا في هيئة الائتلاف الناشط بين الكائنات المرتبطة بعضها ببعض والمستندة في ترابطها إلى أصل عديم الهوية، طليق الشروط. وحدها صورة الوثبة النوعية المغامرة الواقعة خارج حدود المألوف المنطقي تستطيع أن تنقذنا من التعثر والجهل. لكي نفهم طبيعة هذه الوثبة، لا يفيدنا أن نعتصم بالجدلية الهيغلية النافية التي تدعي، بحسب شلينغ، بلوغ المعرفة المطلقة بواسطة الإلغاء الذاتي الذي ترتضي به الكائنات المحدودة الناشطة في أرجاء عالمنا التاريخي.
من أفضل تجليات فلسفة الهوية المحايدة المستحيلة التعريف العبارةُ الوجيزةُ التي نطق بها شلينغ في المحاضرة التي ألقاها العامَ 1804، وعنوانها “أنظومة الفلسفة على وجه العموم وفلسفة الطبيعة على وجه الخصوص”. ذلك بأنه أراد أن يضع الفرضية الأساسية في كل معرفة. فإذا به يعلن أن “العارف والمعروف واحدٌ”، فيُبطل نظرية المعرفة القائمة على التلاؤم المفترض بين الذات والموضوع، وقد بلغا حداً أعلى من المؤالفة في فعل المعرفة هذا. ما دامت الفلسفة تتشبث بالثنائية الناشطة هذه بين الذات والموضوع، فإنها لن تبلغ المعرفة الحق. لذلك يجب تجاوز الثنائية وافتراض التماهي الأصلي متجاوزاً ذاتيةَ الإنسان. بفضل مبدأ الهوية الأصلية المحايدة، يمكننا أن نتخطى مثالية فيشته الذاتية وفلسفة كانط التفكرية النقدية، وأن نتصور الهوية المطلقة تماهياً أصلياً بين الذات والموضوع، بين المثال والواقع.
مخاصمة هيغل
في أثناء الدراسة اللاهوتية كان هيغل وشلينغ يتقاسمان غرفة السكن عينها، وكانا يجتهدان معاً في سبيل تجاوز النقدية الكانطية. ولكن ما إنْ قرأ هيغل محاضرة شلينغ واطلع على نظريته في الهوية المحايدة أو “الهوية العديمة الهوية” حتى سارع إلى انتقادها في كتابه “فينومينولوجيا الروح” الصادر عام 1807. أتت عبارة النقد قاسيةً، إذ صرح هيغل بأن مثل هذه الهوية الغارقة في ضباب الحياد المعرفي تشبه “الليل الذي فيه تكون جميع الأبقار سوداً”. لم يحتمل شلينغ الإهانة الفلسفية، فبعث برسالةٍ إلى صديقه هيغل يسأله فيها أن يوضح في مقدمة الطبعة الثانية القصدَ الذي تنطوي عليه العبارة حتى لا يظن الناس أنه يوجه نقدَه إليه. غير أن هيغل لم يفعل ما اقترحه عليه شلينغ في مقدمة الطبعة الجديدة، فانقطعت العلاقة بين الرجلَين، وانفصلا انفصالاً غاضباً أفضى بكل واحدٍ منهما إلى انتهاج سبيله الفلسفي الخاص. أما هيغل فبالغ في تطوير ميتافيزياء الذات، وأما شلينغ فأعرض عن المثالية وآثر تجاوز كل ضروب الميتافيزياء التأصيلية.
الفلسفة الإيجابية مقابل الفلسفة السلبية: فلسفة الوحي
بعد موت هيغل، اضطلع شِلينغ بكرسي أستاذية الفلسفة في جامعة برلين، وكان قد بلغ من النضج الفكري أعلى المراتب، فأكب يعيد النظر في أنظومته الفلسفية برمتها، مستخدماً عبارة الفلسفة الإيجابية (Positivphilosophie) من أجل تأصيل فلسفة الميثولوجيا (Philosophie der Mythologie) وفلسفة الوحي (Philosophie der Offenbarung). تقوم الفلسفة الإيجابية على التمييز بين بُعدَين في الكينونة: ماهيتها، وإقبالها على الوجود. كان شلينغ يُصر على القول إن الفلسفة التي تعتني بالنظر في ماهية الكينونة إنما هي فلسفةٌ سلبيةٌ، في حين أن الفلسفة التي ترعى إقبال الكينونة على الوجود وانخراطها المتدرج في الحياة تستحق لقب الفلسفة الإيجابية. ذلك بأن الكينونة المنجَزة الجامدة في ماهيتها لا تستنهض الفكر على نحو ما تستثيره الكينونة المتحركة المتطورة التائقة إلى الإنجاز في معترك الحياة. إذا كانت مقولات المنطق في الفلسفة السلبية تستطيع أن تقبض على الماهية الثابتة، فإنها لا تقوى على الإمساك بحركة الحياة المتجلية في إقبال الكينونة على الوجود.
ومن ثم، تستخدم الفلسفة السلبية المفاهيم التي تتكل عليها في وصف الماهيات المتحققة والجواهر الراسخة والمضامين المغلقة، في حين تركن الفلسفة الإيجابية إلى الإشارات الإيحائية والرموز الدلالية التي تومئ من غير أن تهيمن، وتستطلع من غير أن تُغلق، وتتحسس من غير أن تستخلص. لذلك انتقد شِلينغ هيغل وعاب عليه ادعاءه القدرة على حبس الوجود في قفص المفهوم النظري المجرد. وحده الحدس اللماع هذا كان كافياً ليستثير في ذهن الفيلسوف الوجودي الحديث الأول كيركغارد أجرأ التناولات الوجدانية اللماعة. ليس في مستطاع المفهوم أن يحوي الحياة، وليس في إمكان الأنظومة أن تستخرج المعرفة المطلقة من جدلية الإلغاء الذاتي الذي يصيب الكائنات التاريخية النسبية. لا بد، والحال هذه، من الاستعانة بالفلسفة الإيجابية التي تعترف بوجود هذه الكائنات وانسلاكها التدرجي في حركة الحياة، قبل استباق تحققها الأمثل في المعرفة المطلقة.
الكينونة حريةُ التاريخ
تجدر الإشارة هنا إلى أن شِلينغ يسمي فلسفتَه الإيجابية “تجريبيةً ميتافيزيائيةً”، إذ إنها تفترض من غير دليل أن الوجود الواقعي قائمٌ وناشطٌ في حركة الحياة، لا يخضع للمعرفة العقلية النظرية المجردة، بل ينتسب بالأحرى إلى حقل الحرية المتجلية في صميم المكابدة التاريخية. الكينونة، في جوهرها، حريةٌ واقعيةٌ تُنجز ذاتها إنجازاً منعتقاً من سطوة التصورات الذهنية القبْلية. إذا كانت الكينونة تجسد الحرية، فلأنها مسارٌ مشرعٌ من التحقق التاريخي المنفتح على جميع الاحتمالات، لا خلاصة الاستدلال المنطقي الذي يُجيزه لنا المفهوم في بنائه النظري المحض. ومن ثم، يتضح أن المثالية أنظومةٌ مغلقةٌ تُفضي إلى الإخفاق. عوضاً عن الالتجاء إلى الذاتية المطلقة الصلاحية، يحثنا شِلينغ على الاستناد إلى راهنية الوجود المبني على واقعية الإقبال على الحياة. ذلك بأن مثل هذه الراهنية تتقدم على الوعي الذاتي وعلى رغبة العقل في ضبط الوجود في هيئة المفهوم الجامع المانع. وعليه، ينبغي لنا أن نعترف بامتناع الكينونة عن الإمساك في أصل نشأتها. جل ما نستطيع الاجتهاد فيه أن نعاين فيض الكينونة الغزير يستدعينا ويحثنا على رعايته وصونه، إذ إنه يعرضنا لعظمة اللامتناهي المتجلي في صميم حياتنا من غير تسويغ أو تأصيل، فيكشف لنا محدوديتنا التاريخية ومائتيتنا الكيانية.
اقرأ المزيد
- الفيلسوف باسكال وجد في العقل عظمة الإنسان وشقاءه
- من هو الفيلسوف وهل يحتاج العالم إليه وكيف؟
- غوته الفيلسوف رسم الحياة في مشهد التنوع اللامتناهي
قبل حلول الطور الأخير من فلسفته، حاول أن يتفكر في المطلق الإلهي بواسطة مقولة الهوية العديمة الهوية. فأبان في كتاب أزمنة العالم أن المطلق، لكي يصبح الله، ينبغي أن يميز في كيانه الذاتَ الخاصةَ به من العالم الموضوع خارج هذه الذات والحاوي أصلَ الخليقة. وحده الإنسان، تاج الخليقة، كان بإمكانه أن يرمم الوحدة الأصلية بين الذات الإلهية والعالم الخارجي. غير أن الخطيئة التي عطبته أجلت استحقاق هذا الترميم إلى زمنٍ مستقبلي غير محدد.
في الطور الأخير، أخذ شِلينغ يُسند إلى الفلسفة مهمة النظر في الوجود الواجب الذي يخرج من ذاته بواسطة الوعي ويتجلى في هيئات ثلاث: أولاً، في هيئة الاقتدار النوراني أو النور الكوني الأصلي؛ وثانياً، في صورة الاقتدار الميثولوجي أو ديونيسيوس؛ وثالثاً في قوام الشخص الإلهي أو المسيح.
الفلسفة الملهِمة
يعلم الجميع أن التيارات الفلسفية الغالبة في القرن العشرين سعت إلى تجاوز الميتافيزياء والانعتاق من العقلانية الحسابة والإعراض عن تأصيل قدرة الذات الإنسانية على الإمساك بالكائنات والموجودات والأشياء. فأعلن غيرُ فيلسوفٍ من فلاسفة ما بعد الحداثة موتَ الفلسفة وانكفاء زمن ميتافيزياء الذات المثالية التأصيلية. في هذه الأثناء، جرى استثمار الحدس النقدي العظيم الذي كان قد دفع بشِلينغ إلى المناداة بفلسفةٍ تتجاوز حدودَ الميتافيزياء المثالية. وعليه، انبرى هايدغر (1889-1976) يفسر نصوص شِلينغ الأخيرة تفسيراً يجعلها تنبئ بانعطافٍ خطيرٍ في مسار الفلسفة، إذ تمهد السبيل إلى الخروج من الميتافيزياء والدخول في عصر استثمار طاقات العقل استثماراً مختلفاً لا تنحصر وظيفتُه في تسويغ هيمنته على العالم. من اللافت، في هذا السياق، أن الفيلسوف الألماني هابرماس (1929-….) كان قد أعد أطروحة الدكتوراه في فلسفة شِلينغ، فاستفاد من حدسه اللماع لكي ينتقد وظيفة العقل الحديث الأداتية الاستغلالية، ويدعو إلى استكمال تحقيق الحداثة تحقيقاً يضع الذات في مقامها السليم ويحمي الوجود من هيمنة العقل الآلي الكاسحة.