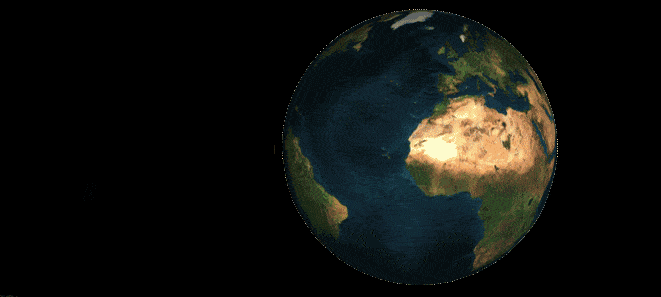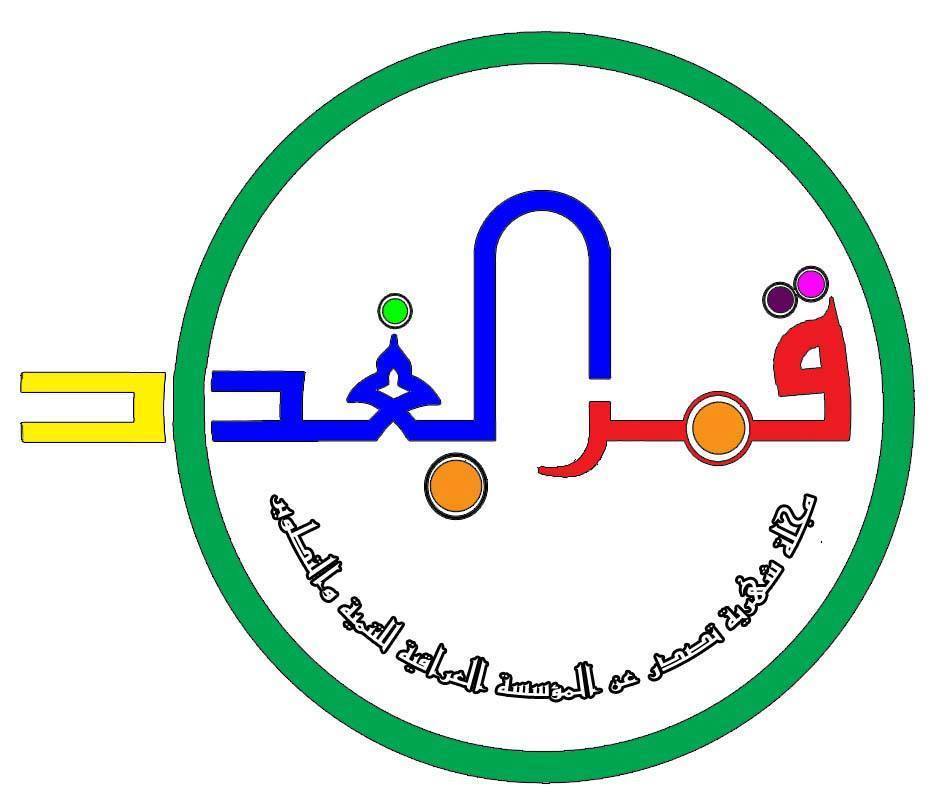أثارالفيديو الذي نشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لنائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي استهجان كل من شاهده. سياسي عراقي من الصف الأول من نخبة الطبقة السياسية المتربعة على مناصب السياسية منذ 15 عاما وهو يحاجج مواطنا مسكينا مغلوبا على أمره، ويختتم كلامه بإطلاق تهديد بوجه المواطنين بقوله لهم «والله إلا ندمركم»، ثم يترك المتجمهرين في منطقة الاعظميةوسط بغداد ممن حضروا الحادثة وينصرف مع عناصر حمايته.
هذا السلوك المثير للاستهجان أثار العديد من التساؤلات أيضا، ومنها أما آن لهذا الرجل أن يتقاعد؟ لقد بلغ منتصف السبعينيات من عمره، قضى منها قرابة 30 عاما متربعا بديكتاتورية مفرطة على قمة حركته السياسية (حركة الوفاق الوطني) بدون أن يسمع أحد بإجراء انتخابات ديمقراطية داخلية في هذه الحركة «الليبرالية»، الرجل تبدو عليه آثار التعب والشيخوخة حتى أصبحت لازمة (والله ما أدري) التي يتندر بها العراقيون، والتي يطلقها في مقابلاته الصحافية والتلفزيونية، ماركة مسجلة باسمه في المشهد السياسي العراقي. فلماذا لا يتقاعد ويعيش ما تبقى من عمره ليركز جهوده في مؤسسة أبحاث أو معهد دراسات؟ أو حتى يقضي ما تبقى من سنوات شيخوخته في مغتربه، حيث تعيش عائلته المتنعمة في لندن؟
وللأمانة ما قلناه ليس حالة خاصة بإياد علاوي، إنما هو مثال يضرب ونقصد به كل المشهد السياسي العراقي، حيث أصبح الأمر حالة عامة باتت تمثل سمة من سمات العملية السياسية العراقية التي مضى عليها 15 عاما منذ 2003 حتى الآن، والوجوه لم تتغير ولم ينسحب من العملية السياسية في ظروف عادية إلا قلة يمكن أن تعد على أصابع اليد، أما الحالة العامة فهي الاستمرار بالعمل السياسي وعادة في المكان نفسه الذي تم شغله حتى الممات.
وقد أشار بعض الباحثين إلى أن هذه الآفة قد ورثتها المعارضة السابقة من سمات نظام صدام الذي عارضته، والذي كان يسير هو الآخر وفق منهج لا يفترق فيه عن الكثير، إن لم نقل كل الانظمة العربية، في ما يتعلق بهذه الزاوية، وهو ما يمكن أن نسميه «حياة السياسي ونشاطه في الشأن العام من المهد إلى اللحد»، لكن يجب أن نشير إلى أن توقعات الشارع العراقي كانت متفائلة وأحبطت، كون من قدموا مع التغيير وعدوا العراقيين بعملية سياسية وفق النهج الليبرالي، الذي مثلت الولايات المتحدة الامريكية الضامن الدولي لتنفيذه، كما مثلت طروحات الحلفاء الغربيين الذين دعموا هذه المعارضة واسقطوا النظام السابق، معيارا لما كان يجب أن يحدث بعد التغيير. لكن يبدو أن امراض النظام السابق السياسية كانت معدية بشكل لافت، حتى أنها اصابت كل من جاء لاحقا، بالأمراض نفسها وربما أسوأ.
بالمقابل يمكننا أن نلقي نظرة على ما يحدث حولنا في العالم الذي أصبح قرية صغيرة ونتعرف على حجم مأساتنا. ولنلقي نظرة سريعة على المشهد السياسي الأمريكي تحديدا، لأن الأمريكان هم من كانوا الضامن للعملية السياسية بعد إطاحة نظام صدام. فبعض الساسة السابقين يجد مكانه في مراكز الدراسات والبحوث أو المراكز الأكاديمية والجامعات، ليقدم من خلالها خلاصة خبراته سواء لمجتمعه المحلي أو في المجتمع الدولي، كما هو حال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر، الذي يدير مؤسسة للدراسات السياسية والاستراتيجية والتي تشرف على عمليات الانتخاب ونشر قيم الديمقراطية ودعم الانشطة غير الحكومية في هذا الصدد في مختلف دول العالم، كذلك هو حال وزير الخارجية الامريكي العتيد هنري كيسنجر الذي يعمل خبيرا ومحللا استراتيجيا في اكثر من جامعة ومركز للدراسات والبحوث. اما بعض الساسة الذين قدموا أصلا من مؤسسات إدارية أو صناعية عملاقة، وبالتالي من الطبيعي أن يعودوا إلى هذه المؤسسات بعد خروجهم من العمل السياسي الرسمي، كما هو الحال مع الرئيسين جورج بوش الاب والابن، فهما من عائلة عرفت بانها تمتلك شركات مهمة تعمل في قطاع البترول في ولاية تكساس الامريكية، لذلك عادا إلى العمل في هذا القطاع بعد انتهاء مدة عملهم في الخدمة العامة، كذلك هو حال نائب الرئيس الامريكي الاسبق ديك تشيني، الذي عمل مديرا تنفيذيا لشركة هاليبرتون النفطية العملاقة، من جانب آخر هناك بعض الساسة ممن ينذر ما تبقى من عمره من أجل العمل الإنساني، ولدينا من الأمثلة على ذلك العديد، فمثلا الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون الذي تم اختياره من قبل الامم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، وقد قام بعدد من المهمات في هذا المضمار، ربما كان اوضحها دوره في أزمة هاييتي، ابان الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة عام 2010، وقد قدر الصليب الأحمر الدولي أعداد المتأثرين بالزلزال حينها بثلاثة ملايين شخص بين قتيل وجريح ومفقود، وكان لجهود الرئيس الاسبق كلينتون دور مهم في جمع الدعم الدولي لهذا البلد المنكوب، حتى أنه أصيب بنوبة قلبية كادت تودي بحياته نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها في مؤتمر المانحين. وقد يعترض البعض ويقول إن هذه النماذج من دولة عظمى تحظى بقيم عمل ديمقراطية راسخة، ونجيب أن هذه النماذج أصبحت معروفة في قارة آسيا وامريكا اللاتينية وإفريقيا، ويمكننا هنا أن نذكّر بعجالة برئيس جنوب افريقيا الاسبق نيلسون مانديلا الذي قضى (27) عاما في زنزانة انفرادية، معتقلا في سجون نظام الفصل العنصري في بلده حتى أصبح أيقونة ورمزا للقائد الوطني في العالم، ثم تسنم بعد الإفراج عنه سدة الرئاسة في اول انتخابات ديمقراطية يشهدها بلده، وقد اصر على عدم الترشح لدورة ثانية رغم المطالبات الشعبية الواسعة بذلك، وقرر أن يستثمر السنوات المتبقية من عمره الذي قارب التسعين حينها في مشروع انساني كبير هو محاربة مرض الايدز، الذي يفتك بشعوب إفريقيا المنكوبة بالفقر والعوز والتخلف، وبات يجوب العالم رغم سنه المتقدم لجمع الدعم الدولي من المؤسسات الخيرية ومن الدول المانحة للوقوف بوجه هذه الكارثة الانسانية. حال المشهد في مجتمعاتنا العربية مختلف جدا، ربما لأننا مانزال نحبو على طريق الديمقراطية الليبرالية، فما زالت نخبنا السياسية تعمل وفق منظور النظريات العتيقة كنظرية الحق الالهي، أو نظرية الشرعية الثورية، وهذه النظريات تكاد تكون قد انقرضت في العالم كله إلا عندنا، فمن يتسنم منصبا رسميا في بلداننا المبتلاة بنخبها السياسية يعتقد انه قد امتلك هذا المنصب إلى الأبد، ويتصرف من خلاله وكأنه اقطاعية خاصة، يتصرف بها وفق ما يحلو له بدون تفريق بين المال العام والمال الخاص، لذلك تجد رؤساء يجلسون على كراسي الحكم لعقود من السنين، ويسعون لتوريث المنصب لابنائهم تحت شعار ( دكان ابوه وهو اعلم به). عندما دقت الديمقراطية ابوابنا، افقنا على ضجيج العالم من حولنا وقد سار وتركنا نتخبط في عقلية القرون الوسطى، لكن إبداعات نخبنا السياسية تفتقت عن انواع الحيل والالتفافات على الديمقراطية لتكون المحصلة النهائية غلالة ثوب ديمقراطي مهلهل يغلف المشهد السياسي المتعفن الراقد تحته.
وعلى العموم فإن السياسي لدينا يصور لمجتمعه انه سياسي بالولادة، وان الوعي السياسي لديه مكتوب في جيناته، وقد رضع المبادئ مع لبن امه وان دوره لن ينتهي فهو ممتد من المهد إلى اللحد، فكيف يمكن لمثل هذه الشخصيات أن تتحول إلى شخصيات خدمة عامة في اكاديميات أو مراكز دراسات أو مؤسسات انسانية؟
نحن نعيش في مجتمعات لم تصل الحداثة بعد، نعيش في بنى اجتماعية تقليدية تتحكم فيها القوى التقليدية كالزعامات القبلية والدينية وما شاكلها من تكوينات فارقها العالم منذ قرون، ونريد أن نقفز على كل ذلك لنصل إلى مؤسسات وتكوينات ما بعد الحداثة التي يسير العالم في ركابها، وضمن معطياتها الفكرية والاجتماعية والسياسية، إنه فعلا أمر صعب جدا، ولكنه ليس مستحيلا، ولنا في النماذج الاسيوية والإفريقية واللاتينية امثلة باهرة يمكن أن نسير على خطاها ونستفيد من تجاربها، والمسوؤلية الكبرى في ذلك تقع بالتأكيد على عاتق نخبنا الكسولة.