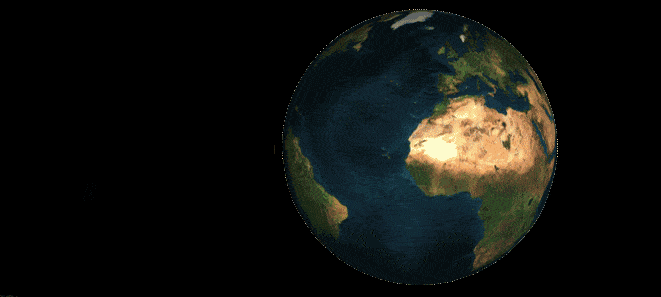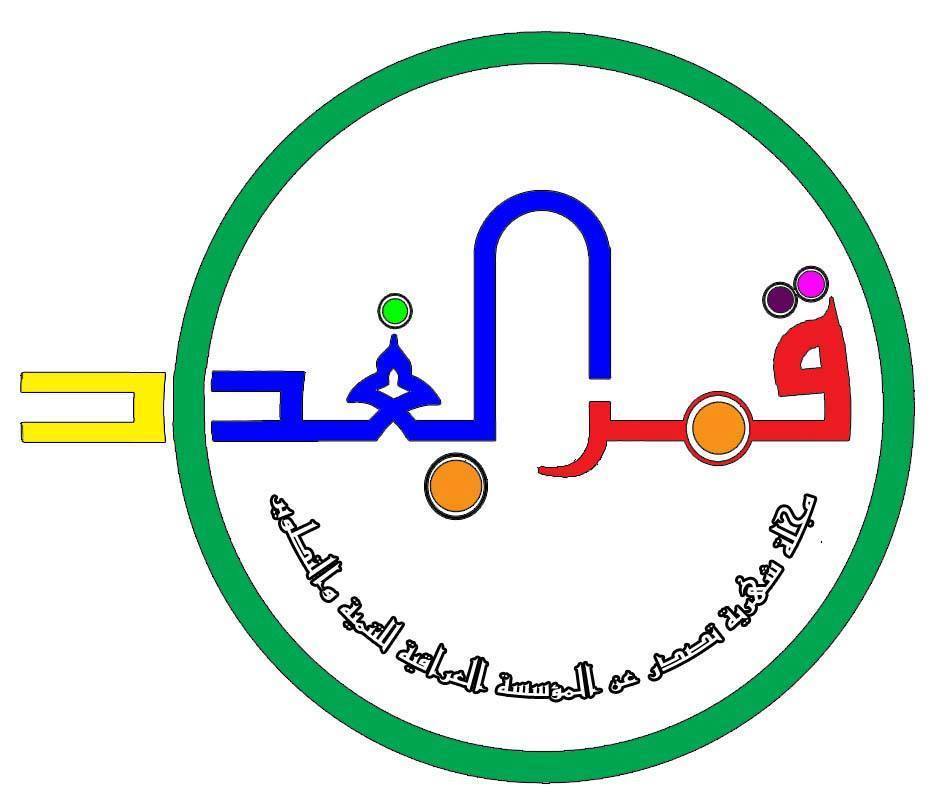الموقف القطعي للحكومة الإسرائيلية بشأن مدينة القدس، منذ أن أقرّ الكنيست عام ١٩٨٠ قرار ضمّ الجزء الشرقي منها المحتل منذ العام ١٩٦٧، هو أن المدينة الموحدة هي عاصمة إسرائيل الأبدية وغير القابلة للتقسيم. هو طبعاً موقف مرفوض ومثير للاستهجان في عموم العالم العربي. فللقدس مكانة جوهرية في صلب الآمال الفلسطينية بتحقيق حلم الدولة. ولها أيضاً مقام خاص في البحث العروبي المعاصر عن الوحدة والرسالة. وعبارة «القدس لنا» التي تصدح بها أغنية السيدة فيروز، إذ شذّبت وجدان جيل كامل، ليست معنية بالفتوحات والانتصارات، بقدر ما هي صرخة توق لعدالة موعودة وغائبة في عالم خذل الإنسان الفلسطيني على مدى عقدين من الزمن ابتداءاً بنكبته عام ١٩٤٨، ثم بدا غير عابئ أمام تكرار المأساة مع النتيجة الكارثية لحرب حزيران ١٩٦٧. وبعد نصف قرن من الزمن استحال الألم نقمة، والغضب سخطاً، وارتفعت القطعية الرافضة فيما القومية انحسرت. أما القدس فبقيت «لنا» رغم أن تعريف ضمير المتكلم هنا قد اختلف، وبقيت تلهب المشاعر وتشعل العواطف. بل إن المجتمعات العربية، إذ تبدو قابلة أن تتجاوز ما يودي بحياة مئات الآلاف في أوساطها، كما في المأساة المستمرة في سوريا، فإنه يمكن التعويل عليها للتعبير المدوي عن رفضها لأية خطوة من شأنها تبديل الوضع الملتبس للمدينة المقدسة. فللرموز حظوة في الثقافة العربية (كما في غيرها بالتأكيد) ترفع مقامها وتغلبها على الإنسان في ألمه ومعاناته وحياته. وعليه، فإن القدس كرمز متنازع عليه، تمسي عقبة أخرى في طريق إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وقد يشكل الانتقال العتيد لسفارة الولايات المتحدة إلى القدس فرصة لمقاربات تعيد النظر ببعض المسلمات التي تنضوي على الضرر.
فمن حيث المبدأ والأساس، نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس هو قرار سيادي ينحصر بطرفين هما الولايات المتحدة وإسرائيل. بل إن وجهة النظر المجردة قد تستغرب أن القوة العظمى الأولى في العالم، أي الولايات المتحدة، قد تغاضت إلى اليوم عن التجاوب مع الإرادة الوطنية لحليفتها إسرائيل بتحديد موقع سفارتها. طبعاً القدس موضع خلاف يتجاوز إسرائيل ويشمل كامل محيطها، غير أنه ثمة منطقة كبيرة منها، أي القدس الغربية، لا نزاع واقعي بشأن تبعيتها لإسرائيل. واستدعاء مقولة السلطة الدولية على كامل المدينة، وفق خطة التقسيم التي رسمتها الأمم المتحدة في قرارها عام ١٩٤٧، والتي نصّت على إقامة دولتين يهودية وعربية في فلسطين، هو استدعاء سجالي يفتقد الصدقية، فبعد أن قوبلت خطة التقسيم هذه بالرفض والإدانة على مدى العقود، هل يصحّ فعلاً التأسيس على بعض ما نصّت عليه انتقائياً؟ لا شك أن نقل السفارة سوف يؤدي إلى ردود فعل غاضبة في العالم العربي، غير أن المسؤولية الأولى لتأطير ردود الفعل هذه وصولاً إلى تجاوزها تقع على الثقافة العربية.
ثمة أوساط عربية قد تقدمت في عدائها وتشددها إزاء إسرائيل والغرب إلى حد تنتفي معه جدوى التواصل. فقابلية بعض الأفراد ضمن هذه الأوساط للتجاوب مع مساعي التعبئة التي يقدم عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» أو غيره من المنظمات القطعية لن تزداد نتيجة النقل المرتقب للسفارة ولن تنخفض مقابل أي تنازل قد تقدم عليه إسرائيل أو الولايات المتحدة. ولكن في المقابل، فإن التواصل مجدي مع الجمع الأوسع في المجتمعات العربية، وهو المعني بمسألة القدس من جانب ذاتي معنوي عاطفي كما من جانب تجسيدها للعدالة الدولية غير المتحققة. وهذا الجمهور الواسع قد يستفيد من الإصغاء إلى طرفين في موضوع نقل السفارة. الطرف الأول هو الولايات المتحدة، والثاني هو شريحة المثقفين في أكنافه.
فالتوجيه الأسلم لحكومة الرئيس ترامپ هو دعوتها إلى وضع نقل السفارة في موضعها الواقعي الحقيقي، أي بأن الفعل هو تصحيح بعد أمد طويل لجانب غير منتظم من العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن لدرء المخاوف والشبهات التي قد يشهرها المتسلقون على الحدث، والضاربة فعلاً في أعماق التاريخ، فإن الأجدى لواشنطن أن تصدر بياناً مستقلاً حول تقدير الحكومة الجديدة للآمال الفلسطينية، وعن تصميمها الذي عبّر عنه دونالد ترامپ خلال حملته الانتخابية لإعادة تفعيل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين سعياً لتحقيق الحل المنصف.
غير أن مسؤولية الفعل الإقدامي الإيجابي في هذا الظرف تقع على الثقافة العربية، لمنع التصوير الانتهازي للحدث على أنه إهانة وإساءة للعالمين العربي والإسلامي، ولاستنهاض مراجعات جديدة لبعض الأفكار الراسخة المعرقلة والتي قلّ أن تخضع للمساءلة.
بكل تأكيد، سواء من وجهة نظر تاريخية أو حضارية أو حتى وجودية، «القدس لنا». ولكنها كذلك لهم. وهنا يكمن السؤال الجوهري الممتنع إلى اليوم عن المواجهة في الثقافة العربية (نعم، السؤال المقابل ممتنع كذلك في الثقافة الإسرائيلية، فالحاجة إلى المساءلة الذاتية تصحّ هناك كما تصحّ هنا). «القدس يهودية». هي عبارة تثير الامتعاض على أقل تقدير، وغالباً ما يزيد عنه، عند ذكرها في أي مقام عربي. ولكنها ليست فقط إقراراً بواقع، بل هي كذلك مرآة لتاريخ ووجدان وحقيقة عميقة. فلقرون طويلة كان الشوق والتوق للقدس، المدينة المقدسة الممنوعة، في صلب الهوية الذاتية اليهودية. غير أن هذا الرابط العاطفي والشعائري والروحي يغيب عن الذكر تماماً في السرديات العربية. كما تغيب عن الخطاب العربي المعطيات التاريخية الملموسة، والتي تبين مثلاً أنه في الزمن العثماني، قبل الانتداب البريطاني والاستعمار الأوروپي والإمپريالية الأميركية، كان اليهود أكبر طائفة في مدينة القدس في معظم الأحيان، بل كانوا الأكثرية المطلقة فيها في مراحل عدة. فالسؤال الجدي الذي لا بد للثقافة العربية من التطرق إليه، إذ تصيغ ردّها على نقل السفارة، هو ما إذا كانت معارضة النقل ناتجة عن اعتبارات سياسية أو عائدة إلى رفض قاطع للقبول بيهودية القدس.
والكلام عن يهودية القدس لا ينفي مكانتها عربياً وفلسطينياً. تبقى القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، مسرى الرسول للمسلمين والشاهد على القيامة للمسيحيين، فهي الأساس لهذه الهوية العربية، الجريحة دون أن تفارق الحياة، والتي تريد للعروبة أن تحتضن مسلميها ومسيحييها. نعم، القدس عربية، ولا ينقص ذلك من يهوديتها. بل للمدينة المقدسة أن تشهر ما يزيد عن هذا وذاك، فهي أرمنية وقبطية وحبشية ويونانية ولاتينية. إنها مهمة جيل لاحق أن يفرز هوياتها المتعددة ويجمعها.
قد يسجّل التاريخ لمدينة القدس في غد قريب أنها أصبحت العاصمة الأولى لدولتين. وهي اليوم عاصمة لدولة إسرائيل. وللاعتراض بجدية وحسن نية على هذا الواقع، لا بد من تفكيك مسمّى القدس، وذلك بالإشارة إلى الاختلاف بين الشطرين الشرقي والغربي. فتابعية القدس الغربية للسيادة الإسرائيلية أمر لا جدال بشأنه مع أي سعي منصف لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فالتزام الولايات المتحدة بهذا القيد في اختيارها لموقع سفارتها في القدس، أي بنقلها إلى الشطر الغربي من المدينة، يدعو إلى اعتبار الخطوة كما هي، عمل اعتيادي في العلاقات بين الدول.