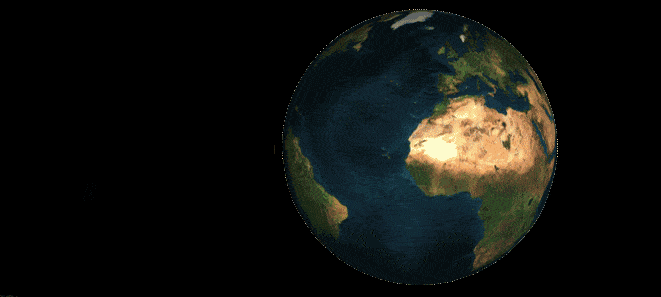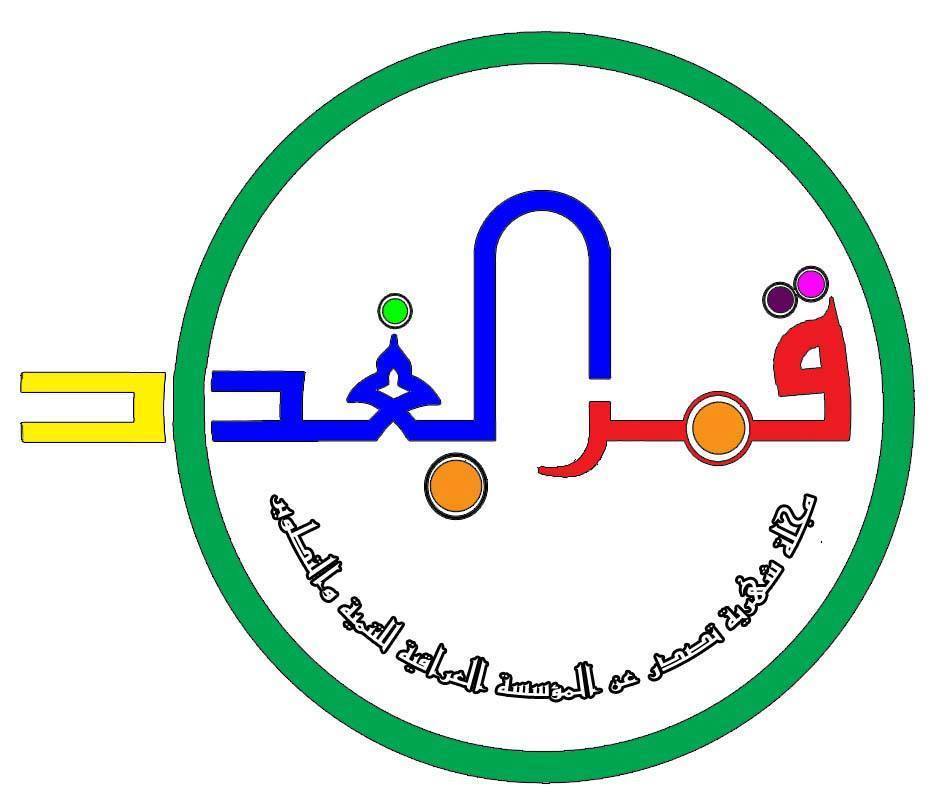جميل مطر
لست متأكداً تماماً من أن العنوان الذي اخترته لهذا المقال يصف بالدقة اللازمة حال العلاقة الراهنة القائمة بين الولايات المتحدة وروسيا. وبالمقدار ذاته أعترف بأنني غير متأكد من أن أي وصف آخر يمكن أن يعكس حقيقة حال هذه العلاقة برضا غالبية الباحثين في العلاقات الدولية. مرت العلاقات بين الدولتين خلال القرن الماضي بفترات شديدة التوتر مورست خلالها أشكال متنوعة من العنف المباشر وغير المباشر. نشبت بينهما حرب باردة انتهت بروسيا في وضع الدولة العظمى المنهزمة أسوأ هزيمة، أقصد الهزيمة غير العسكرية.
سقط النظام الشيوعي، ومع سقوطه انهارت هيبة النخبة الحاكمة، وتعرضت الدولة العظمى إلى عمليات تفتيت أدارتها ولعبت فيها دوراً مشهوداً الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الدولة المنتصرة. تشجعت فاستقلت دول من شرق أوروبا ووسطها وبلاد في القوقاز وشمال وسط آسيا كانت خاضعة لروسيا أو تحميها عباءة الإمبراطورية السوفياتية. ويعتقد بعض من عاشوا هذه الفترة في روسيا أن الدول الغربية بخاصة الولايات المتحدة تعمدت، أو حرص بعض مبعوثيها على غرس الشعور بمهانة الهزيمة في نفوس الشعب وقادة المجتمع. وبعد فترة مؤلمة وكثير من الفوضى، انتفضت في ما يبدو مؤسسات أمنية متحالفة مع الكنيسة الأرثوذكسية لانتشال روسيا من مستنقع الهزيمة واستعادة هيبتها، ليس فقط في الداخل لكن أيضاً في الخارج، الخارج القريب أولاً ثم الخارج الأبعد.
أعتقد، وأنا المراقب من بعد، أن القائمين على تنفيذ الانتفاضة حملوا كثيراً من الرغبة في الانتقام. هؤلاء رأوا بعيونهم كيف تمّت محاولات تمزيق الكيان الروسي. حكوا عن جهود أوروبية وأميركية كانت تهدف إلى تمزيق الكيان الروسي بنشر الدعايات الانفصالية وإثارة الفتن بين الأقليات. بالفعل، شهدت البلاد في الفترات الأولى موجة عارمة من الأعمال الإرهابية، سواء في أقاليم القوقاز أو داخل موسكو ومدن أخرى. شاهدنا من حيث كنا صور مجزرة المدرسة وصور التفجيرات المريعة في محطات القطارات والأسواق. تابعنا كذلك الجهود المكثفة التي قام بها المسؤولون في حلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية للضغط على دول الجوار الروسي للتخلي عن علاقاتها بروسيا والانضمام إلى منظومة دفاع غربية ومنطقة تكامل أوروبية. كنا قبلها شهوداً على عمليات تهريب الثروة الروسية إلى مواقع مالية آمنة خارج روسيا. قام مغامرون عديدون ببيع أصول القطاع العام الروسي وتهريب الحصيلة لإيداعها في مصارف خارج روسيا. كانت الأموال والثروات الوطنية تتسرب أمام أفراد وأجهزة ترى دولة عظمى تنفرط وتتمزق وتُباع رخيصة. هكذا تسرّب الشعور بالرغبة في الانتقام إلى السلوك السياسي للقيادات الوطنية التي تسربت إلى مواقع مهمة في السلطة، وكان هدفها استعادة مكانة روسيا وتعويضها عما فقدت وما سرق منها.
عادت روسيا إلى الشرق الأوسط. عادت إليه عندما وجدت الفرصة متاحة لتستعيد بعض مكانتها وهيبتها ولتصنع لنفسها دوراً قيادياً يحقق لها نفوذاً ومصالح مادية ومزايا استراتيجية. أما الفرصة فكانت مركبة. كانت الظواهر تكاد تؤكد أن المنطقة مؤهلة لحالة ثورية. كانت أميركا، العدو لروسيا المقيم دائماً، خارجة لتوّها من حربين في أفغانستان والعراق أهلكتا جانباً مهماً من أرصدتها وإمكاناتها، وأضعفتا صورتها في المنطقة. كانت أميركا، لتوّها أيضاً، تسلم مقاليدها لحاكم جديد وشاب وأسمر وعازم على سحب أميركا إلى داخل حدودها بالتدرج المناسب انسجاماً مع حقيقة كانت تتأكد يوماً بعد يوم وهي أن انتشار وتطبيقات القوة الأميركية في الخارج لم تعد تتناسب مع حال انحدارها. كانت أميركا، خارجة في لحظتها من أزمة مالية كادت تخنقها، وبالفعل كبلت قواها لسنوات ومنعتها من الاستعداد بضمانات اقتصادية كافية لحماية مصالحها وأطماعها.
كانت أميركا على وشك أن تقرر تركيز الجانب الأهم من اهتمامها واستراتيجيتها في المستقبل على شرق آسيا والعلاقات الباسيفيكية الآسيوية. كان في البيت الأبيض في واشنطن رئيس يزمع أن يطلب إلى القادة الروس إغفال الماضي قليلاً وتدشين علاقات جديدة محل العلاقات القائمة التي ورثت التوتر والعداء وروح الانتقام. ويبدو أنه تسرب إلى قادة موسكو أن الإدارة الديموقراطية الجديدة في واشنطن قد تحب أن ترى موسكو شريكة في تسيير بعض أمور الشرق الأوسط. في الوقت ذاته، لم تغب عن أذهان السياسيين الروس المعلومات عن أن الشرق الأوسط مقبل على تحولات في هياكله وبنيته الأساسية تحت ضغط سنوات الترهل والجمود وضغط تياراته الدينية، بخاصة الأصولية منها. وعندما وقعت محاولات التحوّل في شكل ثورات حقيقية كان واضحاً تماماً لنا، أهل الشرق الأوسط، أن سوء تعامل القادة العرب مع ثورات الربيع كفيل بأن يضيّع عليهم فرصة ذهبية للمساهمة في تحقيق التحول الحضاري الضروري بأقل تكلفة ممكنة، فضلاً عن أنه عجل بإدخال إيران وتركيا طرفين فاعلين في المنطقة، وبالتالي شجّع روسيا على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة تتعلق بدور روسيا في الشرق الأوسط.
لم تسمح موسكو لهذه الفرصة بأن تضيع. ومع ذلك يجب التأكيد على حقيقة أن تطورين عملا على تثبيت الوجود الروسي والتمهيد لقرار البقاء طويل الأمد في الإقليم. تطور منهما يتعلق بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيساً لأميركا. المثير في هذا التطور أنه جاء مصحوباً بحال من الوفاق السرّي بين الرئيسين، رئيس أميركا ورئيس روسيا. الوفاق سرّي بمعنى أن أحداً في أميركا لم يُقدّم حتى الآن تفسيراً للعلاقة الغامضة التي تربط الرئيسين ببعضهما على رغم تدهور العلاقة بين بلديهما على المستويات الأخرى، مستويات الرأي العام والمجالس النيابية وأجهزة الإعلام. إنها بحق حال تستحق أن توصف بالحرب الباردة الثانية بين البلدين. الدولتان مشتبكتان فعلياً في مناوشات وعمليات تخريب تهدد سلامة الأنظمة المصرفية والدفاعية المعتمدة على شبكات التواصل الفضائية. أما الرئيسان فواحد منهما يبدو عازماً على تدمير البنى التحتية للنظام الديموقراطي الغربي، والأميركي خصوصاً، والثاني يبدو من ناحيته عازماً على الاستمرار في عملية تغيير «الوضع القائم» في كل ما هو قائم في أميركا وفي العالم، حتى أنه بات يعرف إعلامياً بلقب «المخرّب الأعظم».
التطور الثاني الذي يعمل على تثبيت أمد الوجود الروسي في الشرق الأوسط وإطالته، ويفتح آفاقاً أرحب للتمدد الروسي في أقاليم أخرى، هو المتعلق بالتقدم الكبير الذي تمكن من تحقيقه الرئيس الروسي في تسوية الصراع على سورية. يتحدثون من الآن عن النموذج السوري في تسوية النزاعات الإقليمية. يقوم النموذج في رأي هؤلاء على أسس أهمها الوجود الروسي الكثيف على أرض النزاع بصحبة دولتين أو ثلاث دول إقليمية. تتعاون الدول الإقليمية مع روسيا مقابل وعد بمكافأة أو جائزة لكل مشارك، هذه الجائزة قد تأخذ شكل نفوذ أوسع أو مصالح مادية مباشرة أو وضع دفاعي أفضل. علماً بأنه في الحالة السورية، وليس من المستبعد أن تتكرر في حالات مماثلة، كانت هناك أيضاً جائزة أكبر يحصل عليها المشاركون جميعاً، بخاصة الروس، وهي خروج الولايات المتحدة من سورية أو الدولة موضوع التسوية وإضعاف النفوذ والمصالح الأميركية في بقية أنحاء الإقليم.
أتصور أن الانسحاب المخطط والمتدرج للقوة الأميركية من الخارج، وكانت له مبرّراته ودوافع، يتعرض الآن لتخبّط شديد. هذا التخبّط مصحوب بكثير من الارتباك وسوء القيادة يمكن أن يدفع الصين إلى تعجيل وتكثيف جهود صعودها إلى مواقع القمة، الأمر الذي لا شك في أنه سوف يضغط على خطط روسيا في مواقع متفرقة، وقد يدفعها إلى ارتكاب أخطاء من نوع الأخطاء التي سبّبت هزيمتها غير العسكرية أمام أميركا في نهاية حربهما الباردة الأولى. يمكن أيضاً أن يؤدي هذا التخبط الأميركي إلى صدع خطير في العلاقات بين العسكريين والنخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة بعواقب وخيمة عليهما وعلى أميركا والعالم أيضاً.