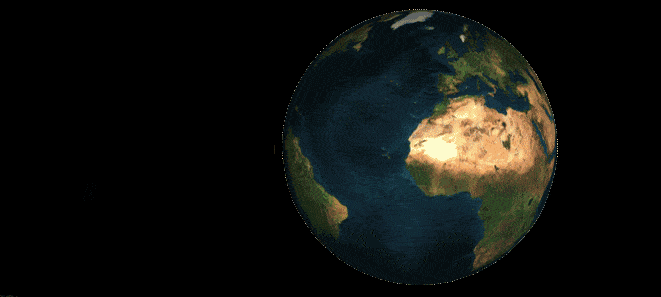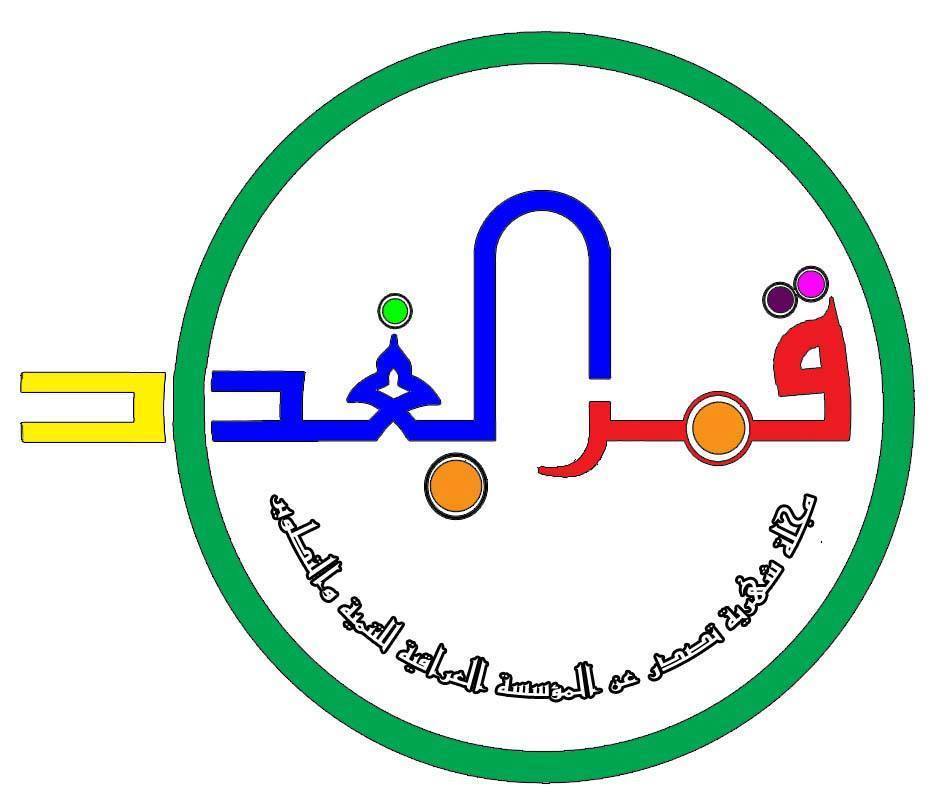أبعاد رمزية تبدو فيها الشخصيات في مأزق وجودي لا فكاك منه


مشهد من مسرحية “الباب” السورية (خدمة الفرقة)
لم تُعر مسرحية “الباب” لمخرجها غسان الدبس الاهتمام للمسرح الأرسطي ووحداته الثلاث، بل ذهبت نحو تقديم أبعاد رمزية تبدو فيها الشخصيات في مأزق وجودي لا فكاك منه. فالزمان والمكان غائمان في حكاية العرض الذي قام الدبس بإعداده عن نص الكاتب السعودي ياسر الحسن، في محاولة لتقديم مقترح لا يعلو فيه صوت المضمون على الشكل الفني، بل يستلهمه لتقديم مستويات متعددة من قراءة واقع جيل الحرب السورية.
مهرج (مجد مغامس) وسكرتيرة (رغد سليم) وموظف حكومي (علي إبراهيم) يحضرون على إثر دعوتهم من صاحب المنزل الذي لا نراه بل نسمع عنه، وهؤلاء ينتظرون أن يؤذن لهم بالدخول إلى البيت، لكنهم يفاجأون بمزاد وهمي لبيع باب البيت المرصع بالأحجار الكريمة، ويديره سمسار (حاتم أتمت) بأنواع شتى من طلاوة اللسان، بين الترغيب والترهيب. يدخل الزبون الأول إلى البيت ولا يعود بعد أن يرسو عليه المزاد، وبعدها يتكرر دخول شخصيات وهمية إلى ما يشبه مثلث برمودا، يبتلع كل من يرسو عليه المزاد. ومع كل زبون جديد تتصاعد صراعات كل من المهرج والسكرتيرة والموظف، ونتعرف أكثر فأكثر إلى ماضي قصة كل منهم.

شخصيات تعيش حال الإنتظار (خدمة الفرقة)
الأصوات الغامضة الآتية من خلف باب المنزل المحاط بالألغاز، يدفع المهرج فهمان العبيط إلى المضي للمشاركة في المزاد الوهمي، فيدخل هو الآخر من باب البيت ولا يعود، على رغم تحذيرات رفيقيه له بعدم المجازفة والدخول إلى البيت. ومع كل حادثة اختفاء يزداد غموض مصير الشخصيات، والخطر المحدق بكل منها، فالسكرتيرة التي استغلها جنسياً ربّ عملها لقاء حصولها على المال لعلاج أمها وإعالة إخوتها الصغار، يأخذها الرقص إلى حتفها المنتظر، فتنهار وتذوي عند رواية قصة ابتزازها، ودخولها في صفقات مشبوهة لمصلحة أوهام باعها إياها مديرها في العمل. والموظف الحكومي يسرد علينا قصة تسلط زوجته عليه. ومع أنه يحمل رسالة لصاحب البيت الذي يقف أمام عتبته، إلا أنه لا يعرف مضمونها، ولا يملك إلا مغامرة الدخول والمقامرة بحياته، لعله يتخلص من واقعه الذي يحاصره ليل نهار كمستخدم لنزوات زوجته وغطرستها.
بقايا شخصيات
أما المهرج الذي غامر ودخل إلى بيت الأشباح هذا فنجده -على رغم التفاؤل الذي يبديه في الجزء الأول من العرض- نسخة من بقايا شخصيات موليير وبهاليل شكسبير ومجانين “العنبر رقم ستة” لتشيخوف. كان فهمان العبيط يحلم أن يصبح ممثلاً مشهوراً، لكنه وجد نفسه على قارعة الطرق يطارد وهماً أوصله إلى التهلكة، وجعله يتورط في لعبة انتحار مقنّع، ظاهرها هو حب الحياة والتمسك بها، لكن باطنها هو تسليم النفس لمصير مجهول يقارب أجيالاً من الشباب والشابات السوريين الذين اختاروا الهجرة عبر قوارب الموت، على البقاء في بلاد تبيعهم الأمل كنوع من المخدرات الشعبية الرخيصة.

المهرج في المسرحية (خدمة الفرقة)
اللافت في هذا كله هو المناخ النفسي المنقبض الذي نجح مخرج العرض في إبرامه كسجن لا مرئي، حول الشخصيات الثلاث العالقة بين داخل البيت وخارجه، كأن يصبح الباب برزخاً بين عالمين، العالم الأول هو عالم الأحلام التي ما هي سوى أوهام جذابة، أما العالم الثاني فهو المجهول الفتاك بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وهذا ما بدا واضحاً في الديكور (إياد ديوب) الذي اكتفى بمجسّم لبابٍ أثري يحجب خلفه كواليس المسرح عبر أشرطة من قماش، تمتد إلى عمق الخشبة كثعابين تخفي خلفها عالماً سرياً محاطاً باستغاثات كتيمة للضحايا الحالمين بغدٍ أفضل.
ومع تتابع مشاهد العرض الذي اعتمد على نقلات الإضاءة (إياد العساودة) لتمرير شحنات انفعالية مركّزة تدعم عمل الممثلين، يتوضح البعد الرمزي للباب، وتنهار الشخصيات واحدةً تلو أُخرى في متتاليات الضوء الذي أسهم في إضفاء غلالات من الشحوب على سحنات الممثلين، عبر توظيف كشّافات جانبية. وكان ملاحظاً أن المخرج لم يكتفِ بذلك، بل عمل على تتابع واضح للضوء وفقاً لحركة الممثل، ولا سيما في مشهد الرقص الجماعي لفرقة ميرال (كريوغراف محمد الطرابلسي)، لكن من دون مراعاة مسألة الجدار الرابع في بعض المشاهد التي غطى فيها الممثلون على أداء الراقصين في خلفية مسرح القباني.
إلى ذلك، كان واضحاً الدور الجوهري للموسيقى (أيمن زرقان) في تعميق الصراع الداخلي للممثلين، ودفعهم للبوح وفقاً لرسم حركي بسيط في تدرجاته الجسدية، إلا أنه كان موظفاً لمصلحة النوع الفني الذي اختاره مخرج العرض وكاتبه، فبدت الشخصيات ضمن هذا الخيار الرمزي ذات ثراء داخلي. وعلى رغم غياب الحدث وتكراره مع كل مرةٍ يفتح ويغلق فيها الباب على مزاد علني جديد، إلا أن هذا بنى علاقة خفية مع المتفرج، وجعل مخيلة الجمهور خصبة لجهة التوقعات التي ينضوي عليها عالم الكواليس كجزء من تفسير العرض وقراءة مدلولاته.

صرخة المرأة (خدمة الفرقة)
بالمقابل، تمكن الفنان غسان الدبس من توظيف هذه العناصر من ضوء وموسيقى وأداء راقص، في سياق المعالجة الفنية التي سمحت بإنجاز فضاء تجريدي، وجعله متاحاً لتمرير اللعبة المسرحية، ومحاولة تصديرها كمعادل فني للواقع السوري اليوم، والذي يعيشه آلاف من الشباب الهائمين على وجوههم، والباحثين عن بارقة أمل وسط لجة دموية أنتجتها سنوات الحرب الطويلة.
اقرأ المزيد
من هنا يمكن الثناء على أداء الممثلين الذين ظلوا في مستوى طبيعي صرف، ولم يلجأوا إلى أنماط أداء ما يسمى بـ”المسرح المسرحي”، إذ كان واضحاً ابتعاد المخرج عن مسرحة الأداء إلا في الحدود الدنيا. وهذا مثل مشهد تقاذف الفتاة كغنيمة حرب بين أرباب المال والنفوذ، أو مشهد الرقص الذي تجاور مع لحظة توتر، لضياع تعيشه الشخصيات في محيط من الأكاذيب والخدع البراقة عبر سماسرة الأمل وتجاره، للخلاص ببطء، إلى قناعة الاعتماد على النفس، وعدم الإصغاء إلى صراخ ما خلف الأبواب المغلقة، التي لا تخفي وراءها إلا صيحات المعذبين والمقهورين. فالأبواب في العرض ما هي سوى شرَك منصوب لفرائس جديدة، والبيوت التي تقعي خلف تلك الأبواب ليس سوى أنفاق جديدة لا ضوء في نهايتها.
تبقى الإشارة إلى المقترح الجديد الذي قدمه نص الكاتب والمخرج السعودي ياسر الحسن، والذي وفّر نماذج أقرب إلى شخصيات مسرح اللامعقول عند صموئيل بيكيت (1906- 1989)، لا سيما شخصيتي فلاديمير وإستراغون في مسرحية “في انتظار غودو” المعروفة. وهذا ما كان متقاطعاً بشكلٍ كبير مع شخصيات مسرحية “الباب”، حيث الانتظار غير المجدي لصاحب المنزل، ومن ثم الإذعان لعبث هذا الانتظار وعدميته. إلا أن العرض السوري (إنتاج مديرية المسارح والموسيقى) لم يلعب على شعرية اللغة في النسخة الجديدة من النص، بل آثر التركيز على مفهوم الانتظار كفخ من الأفخاخ المعاصرة لاصطياد أجيال بأكملها، وتركها رهينة “غودو” السوري، وهو في العرض شخصية صاحب المنزل الذي لا نراه، ولا يبيع إلا وهماً، بابه المرصع بالياقوت والموت.